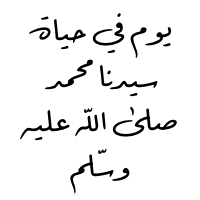نقد دعوى الملاحدة ونقضها
لقد عرفنا في الفقرة الماضية أن دعوى المعارضين للدين قائمة على أساس أن الحقائق العلمية التي توصلوا إليها إنما قامت على التجربة ، أو المشاهدة ، وليس كذلك الحقائق الدينية ، فهي أمور غيبية ، لا يمكن إجراء التجارب عليها ولا مشاهدتها ، وبناء على ذلك فهي ليست حقائق علمية ، ولذلك لا يجوز الإيمان بها .
ونحن سنناقش هذا المعيار العلمي الذي فرضوه ، وهو التجربة أو الحس والمشاهدة ، لنرى من خلاله الحقائق العلمية التي يؤمن بها العقل الحديث ويعتبرها من المسلمات ، ليست خاضعة بأسرها لهذا المعيار العلمي الذي افترضه ، وأن كثيرا منها إن لم يكن أكثرها ، قائم على أساس الاستنباط والاستنتاج والاستقراء الذي رفضوا به الدين .
إن هذا المعيار العلمي الذي فرضوه ، وهو القائم على التجربة أو المشاهدة ، أولا وقبل كل شيء ، ليس على درجة واحدة في كل المشاهدات ، بل هو على درجات متباينة من الناحية العملية . فالدرجة الأولى لهذا المعيار هو أن يكون الأمر الذي نريد مشاهدته أو تجربته في متناول يدنا مباشرة يمكننا أن نراه ونجربه من جميع وجوهه على السواء ،وذلك كمن يقول : إن الماء يحتوي على كائنات حية ، فإذا ما طلبناه بالبرهان على قوله ، أمكنه أن يأتي بقطرة من الماء ويضعها تحت المجهر ، ليؤكد لنا بالمشاهدة المباشرة وجود عدد كبير من هذه الكائنات في هذه القطرة من الماء .
وفي هذه الحالة نتمكن من رؤية الأمر الذي نريد إثباته ، نتمكن من رؤيته مباشرة ومن جميع الجهات ، وفي جميع الظروف والأحوال .
وأما الدرجة الثانية لهذا المعيار هي أن لا تكون الدعوى المراد إثباتها، أن لا تكون قابلة للمشاهدة كليا ، من جميع الوجوه ، بل يمكن مشاهدة بعض أجزائها ووجوهها .
وذلك كدعوى كروية الأرض ، فان الإنسان لا يمكنه أن يرى صورة الأرض كاملة ، إلا أنه يستطيع أن يشاهد أجزاء مختلفة تؤكد بمجموعها كروية الأرض ، وذلك بأن يلتقط صورة الأرض من مركبة الفضاء مثلا ، فان هذه الصورة ستظهر الأرض كروية كما يظهر القمر تماما ، والحقيقة أن هذه الصورة ليست إلا جزءا من كرويتها ، وليست هي الصورة الكاملة لها .
ولا أظن أن أحدا في الدنيا يزعم أن قانون التجربة أو المشاهدة في هاتين الدرجتين على حد سواء وإن كان الإنسان يحصل على العلم الكامل في كلا الدرجتين ، الآن العلوم تتفاوت ولكن ، هل كل الحقائق العلمية التي نعرفها اليوم من هاتين الدرجتين…..؟ الحقيقة أن معارفنا وحقائقنا العلمية التي وقفنا عليها من خلال هاتين الدرجتين بسيطة جدا ، إذا ما قيست بمجموع علومنا ، بل إننا لم نحصل على حقيقة ذات أهمية . عن طريق هذا النوع من المشاهدات ، بالرغم من أن دراستنا للكون تؤكد وجود ما لا يحصى من الحقائق ذات الأهمية في هذا الكون ، كما يقول الأستاذ وحيد الدين خان في كتابه (( الدين في مواجهة العلم ))(1).
ولذلك كان لابد للعقل أن يضيف معيارا جديدا للاستدلال يتلخص في أن لاستدلال يعتبر مقياسا علميا سليما إذا شوهدت فيه تجربة ، تؤكد هذه التجربة وجود حقيقة ما، وذلك بالرغم من عجزنا عن مشاهدة تلك الحقيقة من جميع جوانبها في تلك التجربة التي أجريناها ، وذلك كالإلكترون الذي لا يمكن مشاهدته لتناهي صغره ، بحيث يعجز الإنسان عن مشاهدته مهما أوتي من العلم والطاقة ، كما أنه لا يمكن لميزان وزنه ، ولكنه بالرغم من ذلك يعتقد العلماء بأن الإلكترون حقيقة علمية
كيف أثبت العلماء هذه الحقيقة وهم لم يروها ولم يجربوها ؟ والجواب على هذا السؤال هو أن الإليكترون مع أنه لا يمكن رؤيته إلا أنه له آثار نشاهدها في صورة تجارب قابلة للتكرار والإعادة ، ولا يمكن تفسير تلك التجارب إلا بأن نسلم بأن هناك نظاما اليكترونيا ، فالإليكترون في ذاته فرض ، إلا أنه يستند إلى تجربة غير مباشرة ، ولذلك يسلم العلم بوجوده .
وهذه الإضافة الثالثة في مقاييس الاستدلال هي التي مكنتنا من الوصول إلى حقائق ذات أهمية عميقة نسميها اليوم علم الطبيعة الجديدة ، أو علم الفضاء وبهذا نعلم أن التجربة والمشاهدة ليستا وسيلتي العلم القطعيتين ، وأن العلم لا ينحصر في الأمور التي شوهدت بالتجربة المباشرة .
كما أن هذا المقياس الثالث الذي ذكرناه ليس هو الأخير في معيار الاستدلال ، لأن الحقائق التي نتوصل إليها بواسطته ليست إلا حقائق فنية والواقع أن الحقائق التي لها أهمية تبدأ حيث تنتهي الحقائق الفنية ، ومثال ذلك دراستنا لحياة الإنسان وأعضائه ، فإنها كشفت لنا كثيرا من الحقائق ، ولكن الحقيقة ذات المغزى الأهم وهي المتعلقة ببداية الإنسان ونهايته لم نتعرف عليها من خلال علم الحياة والأعضاء (2).
ولذلك كان لابد لنا من مقياس استدلالي جديد نرجع إليه ، ونعول عليه ، يكشف لنا عن هذه الأمور ذات الأهمية ، التي لم نتمكن من الحصول عليها من خلال المعايير الاستدلالية الثلاثة السابقة .
قبول مبدأ الاستنتاج :
من أجل هذا أضاف العقل الحديث مقياسا استدلاليا رابعا بني عليه كثيرا من النظريات العلمية التي آمن بها وتبناها .
وخلاصة هذا المقياس هو الاستنتاج والاستنباط من خلال المشاهدات والملاحظات ، وإن لم تكن مرتبطة بالقضية المطروحة ، إلا أنه إذا كانت هناك قرينة جائزة لتأييد تلك القضية ، فان الاستدلال بهذه القرينة على القضية المطروحة سيكون مقبولا ومسلما .
وهذا إذا لم تكن هناك نظرية أقوى من هذه التي توصلنا إليها تفسر تلك المشاهدات والملاحظات .
وهذا المقياس الرابع مقبول عند العقل الحديث ، وأي ادعاء تتوفر فيه شروط هذا المقياس يصبح نظرية علمية مقبولة .
ولذلك يقول البروفيسور ا . ي . ماندير :
(( إن الحقائق التي تعرفها مباشرة تسمى (( الحقائق المحسوسة )) ، بيد أن الحقائق التي توصلنا إلى معرفتها ، لا تنحصر في الحقائق المحسوسة ، فهناك حقائق أخرى كثيرة لم نتعرف عليها مباشرة ، ولكننا عثرنا عليها على كل حال ، ووسيلتنا في هذا السبيل هي الاستنباط ، فهذا النوع من الحقائق هو ما نسميه (( بالحقائق المستنبطة )) والأهم هنا أن نفهم أنه لا فرق بين الحقيقتين وإنما الفرق هو في التسمية ، من حيث تعرفنا على الأولى مباشرة ، وعلى الثانية بالوساطة ، والحقيقة دائما هي الحقيقة ، سواء عرفناها بالملاحظة أو بالاستنباط .
ويقول : (( إن حقائق الكون لا تدرك الحواس منها غير القليل ، فكيف يمكن أن نعرف شيئا عن الكثير الآخر ، هناك وسيلة هي الاستنباط أو التعليل وكلاهما طريق فكري ،نبتدئ به بوساطة حقائق معلومة حتى ننتهي بنظرية نقول : إن الشيء الفلاني يوجد هنا ولم نشاهده مطلقا(3).
ويقول : (( إن الوقائع المحسوسة هي أجزاء من حقائق الكون ، غير أن هذه الحقائق ندركها بالحواس قد تكون جزئية وغير مرتبطة بالأخرى ، فلو طالعناها فترة مجردة عن أخواتها فقدت معناها مطلقا ، فإذا ما درسناها في ضوء الحقائق الكثيرة مما علمناه مباشرة أو بلا مباشرة فإننا سندرك حقيقتها(4).
وقد ضرب ما ندير لذلك مثالا قال فيه :
(( إننا نرى أن الطير عندما يموت يقع على الأرض ، ونعرف أن رفع الحجر على الظهر أصعب ، ويطلب جهدا ، ونلاحظ أن القمر يدور في الفلك ، ونعلم أن الصعود في الجبل أشق من النزول منه ، ونلاحظ حقائق كثيرة كل يوم لا علاقة لإحداها بالأخرى ظاهرا ،ثم نتعرف على حقيقة استنباطية هي((قانون الجاذبية )) وهنا ترتبط جميع هذه الحقائق ، فنعرف للمرة الأولى أنها كلها مرتبطة إحداها بالأخرى ارتباط كاملا داخل النظام .
وكذلك الحال لو طالعنا الوقائع المحسوسة مجردة فلن نجد بينها أي ترتيب ، فهي متفرقة ، وغير مترابطة ولكن حين نربط الوقائع المحسوسة بالحقائق المستنبطة فستخرج صورة منظمة للحقائق . فقانون الجاذبية الذي أشار إليه ماندير ، والذي أستنبط من مجموعة مشاهدات ، هذا القانون لا تمكن ملاحظته ، وكل ما شاهده العلماء لا يمثل في ذاته قانون الجاذبية ، وإنما هي أشياء أخرى اضطر العلماء معها للإيمان بهذا القانون الذي اكتشفه نيوتن ، وصار حقيقة علمية ولكن ، ما حقيقة هذا القانون من الناحية التجريبية ؟ أنه أمر غير مفهوم ، كما قال نيوتن نفسه في خطاب أرسله إلى بنتلي ، قال فيه : (( أنه لأمر غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فيها ولا إحساس وهي تؤثر على مادة أخرى ، مع أنه لا توجد أية علاقة بينهما )) .
فنظرية معقدة غير مفهومة ولا طريق إلى مشاهدتها تعتبر اليوم بلا جدال حقيقة علمية ، لماذا ؟ لأنها تفسر بعض ملاحظاتنا .
فليس بلازم إذن أن تكون الحقيقة هي ما علمناه مباشرة بالتجربة ، فالعقيدة التي تربط بعض ما نلاحظه ، وتفسر لنا مضمونه العام – تعتبر حقيقة علمية من نفس الدرجة (5).
ولذلك يقول الفيلسوف الانجليزي براتراند رسل، وهو من أكبر الفلاسفة الملحدين في هذا العصر
(( إنني أومن بالمبدأ القائل بأن هناك طرقا معقولة لاستنباط وقائع من وقائع أخرى ، وبالتحديد الاستنباط من وقائع أعرفها بدون استنباط لوقائع لم تتأت لي معرفتها بتلك الطريقة .))
ويقول : (( إنني أجزم بأن هناك طرقا للاستنباط أقرب إلى الحق ، ويجب قبولها ، رغم أنه لا يمكن إثباتها بالتجربة (6) )) .
ونحن إنما نسوق هذه الأقوال لنبين من خلالها أن العقل الحديث لا يحصر مبدأ معرفته ومعلوماته بما يحرك أو يشاهد فقط ، بل اتخذ وسائل أخرى وهي وسائل الاستنباط والاستنتاج من خلال المشاهدة والملاحظة ، وأن الحقيقة العلمية التي يتوصل إليها عن طريق هذا المعيار في قوة جميع الحقائق العلمية الأخرى التي حصل عليها بالتجربة والمشاهدة ، كما سمعنا هذا من كبار الفلاسفة المعاصرين المعادين للدين والمؤيدين له على السواء .
توضيح المعيار الرابع :
ولتوضيح هذا المعيار الذي أمن به العقل الحديث وجعله وسيلة لقوانينه ومعارفه سنضرب – عددا من الأمثلة نبين من خلالها كيف اعتمد العقل الحديث على هذا المعيار ، لنخلص من خلالها إلى أن الفكر الديني ، وعقيدة الإلوهية والوحدانية لم تخرج عن نطاق المعايير العلمية التي فرضها العقل الحديث للوصول إلى الحقائق ، وأن الفكر الإلحادي لم يعاد الدين لأنه لا يستند إلى قواعد علمية حقيقية ، بل عاداه عنادا وجحودا وعصبية ، كما سنرى ذلك من خلال الأمثلة التي سنسوقها ، ومن خلال أقواله واعترافاته .
لقد ادعى المعارضون للدين أن الدين باطل ، (( وأنه لا يستند إلى أساس ، وصارت هذه الدعوى عقيدة يحملها الماديون أصحاب الفكر الإلحادي )) .
ولكن إذا سألنا أصحاب هذه الدعوى ، إلى أي معيار استدلالي استندتم في حكمكم هذا ؟ فإننا سنجد الجواب أنهم استندوا إلى المعيار الاستدلالي الرابع ، القائم على الاستنباط والاستنتاج .
وذلك لأن العقل الحديث يرى أن الدين مجموعة من العقائد الذاتية الخاصة بأصحابها ، وأنها لا يمكن إخضاعها للتجربة العلمية ، وبناء على ذلك حكموا ببطلانها . .
ولكن حكمهم هذا الذي أصدروه ببطلان الدين فيه تناقض ، وذلك لأنهم إنما رفضوا الدين لأنه عقائد لا يمكن أن تخضع للتجربة ، وما كان كذلك فهو باطل ، إلا أنه يجب أن يكون حكمهم باطلا أيضا ، للسبب نفسه ، وذلك لأنه لا يجوز لهم أن يحكموا ببطلان الدين إلا إذا تمكنوا بواسطة المشاهدة والتجربة أن يثبتوا أن حقائق الدين وقواعده باطلة ، وذلك شيء لا سبيل إليه بناء على ما افترضوه من أن حقائق الدين وقواعده باطلة ، وذلك شيء لا سبيل إليه بناء على ما فترضوه من أن حقائقه غير قابلة للتجربة ، وبناء على ذلك فحكمهم الذي أصدروه ضد الدين باطل قطعا ، إننا سنستعمل نفس أسلوبهم في الاستدلال ، والنقاش والجدل ، فكما أنهم لا يؤمنون إلا بما يشاهد ويجرب – فإننا من حقنا أن لا نؤمن إلا بما يشاهد ويجرب ، وهم لم يستطيعوا أن يثبتوا لنا أن حقائق الدين باطلة بواسطة التجربة ، وعليه فحكمهم الذي أصدروه ضد الدين باطل قطعا .
فما هو مقياسهم الاستدلالي الذي أوصلهم إلى هذه النتيجة التي أصدروها ضد الدين ؟ وما داموا لم يشاهدوا ولم يجربوا . . ؟
إن المعيار الاستدلالي الذي سلكوه هو المعيار الرابع الذي ذكرناه والذي يعتمد على الاستنباط والاستنتاج من المشاهدات والملاحظات ، وان لم تكن مرتبطة بالقضية المطروحة مباشرة ، مادامت هناك قرينة تؤيد هذا الاستنتاج .
لقد اكتشفوا قانون الجاذبية ، وعرفوا أنه هو الذي يمسك الكون وينظمه ، كما اكتشفوا قانون هطول الأمطار، وهبوب الرياح ، وقوانين القوة والحركة ، ورأوا أنه بناء على هذه القوانين وغيرها ،رأوا أن الكون خاضع في حركته لنظامها ، وأنه لا تخرج ذرة واحدة فيه عن هذا النظام ، وبناء على ذلك استنبطوا أنه لا إله يحكم النجوم ،وقالوا ما دامت الأمور مرتبطة بقوانين طبيعية ، فلا يجوز لنا أن ننسبها لأمور وراء الطبيعة ، فسبيلهم إذن هو الاعتماد على القانون الرابع وإلا فإنهم لم يتمكنوا بواسطة التجربة أن يثبتوا لنا أنه لا إله في هذا الكون يحكمه ويصرفه .
استعمال المؤمنين للقانون الرابع
إلا أن هذا المقياس الرابع الذي اعتمدوا عليه في إبطال الدين هو بذاته من أكبر الأدلة على صحة الدين وحقيقته ، لأننا سنقول كما أنكم أجزتم لأنفسكم أن تستنبطوا من خلال هذه المشاهدات هذا الحكم ، وهو بطلان الدين ، يجوز لنا أيضا أن نستنبط من خلال هذه المشاهدات صحته ، واستنباطنا أقرب من استنباطكم وأصح .
وذلك لأن هذه المشاهدات لم تفسر لنا إلا بعض الظواهر ، ولم تخبرنا عن الحقائق الكامنة وراءها ، وإلا فمن أين أتت هذه القوانين التي يسير عليها الكون ، وبهذه الدقة وبهذا الأحكام ، أن مشاهداتنا هذه لم ولن تدلنا على عدم وجود الله ، وإنما نستنتج من دقتها وإحكامها أنه لا بد أن يكون لهذا الكون صانع عظيم وحكيم ، هو الذي أوجده على هذا المستوى من الدقة والإحكام والانتظام .
وكلامنا هذا ليس من قبيل العقائد التي لا تستند إلى دليل ، وإنما هو كلام استند إلى نفس الدليل الذي أصدرتم به حكمكم ببطلان الدين ، وهو المقياس الرابع ، فكما جوزتم لأنفسكم استخدامه ، يجوز لنا أن نستخدمه ، وإلا فمنعنا من استخدامه تعنت وعناد ، على أن استخدامنا له أوضح وأتم من استخدامكم ونتائجنا أظهر وأوضح من نتائجكم ، إننا كما أمنتم بهذا المعيار آمنا به ، وكما بنيتم عليه بنينا .
مثال آخر لتوضيح القانون الرابع :
وما ذكرناه من المثال السابق في بطلان الدين – على زعمهم – كان مثالا سلبيا للقانون الاستدلالي الرابع .
وأما المثال الايجابي فيمكن أن نلخصه في البحث عن أصل الأنواع الأرضية ، إذ طال بحث الإنسان – الذي لم يؤمن بالدين – طال بحثه عن أصل وجوده ، ووجود الأنواع الأرضية ، والحياة وتضاربت نظرياته في هذا الميدان ، وسوف اقتصر في هذا المجال على نظريتين من هذه النظريات وهما نظريتا ماييه ودارون . على أن إحداهما وهي نظرية ماييه قد اندرست رغم ما كونته من الأنصار لها ، وأما الثانية فلا زالت رغم بطلانها علميا – كما سنبين ذلك – لا زالت تجلس في مكان الله في تخيلات الماديين والملحدين . .
وإنما نسوق هاتين النظريتين لأنهما لم تبنيا على القوانين الاستدلالية الثلاثة الأولى والتي تعتمد المشاهدة المباشرة والتجربة ، وإنما بنيتا على الاستنتاج والاستنباط ، ومع ذلك فقد حظيت نظرية دارون برضا معظم الباحثين عن أصل الحياة .
نظرية ماييه :
أما ماييه فهو من كبار علماء القرن التاسع عشر ، ومقتضى نظريته أن البحر أصل الكائنات الأرضية على اختلاف أنواعها وأجناسها ، وذلك بناء على أن البحر قد عم سطح الأرض في عصر من العصور ، وبهذه الواسطة انتقلت المخلوقات إلى الأرض وعاشت فيها ، وعلى هذا فكل ما يشاهد على الأرض من أحقر خلية نباتية إلى أرقى حيوان – وهو الإنسان أصله البحر .
قال ماييه :
لا يوجد حيوان في الأرض ، سواء كان ماشيا على قدميه أو طائرا بجناحيه أو منسحبا على بطنه إلا وفي البحر أنواع مشابهة له أو قريبة منه ، وان انتقال هذه المخلوقات من الماء إلى الهواء ليس بممكن فقط ، بل هو أمر ثابت بجملة أدلة ، ونحن هنا لا نريد أن نتكلم فقط على الحيوانات البرية ، أو البحرية ، أو الثعابين والسلاحف ، وكلاب الماء ، ولا على الحيوانات العديدة التي تعيش في الماء والهواء على حد سواء ، ولكننا سنتكلم على الحيوانات التي لا تستطيع أن تعيش إلا في الهواء .
ثم قال مستدلا على نظريته : (( يكفيك أن تختبر أشكال الحيوانات واستعداداتها وميولها ، سواء كانت برية أو بحرية ، ثم تقارنها ببعضها فابدأ بالطيور مثلا ، ودقق النظر في جميع أنواعها ، وفي اختلاف ريشها ورقتها ، تجد أنك لا تصادف نوعا منها إلا وفي البحر نظيره )) ، ثم علل الانتقال من الماء إلى الهواء مع أنه غير ممكن بالنسبة للحيوان المائي علل ذلك بأن هذا الانتقال لا يتنافى مع العلوم الطبيعية ، فان الهواء الذي يحيط بالكرة الأرضية يحتوي على كثير من الجزئيات المائية ، وليس الماء إلا هواء فيه جزيئات مائية أكبر حجما وأكثر رطوبة ، فهو إذن أثقل من هذا السيال العلوي الذي ألصقنا به اسم الهواء .
ثم علل كيفية الانتقال بأنه يحتمل أن طائفة من هذه الحيوانات كانت في قاع بحيرة من البحيرات ، فأخذ ماء هذه البحيرة يجف شيئا فشيئا ، فوجدت هذه الكائنات نفسها مجبرة على المعيشة في الجو الهوائي ، أو يحتمل أن تكون قد حاولت القفز من تلك البحيرة إلى البحر المجاور لها ، هربا من حيوان مفترس ، فسقطت في غابة ، فهمت بالرجوع إلى مستقرها الأول فأجهدت نفسها من القفز ، فلم تستطع أن تدركه ، ولكنها تحصلت بهذه المحاولة على خاصية الطيران ، وفي هذه الحالة تشققت عواماتها من الجفاف الذي أحدق بها لفقد الماء ، ثم إنها تكون قد وجدت في تلك الغابة ما يغذيها من المواد فلم تمت ، بل بقيت حية ، ولكن الأنابيب المحركة لعواماتها انفصلت ، واكتسبت ريشها فكبر هذا الريش حتى استحال إلى أجنحة ؟ وأما الأجنحة الصغيرة التي كانت تحت بطونها ، والتي كانت تساعدها على السباحة في البحر ، فقد استحالت إلى أقدام سمحت لها بالمشي على الأرض ، وحصل أيضا تغيير سوى ما سبق في سائر أجزاء أجسامها وذلك ظهرت بهذا المظهر الذي عليه الطيور كلها الآن ؟؟
أما من جهة الحيوانات المنسحبة على بطنها والماشية على الأرض ن فانَّ تصوّر وفهم الكيفية التي انتقلت بها من البحر إلى البر فسهل جدا .
أنك ترى بعينك أن الثعابين والسلاحف تستطيع المعيشة في الماء والهواء على السواء .
أما ذوات الأربع فإننا لا نقول فقط بأن في البحر ما يشبه سائر أنواعها جسما وتركيبا، بل نقول : أن منها ما يستطيع المعيشة في كل العنصرين بغاية السهولة ، هذه هي النظرية العجيبة التي أتى بها ماييه في القرن التاسع عشر، رغم ما بها من الضعف الذي كاد يوصل صاحبها لدرجة الهذيان أو السفسطة ورغم الانتقادات التي وجهت لها من كبار العلماء المعاصرين لماييه ، لم نجد أن واحد من العلماء ، أنكر على ماييه نظريته ،رغم أنها لم تشاهد ،ولم تجرب و إنما بناها على المقياس الرابع السابق الذكر بل وجدنا العلماء يقرونه على طريقته التي استنتج بها هذه النظرية من خلال ملاحظاته ومشاهداته ، لأنهم يقرون هذا المقياس الاستدلالي ، وإنما خالفوه في مدى صحتها وثبوتها لعدم وجود القرينة المؤيدة التي ترجح تفسيره لبعض الظواهر على تفسير غيره لهذه الظواهر .
ولإقرار العلماء لمبدأ الاستنباط والاستنتاج الذي ذكرناه أقر العلماء نظرية دارون في الأنواع الأرضية ، وهي نظرية التطور العضوي ، أو النشوء والارتقاء ، وخلاصة هذه النظرية .
نظرية دارون :
أولا :
أن دراسة جميع الحيوانات تؤكد أنها تضم أنواعا أعلى وأخرى أدنى ، ابتداء من حيوانات تتألف من خلية واحدة إلى حيوانات تتألف من ملايين الخلايا ، كما أن هناك اختلافا كبيرا بين هذه الحيوانات من حيث صلاحيتها وكفاءاتها ورقيها .
ثانيا :
لو قارنت معلومات هذه المشاهدة الابتدائية مع الحقائق التي خرجت من جوف الأرض ، فسترى أن هناك ترتيبا ارتقائيا بحسب الزمن ، فالحيوانات التي وجدت على ظهر الأرض قبل ملايين السنين ، والتي احتفظ بطن الأرض بعظامها المتحجرة – تدلنا على أن حيوانات العصر القديم ، كانت بسيطة التركيب ، ثم ظهرت أنواع أرقى وأكثر تعقيدا على مر الزمن ، ومعنى هذا أن الأنواع كلها لم تظهر للوجود في وقت واحد ،وإنما ظهرت الأنواع البسيطة أولا ، ثم ظهرت بعد ذلك الأنواع الأكثر رقيا وتعقيدا .
ثالثا :
هناك تشابه كبير في النظام الجسماني لكل الحيوانات ، بالرغم من كل الاختلافات النوعية ، فالطير يشبه السمك ، وهيكل الحصان يشبه جسم الإنسان ، وبناء على هذا يحتمل أن تكون كل الأجسام الحية منتهية إلى أسرة واحدة ، وأن الجد الأعلى لكل الكائنات الحية جد واحد .
وأما كيفية خروج نوع من نوع آخر ، فيجيب عليه الدارونيون بأنه خاضع لقانون الوراثة وذلك أن الصفات العرضية التي تحدث في الآباء بواسطة اختلاف الأحوال المعيشية ، تنتقل إلى الأبناء ، فينشأ الأبناء مختلفين فيما بينهم ، كما نشاهد ذلك في أبناء الأم الواحدة في أي حيوان من الحيوانات ، فإنهم ليسوا متشابهين ، بل ربما كانت بينهم فروق كبيرة ، ولا تزال هذه الاختلافات العرضية إلى اختلافات تقوى على مر الأجيال والقرون حتى تستحيل هذه الاختلافات العرضية إلى اختلافات جوهرية توهم الناظر لها أنها اختلافات نوعية في أصل الخلقة ، وهي في الحقيقة اختلافات بسيطة في مبدئها توالت عليها الحقب حتى ازدادت تأصلا في الكائن الحي ، ونمت فيه فأدته إلى مباينة الأصل الذي نشأ منه تمام المباينة ، حتى أن الناظر لهما يظنهما من نوعين مختلفين ، وهما من نوع واحد ، كما نرى ذلك بين الحصان والحمار ، فإنهما بناء على هذا من نوع واحد ، وإنما اختلف الحمار عن الحصان هذا الاختلاف تبعا لمقتضيات الوسط الذي عاش فيه الحمار والحصان (7) ، وقد تكبر هذه الفروق خلال ملايين السنين حتى أن الشياه ذات الأعناق القصيرة تتحول إلى الزراف ذات الأعناق الطويلة (8) ، وإنما يتم ذلك وفقا لقانون الانتخاب الطبيعي – الذي يعتبر من أركان نظرية دارون .
ولكن (( ما هو المقياس الذي استند إليه دارون في إثبات نظريته التي شرح بها أصل الأنواع الأرضية وبين فيها أن القرد هو الجد الأعلى للإنسان ، وأن الكلب هو الجد الأعلى للحصان ؟ وان الحياة نشأة من مادة لا حياة فيها .
هل شاهد دارون والدارونيون تجربة في معمل من المعامل تثبت لهم أن القرد هو الجد الأعلى للإنسان ، وتريهم كيف خرج الإنسان من القرد ؟ الجواب لا ، إذن فهل رأى دارون أو الدارونيون جزءا من هذه الحقيقة في تجربة من التجارب إن لم ير الحقيقة كاملة ؟ الجواب أيضا ، لا ، هل يستطيعون أن يثبتوا حقيقة التطور والارتقاء كما يثبتون حقيقة الإليكترون بالضغط على الزر وإضاءة المصباح الكهربائي أو تحرك المعمل ؟ الجواب أيضا لا . .
إذن فهم قد استندوا إلى قانون الاستنباط والاستنتاج من خلال بعض المشاهدات مع وجود بعض القرائن ، وأثبتوا من خلال هذا نظريتهم لأنه من المستحيل أن يثبت دارون أو أتباعه كيف توجد الحياة من مادة لا حياة فيها ، أو كيف يخرج الإنسان من القرد .
فهو بني نظريته على أساس التشابه الموجود في مختلف الأنواع ، وحدوث الفوارق في أبناء الأم الواحدة ، وبناء على ذلك فقد حكم بأن هذه الأنواع المختلفة التي لم توجد دفعة واحدة ، والتي تباينت ببساطتها وتعقيدها ، حكم بأنها قد خرج بعضها من البعض ، ومازالت تترقى إلى أن وجد أرفع نوع منها وهو الإنسان .
فهو إذن لم ير كيف خرج الإنسان ، ولم يجربه ، وإنما هو افتراض محض وتخمين وليس هناك أي دليل صحيح على أن هذه الحيوانات لها صلة بالتي كانت قبلها وكان أبسط منها ، وأنها إنما تطورت مع الزمن إلى أن صارت على صورتها الحالية .
رواج نظرية دارون :
من أجل هذا أصبحت هذه النظرية القائمة على الافتراض المحض أصبحت هدفا للطعن والانتقاد . وها هو سير آرثر كيث ، وهو من أكبر المدافعين عن هذه النظرية يقول : (( إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علميا ، ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان (9) )) كما عرفتها إحدى الموسوعات العلمية (( بأنها نظرية قائمة على تفسير بدون براهين ))(10).
إلا أنه على الرغم من هذا النقد القاسي الذي وجه إلى الدارونية من قبل كثير من العلماء حتى أصبحت نظرية لا قيمة لها في ميدان العلوم – على الرغم من هذا نجد العلماء المعاصرين يقبلونها ، ويرضون بها ، على أنها هي التي تفسر لهم أصل الحياة ونشأتها .
فها هو لل يقول :(( ظلت نظرية الارتقاء تحصل على تأييد متزايد ، يوما بعد يوم ، بعد دارون ، حتى أنه لم يبق لدى المفكرين والعلماء شك في أن هذه هي الوسيلة المنطقية الوحيدة التي تستطيع أن تفسر عملية الخلق وتشرحها)) .
ويقول سمبسن : (( إن نظرية الارتقاء حقيقة ثابتة أخيرا وكليا ، وليست بقياس ، أو فرش بديل صيغ للبحث العلمي )) .
ويقول ماندير : (( لقد ثبت صدق هذه النظرية ،حتى أننا نستطيع أن نعتبرها أقرب شيء إلى الحقيقة )) .
فنحن نرى أن هؤلاء العلماء يقبلون النظرية ،ويقحمونها في شتى مجالات العلم ، ويبنون عليها كثيرا من بحوثهم العلمية ،مع أنها نظرية قائمة على الفرض والتخمين والاستنباط .
وبناء على هذا نستطيع أن نقول : إن العقل الحديث لا يحصر دائرة العلم في تلك الوقائع التي يمكننا تجربتها مباشرة ، وإنما يعتبر أن أية قرينة منطقية تستند إلى تجارب ومشاهدات غير مباشرة يمكنها أيضا أن تصبح حقيقة علمية بنفس درجة الحقائق العلمية التي يتمكن من مشاهدتها مباشرة .
ونحن هنا لا نريد أن نبحث عن صحة أو خطأ نظرية النشوء والارتقاء ، فلسنا بهذا الصدد الآن ، وإنما نريد أن نثبت بالبرهان القاطع ما هدفنا إليه من أن العقل الحديث يقبل هذا المعيار الاستدلالي القائم على الاستنباط ، وبناء على ذلك – فما الذي جعل نظرية دارون في أصل الأنواع مقبولة ، وتفسير الدين لأصل الحياة باطلا ، مع أن تفسير الدين أوضح وأتم .
ما جاز لدارون يجوز للمؤمن
فإذا جاز لدارون أن يقول : إن التشابه بين أجسام الحيوانات الراقية والبسيطة يدفعه للإيمان بأن جدها الأعلى واحد ، إلا يجوز لعالم الدين أن يقول : أن التشابه الذي رأيناه بين أجسام جميع الحيوانات البسيطة والمعقدة على تتابع الأيام والأجيال والأحقاب يدفعني للإيمان بأن خالق هذه الكائنات الحية واحد ، بدلا من أن يقول : إن جدها إلا على واحد . . ؟
إن كلا الرجلين استند إلى المشاهدة والاستنباط ، إلا أن استنباط دارون بعيد كل البعد عن العقل ، والقوانين العلمية ، لما هو معروف في نظرية من الثغرات التي لم ولم ولن تسد ، بينما نجد استنباط عالم الدين قائما على قانون العقل ، إلا وهو أن التشابه الكبير القائم بين هذه المخلوقات يدل على أن صانعها واحد . .
ونحن الآن في جدال موضوعي ، ولا نريد أن نتحكم ، فكل منا يرى من خلال وجهة نظره ،
ولكن الذي نريده ونصر عليه أن لا يتعنت فلاسفة الإلحاد ، فيمنعونا مما أباحوه لأنفسهم .
فكما أنهم رضوا بمبدأ الاستنباط يجب عليهم أن يسمحوا لنا باستعمال نفس المبدأ ، وعند ذلك نستطيع أن نقول : أن قواعد الدين حقائق علمية بمعيار العقل الحديث . كما أنها كانت كذلك بمعيار العقل القديم . .
تعصب الفكر الإلحادي :
إلا إننا مع هذا نجد فلاسفة الإلحاد يصرون على رفض الدين مع قبولهم لمعاييره الاستدلالية ، وأما لماذا يرفضون الدين على أن تفسيره لأصل الحياة أوضح من تفسير دارون . فذلك شيء نترك الكلام عنه للسير آرثر كيث إذ يقول (( إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علميا ، ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان ، ونحن لا نؤمن بها إلا لان الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق المباشر ، وهذا ما لا يمكن حتى التفكير فيه ))(11).
ويوضح السير جمس جينز في كتابه عالم الأسرار هذه الحقيقة فيقول : (( إن في عقولنا تعصبا يرجح التفسير المادي للحقائق ))(12).
كما يؤكد الدكتور هيلز هذه المعاني فيقول (( إنني سأكون آخر من يدعي أننا نحن العلماء أقل الناس عرضه للتعصب بالنسبة للمثقفين الآخرين ))(13).
إذن فالأمر ليس أمر صحة المبدأ أو عدمه ، وإنما هو أمر تعصب أعمى يدفع فلاسفة الإلحاد في العصر الحاضر لترجيح أمر على أمر آخر ، كما رجحوا تفسير دارون ، لأصل الأنواع بالنشوء والارتقاء على تفسير الدين لها بالخلق المباشر ، مع أن طريقة الاستدلال واحدة ، بل هي في جانب الدين أرجح ، وإذا أردنا أن نعرف المزيد عن هذا التعنت الذي أصيب به العقل الحديث فلنستمع إلى ويتكر شامبرز في كتابه (( الشهادة )) وهو يذكر حادثا كان من الممكن إن يصبح نقطة تحول في حياته فيقول : أنه بينما كان ينظر إلى ابنته الصغيرة استلفتت أذناها نظره ، فأخذ يفكر في انه من المستحيل أن يوجد شيء معقد ودقيق كهذه الإذن بمحض اتفاق وصدفه ، بل لابد أنه وجد نتيجة إرادة مدبرة ، ولكنه طرد هذه الوسوسة عن قلبه حتى لا يضطر للإيمان بالله منطقيا ، لأن فكره لم يكن على استعداد لتقبل هذه الفكرة )) .
ويقول الدكتور تامس ديود باركس بعد ذكر هذا الحادث : (( إنني اعرف عددا كبيرا من أساتذتي في الجامعة ، ومن رفقائي العلماء الذين تعرضوا مرارا لمثل هذه المشاعر وهو يقومون بعلميات كيمياوية وطبيعية في المعمل (14).
كما يقول أحد العلماء الآخرين : (( إن كون العقيدة الإلهية معقولة وكون إنكار الإله سفسط ، لا يكفي ليختار الإنسان جانب العقيدة الإلهية فالناس يظنون أن الإيمان بالله سوف يقضي على حريتهم ، تلك الحرية العقلية التي استعبدت عقول العلماء واستهون قلوبهم ، فأية فكرة عن تحديد هذه الحرية مثيرة للوحشة عندهم (15).
وليس هذا فقط ، بل هناك أسباب أخرى سوى العصبية والتعنت والجري وراء الأهواء هناك أسباب أخرى دفعت كثيرا من الأفراد والمؤسسات لتبني الإلحاد ولنترك الكلام عليها لعالم الفسيولوجيا – الكيمياء الحيوية د .وولتر لندبرج اذا يقول :
(( ويرجع إنكار وجود الله في بعض الأحيان إلى ما تتبعه بعض الجماعات أو المنظمات الإلحادية ، أو الدولة ، من سياسة معينة ترمي إلى شيوع الإلحاد ، ومحاربة الإيمان بالله ، بسبب تعارض هذه العقيدة مع صالح هذه الجماعات أو مبادئها )) .
هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها العالم إزاء الدين والعلم ، عصبية عمياء ، ومصالح مادية وسياسية ، هي التي دفعت فلاسفة الإلحاد إلى ما دعتهم إليه ، من الإعراض عن الدين ، وإنكار الخالق ، والزعم بأن العلم يناقض الدين ، مستغلين المكتشفات الحديثة ، والقوانين العلمية التي وقفوا عليها أسوأ استغلال .
بل ذهب بعض فلاسفة الإلحاد المعاصر إلى درجة أبعد من هذا ، ألا وهي إتباع المغالطات من أجل دعم إلحادهم ونقدهم للفكر الديني ، فالمهم عندهم إبطال الدين ، وليس الحقيقة العلمية التي يتباكون عليها .
اتجاه الفكر الإلحادي إلى المغالطة :
فها هو جان بول سارتر ، الفيلسوف الفرنسي الملحد ، يعلن حينما زار مصر في الستينيات – يعلن في جامعة القاهرة أنه ملحد ،وأنه لا ضرورة للدين ، ويستدل على ذلك بمقياس علمي وراء المقاييس العلمية الأربعة التي ذكرناها ، ولم يقل به عاقل من عقلاء الأرض ، يستند به إلى جزئية معينة ، لا تدل إلا على نفسها ، وليست لها أية علاقة بغيرها ، ومن ثم يجعلها قانونا علميا يبطل به الدين فيقول :
(( أنه فيلسوف ملحد ،وأنه لا ضرورة للدين ، لأنه يعيش مع صديقته منذ خمسة وعشرين عاما بدون عقد زواج شرعي ، وانه يشعر بالسعادة ، ولذلك فهو ليس بحاجة للدين )) .
ليس دليلا على عدم الوجود . . فمن زعم انه لا يوجد في الفضاء قمر صناعي لأنه لم ير بعينه أو بمنظاره ، فكلامه هذا باطل ، لأنه إذا لم يتمكن من رؤيته فليس معنى هذا أن القمر غير موجود ، فربما رآه غيره ، ولكنه يدل على قصور الناظر والباحث عن القمر .
وكان بامكان كاكارين ومروجي كلامه أن يستدلوا بهذا المنطق فيما لو قلنا لهم أن الله كملوك الأرض ، يجلس في الدائرة التي طاف حولها رائد الفضاء ، على أننا لو قلنا له هذا لما كان في كلامه دليل على عدم وجوده ، لأنه ذا عجز هو عن رؤيته لقصور وسيلته ، لما كان عجزه هذا دليلا على عدم الوجود ، فقد يراه غيره . . وهو موجود .
إلا إننا لم نقل هذا ، ولم نزعمه والله لا يجري عليه الزمان ، ولا يحده المكان ، ولذلك كان بحث كاكارين عبثا ، وكلامه ساقطا ، لأنه بعيد كل البعد عن عقيدة الإلوهية .
ولكن هل قال كاكارين هذا الكلام ، وهو مؤمن به ، أظن أنه ما قاله إلا مغالطة وإيهاما ، وإلا فهو يعلم مدى سعة هذا الكون الذي سبح فيه ، والذي يعجز هو وأمثاله ، لا عن التفتيش فيه عن الله ، بل يعجز عن تصوره وتصور سعته ، إن كاكارين يعلم أنه يغالط ، لأنه ما جاب كل الكون ومن ثم فليس من حقه أن يقول هذا الكلام .
هذه أمثلة بسيطة عن المحاولات الخاطئة التي سلكها فلاسفة الالحاد المعاصر من أجل الوصول إلى غاياتهم ، تدلنا دلالة قاطعة على أن الأمر ليس أمر دين وعلم وإنما هو أمر عصبية وعناد وتحكم .
نظرية دارون على فرض صحتها لا تؤدي للإلحاد :
وكما أنهم استعملوا القوانين العلمية التي وقفوا عليها ، والتجارب التي شاهدوها ، كما أنهم استعملوها استعمالا خاطئا للاستدلال على بطلان الإلوهية والدين ، كما مر معنا في حلقات هذا البحث ، كذلك استعملوا هنا النظريات التي استنبطوها بالقانون الرابع ، وذهبوا يهللون ويكبرون ، ويزعمون أنهم عثروا على سر الحياة ، وأنه لا داعي للقول بوجود الله .
فعندما استنبط دارون نظريته في أصل الأنواع الأرضية ، وإنها قائمة على النشوء والارتقاء ، وأن كل الحيوانات تطورت من الخلية الحية الواحدة ، حتى وصلت إلى ذروة رقيها في الإنسان ، ذهب فلاسفة الإلحاد كعادتهم ليعلنوا انه لا اله يحكم هذا الكون ويدبره ، وإنما هو الارتقاء والاصطفاء الطبيعي ، حسب هذه النظرية المزعومة .
ولكن . . بغض النظر عن صحة النظرية أو عدمه ، على أننا نؤمن ببطلانها عقلا وشرعا ، وبغض النظر عن هذا ، هل تفيد هذه النظرية هذا الذي ذهبوا إليه من إنكار الخالق وبطلان الدين ؟!
أو ما تساءل العقل الحديث من أين أتت الخلية الحية الأولى ، والعقل البشري لا يؤمن بالصدفة في احتمال وجودها لاستحالته ؟
أو ما تسائل العقل البشري لماذا يعمل الجميع باتجاه نتيجة واحدة ، من أجل الوصول إلى العقل المدرك .
وإذا فرضنا صدق التكهن بأن الخلية الأولى وجدت صدفة ، أفيجوز لعاقل أن يؤمن بأن هذه الصدفة تتكرر ملايين ، ملايين المرات وبنظام واحد ، واتجاه واحد ، ولنتيجة واحدة ؟
إن العقل ليرفض هذا رفضا قاطعا ما لم يكن هناك موجة لهذه العناصر نحو تلك النتيجة . . . ؟
ولذلك وجدنا دارون نفسه يعترف بهذا ، ويقول : إن نظريته لم تأت لتهدم الأديان والعقائد ، وإنما لتفسر بعض المظاهر ، وانه يؤمن بوجود قوة مدبرة وراء هذه العناصر تسيّرها نحو الغاية والهدف ألا وهي قوة الله ، فقد قال عند كلامه على نشوء العين وتدرجها في الكمال قال :
(( يجب التسليم بأنه توجد قوة مدبرة مظهرها الانتخاب الطبيعي ، تراقب دائما ما يحدث من العوارض على الطبقات الشفافة للعين )).
فكلامه واضح في أنه لا ينفي بنظريته الإلوهية ، بل يثبتها ، أو يجوز لمن جاء بعده أن يستغل هذه النظرية من أجل نفي الخالق ، وصاحبها يثبت بها وجوده ؟
وليس دارون فقط هو الذي اعترف بوجود الخالق من خلال نظريته ، بل تابعه عليه كثير من أتباعه وأنصاره ، كالعلامة الفزيولوجي جوفروا سانتيلير في كتابه أصول الفلسفة الزولوجية اذ يقول : (( إن تسلسل الأنواع مظهر من أفخم المظاهر للقوة الخالقة ، وسبب لزيادة الإعجاب بها وشكرها ،وحبها )) .
كما يقول العلامة الفرنسي كاميل فلامريون في كتابه ( الله في الطبيعة )(16) :
(( إن الزعم بأن الخلية تتكون بذاتها وتترقى بطبيعتها بقيامها على اتجاه ثابت ، نحو نتائج متدرجة في الكمال ، يعتبر كنصف اعتراف بأن هذه الطبيعة مقودة نحو الكمال بسبب عاقل .
كيف يعقل أن الطبيعة الميتة تفكر في أن تترقى على التعاقب في شكل نباتي ثم حيواني ثم إنساني ، وأن تكون هذه الأعضاء التي تؤلف الكائن الحي ، وتكون كفوا لحفظ الحياة في خلال القرون ، وأن تبني هذه الأجهزة التي بها الكائن الحي يكون في اتصال مستمر بالأشياء المغايرة له ؟
بأي اتفاق مدهش تكونت هذه الأعضاء رويدا ، رويدا لأجل توصيل المؤثرات الخارجية إلى الجسم ، ثم ارتبطت هذه الأعضاء بالمخ المدرك الذي هو وحده يحكم ويفهم ؟ إلى أن قال : ” أن فوق كل هذه الإستحالات الممكنة للكائنات ناموسا لا يتحول ، يقود ترقي الطبيعة منذ بدء تكون الأنواع الأولية . . أن العقل الخالق المدبر الذي نسميه ” الله ” هو أذن القانون الأول الأبدي والقوى الصميمة العامة المؤلفة للوحدة الحية للعالم ” .
فهذه اعترافات المؤمنين بالنظرية ، يجهدون من أجل إثبات وجود الله من خلالها ، فما لأولئك الذين يريدون أن يستغلوا العلم أسوأ استغلال وأقبحه بعد أن قال صاحب النظرية ومؤيدوه أنهم يؤمنون بوجود الله من خلالها .
ونحن لا نذكر هذه النظرية وما قيل عنها للدلالة على صحتها ، فقد ذكرت أننا نرفضها علما وشرعا كما رفضها العلم الحديث ، ألا أننا نسوق هذا لنبين أنه على فرض صحتها في عقول المدافعين عنها ،على فرض هذا هي لا تؤدي إلى
جحود الخالق ونفيه كما يزعم مستغلو العلوم ، وفلاسفة الإلحاد .
إن ما ذكرناه عن نظرية دارون من أنها – على فرض صحتها – لا تؤدي إلى النتيجة التي وصلوا إليها وهي نفي الإلوهية – إن ما ذكرناه عن هذه النظرية يمكن أن نذكره جوابا على كل نظرية أو قانون علمي يمكن أن يطرح في هذا الموضوع .
التحكم في تعيين الحقائق :
على أن كل ما توصل اليه العقل الحديث من نظريات وقوانين من خلال الملاحظة والاستنتاج ، انما هي تفسيرات لما يجري أمام العلماء من المشاهد والحركات والتفاعلات ،وليست هي الحقيقة في الواقع ونفس الأمر ، وأما الحقيقة فلم يستطع العلماء أن يضعوا أيديهم عليها يقينا ، ولذلك كان من الممكن أن تتغير هذه النظريات الشارحة ، او القوانين المستنبطة بتغيير وسائل المشاهدة والملاحظة وتطورها ، بل هذا هو الواقع ، كما سنبينه من خلال المثال الآتي :
حقيقة المادة :
لقد حار العلماء في معرفة حقيقة المادة التي تتركب منها الأشياء المحسوسة في الكون ، فقد تبنى العلماء لمئات السنين نظرية الفيلسوف اليوناني ديمو كريت من أن الأجسام مكونة من ذرات صغيرة جدا لا تقبل الانقسام ،وأنها متأثرة بقوتين ، قوة تجذب بعضها إلى بعض ،وقوة تميل إلى تنفير بعضها من بعض، ففي الجسم الصلب تفوق قوة الجذب قوة الدفع ، وفي الجسم السائل تفوق قوة الدفع .
وقالوا بعد تهذيب هذه النظرية : إن كل ما في الكون ينقسم إلى مادة وقوة ، فالذهب والنحاس والخشب مثلا ، مادة ،والحركة ، والحرارة ،والكهرباء ، قوة ،والقوة والمادة مختلفتان ، ولكنهما متلازمتان ، فلا قوة بلا مادة ، ولا مادة بلا قوة .
والقوة والمادة مختلفتان ، ولكنهما متلازمتان ، فلا قوة بلا مادة ، ولا مادة بلا قوة ، وان كلا منهما أزلي أبدي ، أي غير قابل للفناء ، وان الأجسام لا تختلف في حقيقتها ، وإنما في ترتيب ذراتها .
وأما القوة فهي مظهر من مظاهر التموجات التي يحدثها الجسم في الأثير ، فإذا تموج الأثير بسرعة معينة أنتج الصوت ، واذا تموج بسرعة أخرى أنتج الكهرباء ، وهكذا ، وما دامت المادة والقوة أزليتان ، إذن فلا موجد لهما . . فلا داعي للقول بوجود الخالق في زعمهم . .
ولكن هل هذا الذي توصلوا إليه هو الحقيقة حتى يلزم منا ما ادعوه من نفي الإلوهية ؟ الواقع : لا ، لقد قامت نظريات علمية جديدة في المجامع العلمية ، تبطل هذه النظرية وكان ذلك على أثر اكتشاف الراديوم وبعض العناصر الأخرى ، وذلك أنه شوهد أن من خواص هذه العناصر أنه ينبعث منها على الدوام حرارة وضوء وكهرباء ، فمن أين تصدر هذه القوة ؟
لقد لا حظ العلماء بعد تجارب دقيقة ومضبوطة أن مادة تلك العناصر تنقص شيئا فشيئا ، وأن القوة التي تتحول منها في ظروف خاصة إلى مادة أخرى من قبيل الراديوم ، تسمى هليوم ، فاستنتجوا من ذلك أن مواد هذا النوع من الأجسام تتحول إلى قوة ، وأن القوة قد تتحول إلى مادة .
ثم وسعوا مدى هذه النظرية فقالوا : إن جميع الأجسام تشع على الأجسام ضوءا ، وكهرباء ،وحرارة ، مثل الراديوم ، ولكن ببطء شديد جدا ، بحيث لا يمكن مشاهدته بحواسنا ، ولا بالآلات ، ولكن يمكن إظهاره تحت تأثير المغناطيس ، مما اضطر العلماء إلى الأعراض عن القول بعدم تلاشي المادة والقوة وذهبوا إلى القول بتلاشيها .
وقالوا : أن الذرة مركبة من بروتون وإلكترون ، وأن الإلكترون يدور حول البروتون بحركة منتظمة هائلة السرعة ،وليس البروتون أو الإلكترون هما النهاية التي يقف عندها انقسام المادة ، بل إنها تنقسم إلى دقائق أصغر منها حجما تنتج من تحطم الذرة ، مما يكون الحرارة ، أو الكهرباء ، أو الضوء . ولهذا لم يعترفوا لها بمادتها ، بل اعتبروها قوة ، أو أن كل واحدة منها كمية من الأثير تدور حول مركزها .
والخلاصة أن المادة والقوة شيء واحد يتحول كل منهما إلى الآخر ، وإن المادة لا وجود لها ، وأن ما في الكون إنما هو القوة فقط .
والذي أريده من سياق هذا الكلام عن المادة هو أن ما يتوصل إليه العلم الحديث من النظريات أنما هو شرح لظاهرة معينة ، وليس كشفاً للحقيقة ، وإلا لما كان قابلا للتغيير .
ومادام الأمر كذلك فليس لإنسان أن يتحكم ويقول : إنني عرفت الحقيقة وكشفت السر ، فلا داعي لأي قول آخر يخالف قولي أو كشفي ، لقد بنوا على قولهم : إن المادة أزلية أبدية أنه لا ضرورة للقول بوجود إله أوجدها ،إلا أن المشاهدات الجديدة ، والمعلومات المتطورة أثبتت بطلان هذا من وجهين :
الوجه الأول :
ما ذكرناه من تحطم الذرة وتحولها إلى طاقة أو قوة ، أي أنها قابلة للفناء ، وكل ما كان قابلا للفناء فليس بقديم ، ولذلك لابد له من موجد .
والوجه الثاني :
هو القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية الذي يثبت بكل قطعية خطأ القول بأزلية الكون ، وذلك لأن العلوم تثبت بكل وضوح أنه يوجد في هذا الكون انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة ، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية ، بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة .
ومعنى هذا أن الكون يتجه إلى حالة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام وينضب فيها معين الطاقة ، وعند ذلك تتوقف العمليات الكيماوية والطبيعية ، وتندثر الحياة .
ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ، والعمليات الكيماوية لا تزال مستمرة ، فإننا نستنتج بكل ثقة أن هذا الكون ليس أزليا ، وإنما هو حادث ، وإلا لكان من المفروض أنه قد انقرض منذ أمد بعيد ، ومادام حادثا ، فلابد من محدث أوجده على هذه الحالة (17).
ولقد اعترف برتراند رسل بهذه الحقيقة فقال : (( إن نشأة الإنسان وحياته وآماله ومخاوفه وعواطفه وعقائده وحواسه ، وبطولته ، لا يمكن أن تحول بينه وبين الموت ، وجميع ما قام به عبر الأجيال مصيره الفناء المرتبط بنهاية المجموعة الشمسية ، إن جميع ما حققه الإنسان من نصر ، وما بناه من مدنية ، سيدفن تحت أنقاض هذا الكون ، وان هذه الأمور جميعا حقائق لا تقوى فلسفة من الفلسفات على إنكارها)) (18).
إذن فكل ما أمكن الوصول إليه من نظريات إنما هو شرح لما يجري في هذا الكون وليس إدراكا للحقيقة ، ولذلك كان قابلا للتبدل والتغير .
يقول وليم كروكس الكيماوي الانجليزي الشهير في خطبة له في المؤتمر العلمي المنعقد في برلين سنة 1903 (19) :” لقد ظهرت في القرن التاسع عشر نظريتان على ذرات المادة ، فالكهرباء والأثير وهي نظريتنا الحالية على تركيب المادة يمكن أن تظهر لنا مرضية ، ولكنها إلى أي حال ستؤول يا ترى في آخر القرن العشرين ؟ ألم تعلمنا الضرورة هذا الدرس ، وهو أن مباحثنا ليست إلا ذات صبغة وقتية ؟ !
ويقول أبرسولد : ” لقد كنت عند بدء دراستي للعلوم شديد الإعجاب بالتفكير الإنساني ، وبقوة الأساليب العلمية إلى درجة جعلتني أثق كل الثقة بقدرة العلوم على حل أية مشكلة في هذا الكون ، وعندما تزايد علمي ومعرفتي بالأشياء من الذرة إلى الأجرام السماوية تبين لي أن هناك كثير من الأشياء التي لم تستطع العلوم أن تجد لها تفسيرا ، أو تكشف النقاب عن أسرارها
وبرغم أن العلوم تستطيع أن تقدم لنا نظريات قيمة عن السدم والنجوم والذرات وغيرها من العوالم الأخرى ، إلا أنها لا تستطيع أن تبين لنا مصدر المادة والطاقة التي استخدمت في بناء الكون ، أو لماذا اتخذ الكون صورته الحالية ، والحق أن التفكير المستقيم والاستدلال السليم يفرض على عقولنا فكرة وجود الله “(20)
إلى أن قال اجوست سباتييه في كتابه ” فلسفة الأديان ” : ” إن العلماء أول المعترفين في كل فرع من فروع العلم بأنهم لم يدركوا منه إلا جزءا محدودا ، وأن أكثرهم تواضعا هم أكثرهم علما ، على أنهم كلهم يعترفون بأن ما حصلوه للآن من الاكتشافات وما درسوه من هذا الجزء اليسير من الطبيعة ليس إلا عدما بالنسبة لما يجهلونه (21)
إذن فالبحث في تفسير مظاهر الطبيعة والمادة والكون لا زال بحثا ساذجا ، يخضع كل يوم للتبدل والتغير ، بتبدل وسائل العلم والمعرفة وتطورهما ، وليس إدراكا للحقيقة في الواقع ونفس الأمر ، وبناء على ذلك ، فإننا نرفض رفضا قاطعا ربط فلاسفة الإلحاد بين هذه النظريات المتطورة وبين الإلوهية والدين ، ولا سيما أنها قد فشلت في تفسير مظاهر الكون والطبيعة تفسيرا حقيقيا ، إلا أن العلماء قد أعطوا مثل هذه النظريات قوة الأمور المبنية على المشاهدة ، ماداموا لم يصلوا إلى نظرية أفضل منها .
فإذا جاز للعقل الحديث أن يقبل تفسير هذه النظريات لمظاهر الطبيعة ، مع أنها متطورة ، ومتغيرة ، وليست وصولا إلى الحقيقة ، وإنما هي أمور ظاهرة أثبت الواقع فشلها في كثير من الحالات ، باعتراف العلماء ، أفلا يجوز للمؤمن أن يقبل تفسير الدين لمظاهر الطبيعة مع أنه تفسير ثابت ، موافق للعقل والمنطق ، لم يستطع إنسان أن يثبت تخلفه في حالة من الحالات ، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا ؟
بلى يستطيع ، ليس بالعصبية التي جرى عليها فلاسفة الإلحاد ، وإنما بالحق والمنطق ، وبنفس الأسلوب الذي يؤمن به العقل الحديث .
(1) ص / 6 .
(2) الدين في مواجهة العلم ص / 7 .
(3) الإسلام يتحدى ص / 62 – 63 .
(4) المرجع السابق .
(5) الإسلام يتحدى ص / 64 .
(6) الدين في مواجهة العلم ص / 19 .
(7) دائرة معارف القرن العشرين 4 / 31 .
(8) الدين في مواجهة العلم ص / 11 .
(9) الاسلام يتحدى ص / 58 .
(10) الدين ص / 12 .
(11) الإسلام 58 .
(12) ص / 57 .
(13) الدين ص / 45 .
(14) الاسلام ص / 58 – 59 .
(15) الله يتجلى في عصر العلم ص / 11 .
(16) ص / 435 عن دائرة معارف القرن العشرين 8 / 503 – 504 .
(17) الله يتجلى في عصر العلم ص 6 و 27 .
(18) المرجع السابق ص / 52 .
(19) دائرة معارف وجدي 8 / 500 .
(20) الله يتجلى ص / 76 – 37
(21) دائرة معارف وجدي 8 / 501