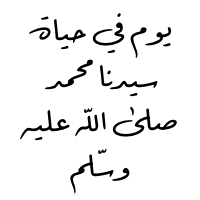أمثلة لبعض مالا يستوعبه العقل من التعبديات والغيبيات
ولذلك قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : ” لو كان الدين بالرأى ، لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره ” لأن الفَرْضَ فى مسح الخف مسح ظاهرة ، ومع أن الذى يتلوث أثناء السير هو أسفل الخف ، لا أعلاه ، فلو أردنا أن نحكم العقل فى هذه المسألة لحكم بوجوب مسح أسفله لا أعلاه .
ومن نظائر هذا فى الأمور التعبدية :
1- خروج الريح من الدبر ، فإنه ناقض للطهارة ، ويوجب الوضوء فى أعضاء الوضوء الأربعة ، وهى الوجه واليدان ، والرأس ، والرجلان ، ولا يوجب غسل محل خروج الريح ، وهو الدبر ، ولو حكمنا العقل ، لحكم بوجوب غسل محل خروج الريح ، المؤدى إلى الحدث ، لأنه هو المناسب فى حكم العقل للغسل ، وذلك حسب إمكانيات العقل .
2- الحكمة فى مشروعية الوضوء هى النظافة ، واسمه المشتق من الوضاءة يدل عليها ، ومع ذلك نرى الشارع يأمرنا عن عدم الماء بالتيمم ، وهذا ليست فيه نظافة ، بل هو تعفير للوجه واليدين بالتراب ، ولو حكمنا العقل فى هذه أيضاً لنفاها واستبعدها ، وهذا أيضاً دليل على عجزه وقصوره .
ومن هذا أيضاً لو أن الإنسان أراد أن يفكر بعقله فى الخلود الأبدى فى الجنة أو الناء ، مما لا يضبط بملايين السنين ، ولا بالمليارات ، ولا بمليارات المليارات ، حتى ولو كان الحساب بالسنين الضوئية ، فإنه لا نهاية له ، ولذلك فإن كل رقم رياضى حقيقى أو وهمى سوف لا تكون له أية نسبة أمام اللانهاية ، التى سيعيش فيها الإنسان بعد البعث ، الإيمان بمثل هذا والتسليم له .
الجواب على هذا وبكل بساطة : لا
ولا أريد أن أستطرد بسرد الأمثلة من فروع الفقه أو مسائل العقيدة ، فهى كثيرة ، لا حصر لها ، وكلها تعتمد على الإيمان بالغيب ، ويعجز العقل معها عن الحركة والعمل ، ولا يجد بداً من التسليم .
العقل عاجز عن استيعاب ما وراء طاقته من وقائع الحياة :
ولكن سأتكلم على وقائع الحياة المادية التى نشاهدها ، أو نسمع عنها صباح مساء ، وكلها تدر على مدى العجز والقصور عند العقل البشرى فيما إذا كانت الأمور وراء طاقته وقدرته .
فلو أن رجلاً أخبر أجدادنا قبل مئة عام بأن بعد مئة عام سيتوصل الناس إلى ضرب من العلم يستطيعون بواسطته أن يصعدوا إلى القمر ، بل إلى أبعد كواكب المجموعة الشمسية … ، وأنهم فوق هذا سيتمكنون – وهم فى هذا البعد السحيق عن الأرض – سيتمكنون من قراءة الكتاب الذى نحمله بأيدينا ونحن على الأرض ، بل يعرفون ماذا يوجد تحت أرجلنا فى باطنها مما نجهله ونحن عليها ، وأنهم سيتمكنون وهو على الأرض من عد ضربات قلب الإنسان وهو على سطح القمر … لأنكروا هذا فى ذلك الوقت أيما إنكار ، ولسخروا من قائله ، ونسبوه إلى الجنون والهذيان ، لأن العقل كان عاجزا فى تلك الحقبة من الزمن عن إدراك الحقيقة التى صارت بديهية فى حياتنا اليوم .
لكنه رغم هذا التقدم العلمى الهائل فى مجال الكون ، والحياة ، والصناعة ، مما فاق الخيال وسبقه ، رغم هذا نجد أن العقل البشرى اليوم قد أصبح يقر بالعجز عن ادارك حقائق الكون والحياة أكثر من أى يوم مضى ، رغم كشفه لكثير من أسرار الكون والحياة ، ومشاهدته لتغيراتهما وتقلباتهما .
بل هو اليوم معترف بعجزه وقصوره عن الإحاطة بجانب واحد من جوانب الكن والحياة ، بعد أن اطلع على إعجاز القدرة الإلهية فيهما .
بل إنه ليقف اليوم ذاهلاً عاجزاً ، ليس عن إدراك حقائق الكون والحياة ، بل عن إدراك حقائق أصغر الكائنات المجهرية الجرثومة الحية … مما يؤدى بحياة المئات والآلاف دون أن يستطيع الطب أن يقدم لهم شيئاً .
فإذا ما ثبت لدينا أن العقل عاجز عن إدراك الحقائق التى بين جنبيه ، ثبت لدينا من باب أولى وبالبداهة عجزه عن الأمور الغائبة عن عينيه ، ووجب علينا الإيمان بها كما أخبر الشارع عنها .
وإلا أوقع نفسه فيما لا تحمد عقباه ، وسلك طريقاً لن يصل إلى منتهاه .
استبداد العقل أوقع الفلاسفة فى التناقص والكفر :
إذا ثبت لدينا أن العقل قاصر عن إدراك ما وراء طاقاته وإمكانيات ، ثبت لدينا أن خوضه فى هذا لن يصل به إلا إلى الضياع ، وأنه سوف يوقعه فى التناقص .
وذلك كالفلاسفة الذين أخضعوا كل أمر من الأمور – بدون استثناء – لأحكام عقولهم ، معتمدين عليها فى الفهم والإدراك ، ظانين أنها ستبلغهم القصد ، وتلهمهم الرشد ، ولكن الحقيقة أنها قادتهم إلى متاهات ضلوا فيها عن طريق الرشاد،وتنكبوا سبل الهداية والسداد ، ومن ثم وقعوا فى التناقص المزرى بالعقل ، وسلبوا الإيمان .
فقالوا : إن الله يعلم بما مضى من الأقوال والأعمال والأحوال ، ويعلم فى المستقبل الكليات ، ولكنه لا يعلم ما سيصدر عن الإنسان من أقواله وأفعاله الجزئية .. وهى مقولتهم المشهورة بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزيئات . وذلك لأن عقولهم لم تتصور إحاطة علم الله بالجزئيات التى ستقع فى المستقبل ، فكفروا بما قالوا ، إذ نسبوا لله الجهل .
وقالوا إن العالم قديم ، وليس بحادث ، لأن عقولهم لم تتصور حدوثه ، كما لم تتصور وجود الله ولا شئ معه فجعلوا لله شريكاً فى القدم ، فكانوا به كافرين .
وقالوا : إن الله يحشر الأرواح يوم القيامة ، دون الأجساد ، لأن عقولهم التى حكموها فى كل شئ ، لم تتمكن من تصور إعادة الجسد بعد الفناء كما كان ، وهم لم يزيدوا بهذا على ترديد ما قاله أمية بن خلف حينما أخذ عظماً بالياً ، فذروه فى الهواء ، وقال لمحمد r أتزعم أن ربك يبعث هذا ؟! ) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ( (يس : 78) وكان الجواب المحكم ، الذى لا يرتاب فيه عاقل مفكر : ) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ( (يس : 79).
إن أبسط قواعد المنطق السليم تقول : إن إعادة تركيب الآلة بعد فكها أسهل من اختراعها وتصميمها ، فمن اخترع الآلة وصممها سهل عليه إعادة فكها وتركيبها ، فالذى خلق الإنسان أول مرة ، على هذا النمط المدهش المعجز ، قادر على إعادة تركيبه وبعثه مرة ثانية ، وهو أهون عليه .
إذن فالقول بعدم إمكان بعث الأجساد وحشرها يوقع قائله فى تناقض مشين إذا كان هذا القائل ممن يؤمن بالله وأنه هو الذى خلق الأجساد أول مرة ، وهو الذى نفترضه ، على ما ذكرناه فى بداية الموضوع ، من أن كلامنا موجه لمن آمن بالله ، لا للكافر به .
الإيمان بوجود الله يستلزم الإيمان بقدمه وصفاته :
والإيمان بوجود الله ، يستلزم الإيمان بوحدانيته ، وقدمه ، وبقائه ، وإن كل ما سواه حادث أحدثه بإرادته وقدرته ، وإنه بكل شئ عليم ، وعلى كل شئ قدير ، وإلا كان التناقض المشين المزرى بالعقل .
وما وصل الفلاسفة وغيرهم إلى ما وصولوا إليه من التناقض والكفر الصريح إلا باعتمادهم الاعتماد الكلى على عقولهم ، وإطلاق عنانها بالخوض فى كل ما عن لها ، مما كان فى طوقها أو خارج عنه ، فقاسوا الغائب على الشاهد ، وتحكموا فى الحكم على الله من خلال القوانين التى حكموا بها على مخلوقاته ، حسبما سولت لهم أنفسهم ، وتصورته عقولهم ، متناسين أن الإيمان بالله يحتم عليهم الإيمان بكلامه الذى وصف فيه نفسه بأنه ) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ( (الشورى : 11) .
وهذا شئ يقتضيه معنى الألوهية ، إذ لو كان كالحوادث ، لكان متصفاً بصفاتها ، ولكان محتاجاً إلى محدث ، فالإيمان بالله يحتم الإيمان بأنه مخالف للحوادث فى أوصافها .
ولذلك قال أسلافنا رضوان الله عليهم : كل ما خطر ببالك ، فالله بخلاف ذلك .
فمن أكبر العبث أن يجود العقل فيما لا يمكن له أن يتصوره ، ولو تصوره لتصوره تصوراً خاطئاً على غرار ما يتصوره من المحسوسات ، والمفترض أنه بخلافها .
كما أخبر الله تعالى عما أعده لعباده المؤمنين به يوم القيامه ، من النعيم ، مما سمى لهم بعضه باسمه ، مما عرفوا نظيره فى الدنيا ، إلا أنه أخبرهم بأنه إنما يشبه بالاسم ، إلا أنه يخالفه فى الحقيقة ، فقال : ) وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً ( وبين هذا فى الحديث القدسى وقال ” وأعددت لعبادى مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ” .