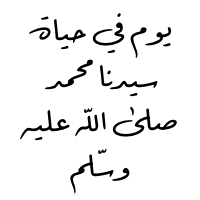الشيخ مصطفى صبري
الشيخ مصطفى صبري
شيخ الإسلام في الدولة العثمانية
بقلم: عبد الله الطنطاوي
حياته:
ولد مصطفى صبري في قرية (توقاد) بالأناضول في 12/3/1286 هـ في أسرة محافظة على دينها، محبة للعلم الشرعي، يرنو سيِّدها إلى ولده مصطفى، فيطالع فيه علامات النجابة، والذكاء، فيتطلع إلى أن يكون هذا الفتى عالماً كبيراً من علماء الإسلام.
تلقّى الطفل علومه الأولية في قريته الصغيرة، وحفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، ولفت ذكاؤه انتباه شيوخه الذين قالوا لأبيه أحمد أفندي: “إن ابنك هذا ذو عقل نيّر، وصاحب موهبة فذّة، فلابدّ من أن ترسله إلى (قيصرية). ولبّى الوالد نداء معلمي ولده، وأرسله إلى مدينة (قيصرية) لمتابعة تعليمه، وهي مدينة مشهورة بعلمائها الكثر، وهناك العلوم العربية، والعلوم الشرعية، كما تعلّم المنطق، وأصول المناظرة، والوعظ.
ثم انتقل إلى الآستانة لاستكمال تعليمه في جامع السلطان محمد الفاتح، وتلقّى العلوم الشرعية والعربية على أيدي الشيخين العالمين: محمد عاطف بك الإستانبولي، وأحمد عاصم أفندي، وأعجب الشيخان بهذا الشاب، بذكائه الحاد، وبجدّه ونشاطه، وبجرأته الأدبية في طرح أفكاره، وبلغ الأمر بالشيخ أحمد عاصم أفندي أن يزوجه ابنته (ألفية هانم) لما وجد فيه من مزايا لم يجدها مجتمعة في غيره من تلاميذه الكثر، وذلك بعد نجاحه في امتحان التخرج، وحصوله على إجازة التدريس في جامع محمد الفاتح، عام 1307هـ.
وظائفه:
- تمَّ تعيين الشيخ مصطفى صبري مدرّساً في جامع الفاتح، بعيد تخرجه وحصوله على الإجازة في التدريس وهو في الثانية والعشرين من العمر، وكان جامع الفاتح أكبر جامعة إسلامية في الآستانة آنذاك، ومنصب التدريس فيه منصب مرموق يتطلع إليه العلماء من سائر أنحاء البلاد، وقد فاز في الامتحان، وكان الأول على ثلاثين عالماً من أصل ثلاث مئة عالم تقدّموا لهذه الوظيفة، وكان أصغر الفائزين سناً.
كان الشيخ مصطفى من أنجح الأساتذة الشيوخ في التدريس، فقد بهر تلاميذه بسعة اطلاعه، وتبحره في شتى العلوم، وبطريقته البارعة في التدريس، فذاع صيته، وأقبل عليه الطلاب والعلماء، يحاورونه، ويسألونه، ويستفيدون من علمه وفهمه، واستكتبته الصحف والمجلات، وبرز للناس كاتباً بليغاً، ومفكراً عميقاً، ومحاوراً لامعاً، ومجادلاً لا يغلب، وقد منح الإجازة العلمية لأكثر من خمسين طالباً.
-
صار إمام الدرس السلطاني الخاص، وهو الدرس الذي كان يحضره السلطان العثماني شخصياً في أحد جوامع إستانبول السلطانية، ويحضر معه كبار الأعوان والعلماء، ويلقي الدرس أعلم العلماء، وقد عيّنه السلطان عبد الحميد في هذا المنصب لشدّة إعجابه بعلمه، سنة 1316هـ.
-
في عام 1317هـ عُيّن في قصر يلدز (قصر السلطان عبد الحميد) بوظيفة مدير القلم السلطاني الخاص، ونال في هذه المرحلة عدداً من الأوسمة والميداليات.
-
بعد ذلك بمدة قصيرة عُيّن أميناً لمكتبة يلدز، وقد وجد الشيخ مصطفى صبري ضالته في هذه المكتبة التي طالما بحث عنها، فقد كانت غنية بالمخطوطات وكتب التراث الإسلامي، فأكبَّ عليها، وأفاد منها علماً غزيراً جعله في عيون معاصريه، بحراً لا ساحل له.
-
في عام 1322هـ استقال من وظائفه، وفضّل عليها العودة إلى التدريس، وصار مدرّساً لمادة التفسير في مدرسة الوعاظ، وفي معهد العلوم الشرعية في دار الفنون، ثم انتقل بعدها إلى مدرسة المتخصصين، ليدرّس فيها صحيح الإمام مسلم.
-
في عام 1323هـ عُيّن عضواً في هيئة تدقيق المؤلفات الشرعية التابعة لدائرة المشيخة الإسلامية.
-
عُيّن شيخاً للإسلام ومفتياً للدولة العثمانية مرتين.
-
عُيّن عضواً في دار الحكمة الإسلامية.
-
عُيّن مدرساً لمادة الحديث الشريف في دار الحديث.
-
عيّنه السلطان عضواً في مجلس الأعيان العثماني.
مصطفى صبري سياسياً:
خاض الشيخ غمار المعترك السياسي في ظروف دقيقة وخطيرة كانت تمرّ فيها الدولة العثمانية، ورأى الشيخ ضرورة اقتحام هذا الميدان الحيوي الذي تباعد عنه العلماء، واقتحمه اللادينيون، كجمعية الاتحاد والترقي الماسونية التي استولت على مقاليد الأمور، وما تلا ذلك من خلع السلطان عبد الحميد الثاني، ومن هزيمة الدولة في البلقان، وفي طرابلس الغرب..
بدأ مصطفى صبري عمله السياسي بعد الإعلان عن إعادة العمل بالشروطية الثانية (الدستور) سنة 1326هـ، وخاض الانتخابات النيابية، ونجح في مجلس المبعوثان (البرلمان) عن دائرة سنجق توقاد، سنة 1326هـ وشارك في أنشطة ذلك المجلس، بل كان من أنشط النواب فيه؛ في حضور الاجتماعات، والمشاركة في الندوات ودورات المجلس، ومناقشاته الصاخبة. واحتلّ مكاناً بارزاً في حزب الائتلاف والحرية الذي أسسه مع بعض إخوانه، وصار نائب رئيس الحزب، والناطق الرسمي باسمه، ورئيس المعارضة البرلمانية.
ونظراً لقدرته الفائقة في الخطابة، صار أبرز الدعاة للحزب، المروجين لأفكاره ومبادئه، وسياساته المضادة لسياسة الاتحاديين، وبذلك كسب كثيراً من الجماهير، وصار حزبه يشكل خطراً حقيقياً على حزب الاتحاديين.
كما انتخب رئيساً بالإجماع، للجمعية العلمية الإسلامية التي أصدرت مجلة (بيان الحق) وأسندت رئاسة تحريرها للشيخ مصطفى سنوات طويلة.
كانت هذه المجلة من أهم المنابر السياسية المعارضة لسياسات جمعية الاتحاد والترقي، ولأفكارها، وكان الشيخ مصطفى يصول فيها ويجول، وهو يهاجم الاتحاديين، ويفضح سوءاتهم ومخازيهم وصلاتهم المشبوهة باليهود.
ودعا هذا الحزب إلى اللامركزية في الولايات العثمانية، فلقي ترحيباً من العرب، بسبب كرههم للاتحاديين الداعين إلى سياسة التتريك، واضطهاد الأجناس غير التركية، من عرب، وشركس، وأكراد، وأروام، وأرمن، وسواهم. فما كان من الاتحاديين إلا أن يعتقلوا ويلاحقوا أعضاءه، ففرّ بعض أعضائه المؤسسين والفاعلين إلى خارج البلاد العثمانية عام 1913.
وكان من جملة الهاربين الشيخ مصطفى صبري الذي غاب عن الساحة السياسية إلى نهاية الحرب الكونية الأولى، وهزيمة الدولة، وسقوط الاتحاديين، ذهب خلالها إلى مصر، وأقام فيها مدة من الزمن، ثم ارتحل إلى أوربا، وتنقّل في عدد من دولها، وعندما دخلت الجيوش العثمانية مدينة بوخارست، أثناء الحرب العالمية الأولى، وكان يقيم فيها، قبضوا عليه، وأعادوه إلى الآستانة.
وظلَّ معتقلاً حتى انتهت الحرب بهزيمة الاتحاديين، وفرار زعمائهم، فخرج من المعتقل، وعاد إلى نشاطه السياسي، وعُيّن عضواً في دار الحكمة (الإسلامية) وهي أكبر مجمع علمي إسلامي في الدولة العثمانية، وتضم كبار العلماء والمفكرين.
عندما أعيد تشكيل حزب الائتلاف والحرية من جديد، وبعد توليه السلطة في البلاد، عام 1337هـ عيّن مصطفى أفندي صبري رئيساً لمجلس المبعوثان (النواب) ثم تولّى منصب شيخ الإسلام، ومفتي الدولة العثمانية، تولّى هذا المنصب مرتين، في أواخر سنوات الدولة العثمانية، في وقت عصيب جداً. وفي أثناء هذه المشيخة، تولّى الشيخ مصطفى صبري منصب الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) بالوكالة، طوال مدّة سفر الصدر الأعظم (داماد فريد باشا) إلى فرنسا، لحضور مفاوضات مؤتمر الصلح في فرساي، قرب باريس.
وبعد عودة الصدر الأعظم من باريس، واستقالته، أعفي الشيخ مصطفى من منصبه شيخاً للإسلام، ومفتياً للدولة العثمانية، وعيّنه السلطان محمد وحيد الدين عضواً في مجلس الأعيان العثماني، واستمر في هذا المجلس حتى إلغاء السلطنة العثمانية.
مغادرته وطنه:
تفاقمت الأمور في الدولة العثمانية، وتلاحقت الأحداث العنيفة المنبئة بقرب زوال الدولة، فقرر الشيخ الرحيل عن الوطن مع أسرته عام 1923 قبل استيلاء الكماليين عليها، وذهب إلى مصر، ثم غادرها إلى الحجاز ليكون في ضيافة الملك حسين، ولكنه لم يلبث أن رجع إلى مصر، حيث احتدم النقاش بينه وبين المتعصبين لمصطفى كمال، فغادرها إلى لبنان، وطبع فيه كتابه (النكير على منكري النعمة)
ثم سافر إلى رومانيا، ثم اليونان، وأصدر فيها مجلته (يارين) ومعناها (الغد) مدة خمس سنوات، ثم غادر اليونان إلى مصر، بعد أن طالب الكماليون اليونان بتسليمه، واستقرّ فيها، وكانت الصحافة المصرية قد تحدّثت زمناً طويلاًُ عن التطور الذي طرأ على الخلافة بتجريدها من السلطة،
احتدمت المعركة حين قدم إليها، وأراد أن ينبه المصريين إلى ما يضمره الكماليون للإسلام وشريعته وأهله، وما ينطوون عليه من خبث النية وفساد الدين، وأن الخلافة التي ابتدعوها مجردة عن السلطة ليست من الإسلام في شيء، وأن فصل الدين عن الدولة ليس إلا وسيلة للتخلص من سلطانه، والتحرر من شريعته وقيوده، وتجاوز حدوده،
وظن الناس وقتذاك، أن الشيخ مدفوع في مهاجمته للكماليين ببغضه لهم، بعد أن ألجؤوه وألجؤوا الخليفة إلى الفرار، فهاجموه هجوماً عنيفاً، تجاوز في كثير من الأحيان حدود اللياقة والأدب.
ونشر مصطفى صبري مقالاً يدافع فيه عن نفسه، بعد أن نشرت الصحف نبأ وصوله، وسوء استقبال الناس له، في عبارات مملوءة بالغمز واللمز.
وكانت الصحف، على اختلاف ألوانها ونزعاتها، وقتذاك، تكيل للكماليين الثناء بلا حدود، ولذلك، بدأ الشيخ مقاله، مظهراً العجب من أمر الناس الذين أصبح قائل الحق بينهم لا يقوله إلا همساً، بينما يجهر الفجرة بمعصيتهم، وينادون بالفاسد المستحيل، فيجدون آذاناً صاغية، واستمرّ في صراعه مع الصحافة إلى أن توفي في القاهرة في 7/7/1373هـ ودُفن فيها، وكان آخر شيوخ الإسلام وفاة.
مصطفى صبري مفكراً
أيقن الشيخ مصطفى صبري أن أخطر ما تتعرض له الأمة من أخطار، وهي كثيرة جداً، خطر الغزو الثقافي الذي تبدّى في الهزيمة النفسية للمثقفين المسلمين عامة، والعرب خاصة، أمام الثقافة الغربية التي ملكت عليهم أقطار عقولهم، وأحلّوها من قلوبهم ونفوسهم محلاً ما كان ينبغي لهم أن يحلوها فيه.
ظهر له هذا في المقالات التي تُنشَر في الصحف المصرية، وما تطرحه المطابع من دوريات وكتب، فتصدّى لها بالنقد، وألّف العديد من الكتب التي تردّ عليها “وبذلك، صار لكتبه –إلى جانب قيمتها الفكرية الإسلامية- قيمة تاريخية، إذ أصبحت سجلاً صادقاً للحياة الفكرية المعاصرة، وزاد في قيمتها من هذه الناحية، أن المؤلف قد جرى في كل كتبه، على نقل النصوص التي يعارضها كاملة، قبل أن يتولّى الردّ عليها.”
كانت المهمة الأولى للشيخ، مقاومة الدعوة إلى الإلحاد، ودعوة المسلمين إلى التمسّك بدينهم، وشريعتهم، والإيمان بالكتاب كله، دون تفريق بين دقيق وجليل، ورفض كل دعوة إلى التأويل وإلى تطوير الإسلام، تحت ستار ملاءمة ظروف الحال، ومسايرة ركب الحضارة، والتطور مع الزمن. ظهر هذا في مؤلفاته:
ففي كتابه النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة، بحث مسألة الخلافة من الناحية السياسية، وهاجم الكماليين، ونفّر العالم الإسلامي عامة ومصر خاصة، منهم، وحذّر من شرورهم، ونبّه المسلمين إلى سوء نياتهم في التفريق بين الخلافة والسلطنة، وبيّن دوافع هذا التفريق، وأوضح الآثار المترتبة عليه.
وتحدّث عن فساد دين الكماليين، وعن تعصّبهم للجنس التركي، ومحاربتهم للعصبية الإسلامية، واستخفافهم بالقرآن، وبتعاليم الإسلام، وأنها غير صالحة للقرن العشرين، وقدّم نماذج من كتابات كتّابهم الداعين إلى التخلص من سلطان الدين، وإبعاده عن سياسة الدولة، اقتداء بالأوربيين،
وذكر كلمة لأحد غلاة الكماليين من الترك في أحد كتبه “إنا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئاتهم، والنجاسات التي في أمعائهم”. وقدّم المؤلف أمثلة بالقوانين التي خالفوا فيها الشرع، وأن الكماليين خرجوا من عباءة الاتحاديين الملاحدة، لا فرق بينهم، فهم مثلهم في صلتهم باليهود، وتواطئهم مع الإنكليز، وردّ على الذين نصحوه بعدم مهاجمة مصطفى كمال أتاتورك، لتعلق المسلمين به.
وقال لهؤلاء:
ليست من وظيفة العلماء محاباة العامة، ومجاراة الدهماء، بل وظيفتهم إطلاع الناس على حقائق الأمور، ولابدّ من بيان عصبية الكماليين لقوميتهم التركية، وتعصبهم لطورانيتهم إلى حدّ العداوة للإسلام، ومهاجمته، باعتباره ديناً عربياً، وإحيائهم لعقائد الترك الوثنية في جاهليتهم الأولى، وإحلالهم المشاعر القومية محل المشاعر الإسلامية.
وقال: إن الكماليين والاتحاديين حزب واحد، ولعنة الله على الاتحاديين الذين أدخلوا السياسة في الجيش، فسنّوا بهذا سنّة سيئة صارت آفة على الدولة، وصار الجيش آفة على الدولة، وقادوا الإمبراطورية إلى حربين ضيّعوا فيهما الخلافة والدولة والأمة، وقال: “ولن تجد ملة أو قوماً خارج بلادنا وداخلها دامت مودّة الاتحاديين والكماليين معهم إلا اليهود” ولهذا لم يسلم جنس من عدوانهم في تركيا، لا الألبان، ولا العرب، ولا الأكراد، ولا الأرمن، ولا الشراكسة، ولا الأروام.. ما سلم من عدوانهم إلا اليهود.
وفي كتابه: مسألة ترجمة القرآن، ناقش شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي في مقاله (بحث في ترجمة القرآن وأحكامها) الذي كان فيه صدى لما فعله الكماليون في تركيا، الذين أمروا بترجمة القرآن إلى اللغة التركية، وحملوا المسلمين على الصلاة بها، بدلاً من لغة القرآن الكريم.. ردّ على المراغي الذي جوّز الصلاة بالقرآن المترجم إلى التركية، كما ردّ على محمد فريد وجدي الذي أيّد صنيع الكماليين.. وقد نقل الشيخ صبري نقولاً كثيرة من مقال المراغي، ومقالي وجدي في معرض الردّ عليهما، ناقشهما، وبيّن فساد آرائهما من الناحية الشرعية بأدلة كثيرة قوية، ونبّه إلى ما سوف ينجم عنها من أخطار، كما ردّ على ما أباحه المراغي من جواز الاجتهاد في الفقه استناداً إلى الترجمة.
وفي كتابه: موقف البشر تحت سلطان القدر: ردّ على من زعم أن تأخر المسلمين وتواكلهم وانحطاطهم وتخلفهم إنما يرجع إلى إيمانهم لعقيدة القضاء والقدر، وفنّد آراءهم ومزاعمهم بحجج قوية.
وفي كتابه: قولي في المرأة، ومقارنته بأقوال مقلِّدة الغرب، سدّد طعناته عبر ردود قوية ومفحمة لأصحاب الدعوات المشبوهة التي جرّت الناس إلى مستنقعات التهتك في التبرج، والابتذال على الشواطئ، والاختلاط الداعر.. وهو ردّ على اقتراح اللجنة التي تقدمت إلى مجلس النواب المصري، طالبة تعديل قانون الأحوال الشخصية، والأخذ بمبدأ تحرير المرأة، وتقييد تعدد الزوجات، وتقييد الطلاق، ومساواة المرأة بالرجل في الميراث، وما إلى ذلك من أمور أخذتها اللجنة والدعاة إلى التغريب، من أوربا.
وفي كتابه: القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون. ردّ على الماديين الملاحدة الذين يشككون بوجود الله تعالى، وعلى الذين ينكرون الغيب، والنبوة والمعجزات، وعلى العلماء الذين يؤولون المعجزات تأويلات تساير روح العصر المادي، حتى صار إيمانهم بالعلم المادي فوق إيمانهم بكتاب الله، وسنّة رسوله.
ومن رأي الشيخ، أن أخطر ما ابتُلي به المدافعون عن الإسلام من الكتّاب الذين تثقفوا بالثقافات الحديثة، أن المستشرقين قد نجحوا في استدراجهم إلى أن يُنْزلوا النبي الكريم منزلة العباقرة والزعماء، حتى إنهم حين يدافعون عما يوجَّه إليه من افتراءات، يدافعون عنه من هذه الزاوية، وعلى هذا الأساس، ويفعلون ذلك باسم العلم.. والواقع أن ذلك نزول بالإسلام إلى أن يصبح مذهباً فكرياً أو سياسياً أو فلسفياً ككل الآراء، ونفيٌ للصفة الأساسية في كل رسالة سماوية، وهي أنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى.
وأما كتابه البديع: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، وعباده المرسلين. وهو آخر ما ظهر للمؤلف من كتب في حياته، وطبعه عام 1950 في أربعة مجلدات كبيرة، فقد احتوى خلاصة آراء الشيخ في السياسة، والاجتماع، والفلسفة، والفقه، كما احتوى معاركه الفكرية مع عدد من أعلام عصره، كالمراغي، ووجدي، العقاد، وهيكل وسواهم.
ذكر المؤلف أنه ألّف هذا الكتاب، بعد ما رآه في تركيا من انصراف المتعلمين عن الدين، وما يراه في مصر من مثل ذاك الانصراف.
قال في مقدمته، مخاطباً روح أبيه: “لو رأيتني وأنا أكافح سياسة الظلم والهدم والفسوق والمروق في مجلس النواب، وفي الصحف والمجلات، قبل عهد المشيخة والنيابة وبعدهما، وأدافع عن دين الأمة وأخلاقها وآدابها وسائر مشخصاتها، وأقضي ثلث قرن في حياة الكفاح، معانياً في خلاله ألوان الشدائد والمصائب، ومغادراً المال والوطن مرتين في سبيل عدم مغادرة المبادئ، مع اعتقال فيما وقع بين الهجرتين، غير محسّ يوماً بالندامة على ما ضحيت به في هذه السبيل من حظوظ الدنيا ومرافقها- لأوليتني إعجابك ورضاك”.
وكان الشيخ فيه عنيفاً على من رأى فيهم خصوماً في الفكر والتوجّه، ولولا تلك الحدّة والشدّة، لكان كتاباً فريداً في بابه، ولكنه كان سيفقد أهم ما تميّز به قلم الشيخ الذي لقي الألاقي في عمره المديد.
فقد تصدّى للمستغربين، وردّ على ما يثيرونه من شبهات حول الإسلام والداعين إليه، من مثل قولهم: “كيف يمكن أن تكون الحكومة حرة ومستقلة إذا قيّدت نفسها بالدين؟”.
وردّ على زعم المستغربين: أن العلماء المعممين ليسوا من ذوي الاختصاص، ولا يُعتدّ بهم وبعلمهم الشرعي، ودعا العلماء إلى الاشتغال بالسياسة. وقال:
“فالعلماء المعتزلون عن السياسة، كأنهم تواطؤوا مع كل الساسة، صالحيهم وظالميهم، على أن يكون الأمر بأيديهم (بأيدي السياسيين) ويكون لهم (للعلماء) منهم رواتب الإنعام والاحترام، كالخليفة المتنازل عن السلطة وعن كل نفوذ سياسي”.
مصادر ومراجع:
1 – قولي في المرأة: مصطفى صبري.
2 – موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، وعباده المرسلين: مصطفى صبري.
3 – النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة: مصطفى صبري.
4 – النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: د. محمد رجب البيومي.
5 – الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسين.
6 – تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني: أحمد صدقي شقيرات.
7 – الأعلام: خير الدين الزركلي.
8 – أعلام القرن الرابع عشر – الجزء الأول: أنور الجندي.