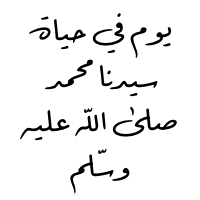سفراء بلا حدود
سفراء بلا حدود
المقدمة
السفير يعبر عن رأي بلده، وانتقاء السفير يرجع إلى أهمية الدولة التي سيمثل بلاده فيها، وهو حريص كل الحرص على عدم الإدلاء بشيء يسيء إلى سمعة بلاده
كما أن سياسته في التصريح لا تخرج عن الضوابط التي وضعت له كسفير، ولا يعني ذلك الانضباط الحرفي بل القواعد العامة لهذه الضوابط…. وكل مسلم سفير، إما سفير محسن فيحسن، وإما سفير سوء فيسيء….
وسفيرنا الذي نريد تقديم أوراق اعتماده قد سبقه سفراء كثيرون قد أساءوا كثيرا وأعطوا صورة سيئة للسفارة، مما يدعو بالضرورة لاختيار سفير يستطيع أن يصحح وضعا سابقا، ويبلغ وضعا جديدا مختلفا، فلابد من اختيار موفق لسفير يقوم بأعباء الوضعين
أعني التصحيح والتبليغ…..
وأهم ما يميز سفيرنا الواعد أن يتكلم فيما يعلم، وأن يعلم فيم يتكلم، ولا يستحي إذا تكلم أن يقول فيما لا يعلم فيه.. لا أعلم أو لا أدري، وذلك هو المأثور عن الأكابر، وقد أثر عن سيدنا عمر قوله: “نصف العلم لا أدري”…
وقد أجاب الإمام مالك بلا أدري عن ست وثلاثين مسألة من أصل أربعين ولم يمنعه كونه مالكا أن ينقل عنه ذلك لأنه يعلم أنه مأجور بلا أدري كأجره بأدري.
الحياة الدبلوماسية حياة خلط وتخليط تقوم على المجاملة وحسن التخلص، ولا يشترط في حسن التخلص هذا، الصدق في القول أو الفعل، بل أينما تكون المصلحة يكون رديفها الموقف، فلا اعتبار للصدق أو الكذب في هذه الحياة
وحتى لا أكون مغاليا أقول يكون ذلك في غالب الحال وليس على كل حال، وحسن التخلص فن وأدب وظرافة يزيده رونقا وبهاء الصدق في حسن التخلص، وإليك أمثلة جميلة على ذلك،
قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:
{فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ} يوسف76….
دفعاً للتهمة عن نفسه، ولو بدأ بوعاء أخيه لشكّوا بأنه هو الذي وضعه ولكنه بدأ بأوعيتهم ليدفع هذا الشك….
ومن حسن التصرف ومراعاة الخطاب حسب مقامات الناس قوله تعالى على لسان الشاهد من أهل زوجة العزيز:
{إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ }يوسف26
قدم قول الصدق لامرأة العزيز اعتبارا لمركزها كسيدة للبلاط، وأخر قول سيدنا يوسف باعتباره عبدا في هذا البلاط…
ومن حسن التخلص والتصرف كذلك قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون:
{وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ}
غافر28…
قدم دعوى الكذب وجزاءها على موسى وأخر دعوى صدق موسى حتى لا يشعروا بإيمانه وأنه على دين موسى…..
هذه هي الدبلوماسية الصادقة وهذا هو فن التعامل مع الموقف وهكذا ما يجب أن يكون عليه سفيرنا، فينبغي عليه إذا تكلم أن يختار من الكلام ما يناسب المقام، فليس كل حق يكون مقبولا، ما لم يوضع في مكانه ونصابه، بل ربما جر هذا الحق باطلا أو أوجد نفرة أو وحشة،
وفي مثل ذلك ما حدث لي عندما كنت مدعوا مرة إلى غداء، فقام أحدهم عندما جلسنا إلى المائدة يذكرنا بطعام أهل النار من الصديد والغسلين أو مثل من يزور مريضا ويخبره أن فلانا قد مات بمثل مرضه، وينبغي أن يكون منطق سفيرنا يبعث على الثقة والارتياح، فلا كلام متكلف، ولا ابتسامة مصطنعة ممجوجة، بل عفوية في التعبير والتبسم، يبعثان على القبول وينشران الثقة والارتياح، فالطبيب الماهر الفطن يظهر أثر علاجه على مرضاه قبل أن يبدأ العلاج.
بين تقوى الذات وتقوى الحزب
التقوى أساس العمل، حيث يقوم عليها الصدق والإخلاص وهي باعث داخلي بإعمال أوامر الله ونواهيه وحراستها ابتغاء مرضات الله، أي أن العمل ليس نابعا من رقابة حزب أو قوانين صارمة لدولة أو مؤسسة
كنت أتناقش مرة مع أحد الشباب عن الحاجة إلى الرقابة الذاتية وضرورة وجودها لضمان صحة سير العمل واستمراره فقال: نستطيع الاستغناء عن ذلك برقابة المؤسسة أو الحزب، فقلت: أيهما أسهل ميكانيكية؟
فقال: المهم النتيجة..
فقلت: لو خلا رئيس الحزب مثلا على حين غفلة من الحزب، وخلو مساءلة من الحزب، بخزانة الحزب أو بتقارير ضده وأراد إتلاف هذه التقارير أو اختلاس بعض ما في الخزانة، ما الذي يمنعه من ذلك إن لم يكن له مانع من نفسه من الله؟
ماذا سيقول؟
إني أخاف سكرتارية الحزب أو أخاف عفلق أو لينين فسكت محدثي…
أنا لا أقول أن رقابة الحزب ليست ذات جدوى على سير العمل ولكن اذا كانت الرقابة تنبع ذاتيا من أفراد الحزب فذلك هو كمال المراقبة لا رقابة الحزب.
وسفيرنا يتحرك بالرقابة الذاتية منطلقا من “إن لم تكن تراه فإنه يراك”… وإذا واتاه الظرف في الخلوة للمخالفة قال: إني أخاف الله…
كما ينبغي لسفيرنا أن يعتز بدينه ولا يخضع لظروف الحوادث ويخشى الله في الناس ولا يخشى الناس في الله فذلك مما يدعو لاحترام الغير له وإعجابا بمبادئه التي يريد للغير اتباعها، وفي ذلك ما حدث لأحد أصدقائي وهو الدكتور علي اليعقوب وأحب أن أحدث به دائما..
يقول، عندما كان يحضر لرسالة الدكتوراه، أن الأستاذة التي كانت تدرسهم كانت صارمة في التعامل معهم والجميع يخطب ودها لتراعيه في الدرجات..
يقول، وفي إحدى المرات أقام الطلاب لها حفلا، وجاءت الحفلة واصطف الجميع لمصافحتها، وفي حينها كنت أفكر قبل أن يأتيني الدور ماذا أفعل؟
هل أصافحها فأرضيها وأغضب ربي، أم لا أصافحها فأرضي ربي فأغضبها؟
وجاءني الدور فلما مدت يدها امتنعت عن مصافحتها، واحتقن الدم في وجهي أكثر من احتقانه في وجهها، وفي الصباح أرسلت تدعوني إلى مكتبها، وعندما أتيت سألتني لماذا أردت إذلالي أمام الطلاب في الحفل؟
فأجبت: لم أرد ذلك، بل غاية الأمر أن ديني يمنعني أن أصافح النساء…
يقول فانقلب غضبها علي إعجابا بي عندما عرفت مرادي… وكان أن أعطتني أفضل درجة بين الجميع.
ما أحلى الرجوع إليه
العقل ضابط الأعمال القلبية والجارحة، فهو قيد القلب، وحارس الجوارح، ومناط التكاليف، لذا اشتق اسمه من صفته ولما كان القلب متقلبا كاسمه، حبيسا وراء قضبان العقل، فهو دائم التَّفَلُّت، يتحين الفرص للفرار من قفصه، طلباً للحرية المطلقة بعيدا عن قيود المشرع
وحين ينجح القلب في الفرار من حبسه، تدخل العاطفة من الباب ليخرج العقل من النافذة، فتعم الفوضى مملكة الجوارح….
وسفيرنا أحق الناس بإعمال عقله… فسفيرنا منظور، ومن سفرائنا من هو منظور متبوع وهو أكبر خطرا من سابقه، فالتبعية كثيراً ما تلغي عنه ضوابط المراقبة، والتسقطية تحصي عليه الأنفاس، والحركات والسكنات
فلابد أن يحتاط لنفسه ما لا يحتاطه غيره، وأن يكون حجم عمله عنده كحجم مكانته هو عند الناس، فلا يتوسع فيما يتوسع فيه العوام فلا يكثر من المباح، والمكروه عند العوام يجعله بمثابة الحرام عنده في العمل، وكذلك ما كان مندوبا عندهم يكون واجبا عليه…
ومن ذلك قول أحد الصحابة لأحد التابعين: “إنكم لتعملون أعمالا لا تأبهون بها كنا نَعُدُّها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبال، ولا ينافس العامة فيما يتنافسون، بل ينافس فيما يتركون.
سأل الحسن البصري بم سوَّدَك الناس؟ أى (جعلوك سيدهم)
قال: استغنيت عن دنياهم واحتاجوا إلى ديني”…
هكذا يجب أن يكون خلق سفيرنا لتتم له التبعية بالتورع والسيادة بالاستغناء…..
وسفيرنا أولى الناس بالرجوع إلى عقله، ومعرفة ما ينوء بثقله من المسؤوليات، فهو لا يأبه بالمخاصم، ولا يرد على المجادل، ضنين على وقته أن يضيع بالمراء.. فهو يمضي حيث يؤمر غير ملتفت إلى أحد.
سفير وليس نبيا
سفيرنا يطلب المثالية على نقص والناس يطالبونه بالمثالية على الكمال… و البون شاسع بين المثالية وبين من يطلبها… فلا يصح من الناس أن يتصوروا فيه كمال المثالية، فهو الطالب لا المطلوب، وهو المثال لا الحقيقة…
لذا فإننا عندما نطلب منه الكمال لابد أن نلتمس له بعض النقص، فلا نعظم هفواته بمجهر الكمال، بل نغمرها في بحر النقص ومما لا ينفك عنه البشر…
كنت مرة ذاهبا إلى مسجدي، وكان قرب باحة المسجد مواقف فأوقفت سيارتي قرب المسجد بعيدا عن المواقف… فجاءني أحد المصلين يقول: لماذا لم توقف السيارة في المواقف؟
قلت: هكذا… هل وقوفي في مكانٍ ممنوعٌ فيه الوقوف؟
قال: لا… ولكنك شيخ فكيف تترك المواقف وتقف أمام المسجد؟
قلت: وهل وقوفي سيضايق أحدا من المصلين..؟!
فقال: لا ولكن الأفضل في كونك شيخا أن تقف بموقف السيارات.
انظر إلى دقة المحاسبة فهو يحصي عليك مخالفة الأولى لا الممنوع أو المحظور، وهكذا يتصور كثير من الناس الدعاة، فهم يطالبونهم بجلائل الأعمال في حين لا يريدون أن يغفروا لهم دقائقها.
ذو الطبيعتين
جبلت النفس على الخلطة، والأنس بالناس، ودواعي المخالطة عديدة، منها ما لابد منه مما يقوم عليه شؤون الناس ومصالحهم ومنها ما يكون على سبيل المجالسة والمفاكهة، وفي كل يكون التأثر والتأثير ومسارقة الطباع
ولما كانت المخالطة من دواعي الفطرة، فلابد من ضبطها كمثيلاتها…. والمعنى أن النفس إذا أدمنت المخالطة أدى ذلك بالضرورة إلى الأنس بالمخلوق والاستيحاش بالخالق…
كثيرٌ من المصلين لا يصبر بعد الصلاة على التسبيح على كونه لا يتعدى دقائق قليلة، ويا ليتنا ننظر إلى الساعة قبل التسبيح وبعده حتى نعرف كيف نشح بالوقت على الخالق في حين نبذله بلا حساب للمخلوق..
فتجد بعضهم يبادر بعد التسليم من الصلاة بالخروج من المسجد، فكأنه قد فرض لله قدرا معلوما من الوقت يمن به لا يجاوزه، وكأن التسبيح خارج هذه الحسبة….
حينما ينادي المنادي حي على الصلاة… إنما يدعوك للاجتماع بصاحب الدعوة سبحانه… وقد حدَّ لك الداعي وقت الاجتماع بالصلاة فرضا وبالتسبيح ندبا، وكلاهما طلب وليس من الأدب مفارقة صاحب الدعوة قبل أن يأذن…
ومن الناس من يكون مستعداً للذهاب إلى الديوانيات أو الاستقبالات وإن بعدت، ويمكث الساعات الطوال يتكلم فيما يعنيه وما لا يعنيه، فإذا دُعِيَ إلى مجلس علم أو تذكير كَبُرَ ذلك عليه وشق
وإذا ذهب مكرها، جلس صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء، أو يغشيه النعاس لعباً من الشيطان، أو يتسقط من الكلام ما يقنع به نفسه بعدم جدوى الحضور، أو إذا أكره نفسه على الذهاب، أرضاها بعدم العودة مرة أخرى…
وكل ذلك بسبب إدمان النفس على الخلطة وتوحشها بها… فلابد لها من ترويض، وترويضها يكون بالتدرب على العزلة، ولا أعني العزلة المطلقة المقابلة للمخالطة، بل خلطة بعزلة وعزلة بخلطة بالضوابط التي لا تخل بمقاصدهما
أي إذا شاء خالط وإذا شاء اعتزل… وهذه صفة سفيرنا ذي الطبيعتين.
كلموا الناس بما يعلمون
كثيراً ما يغيب على المتكلم رتبة السامع، فينبغي له التنبُّه إلى ذلك، لأن قبول كلامه يتوقف غالبا على رتبة السامع، فإما أن يكون المخاطب أعلى رتبة من المتكلم في العلم أو الثقافة فيكون في خطابه كمن يهدي الخِضَاب إلى الشباب أو يبيع التمر في هجر…
أو يكون مساوياً له في الرتبة، وليس هذا ببعيد من ذاك إلا أن يكون الطرح مختلفاً عند المتكلم عنه عند المخاطب
أو يكون أعلى رتبة من المخاطب فيكون له قصب السبق ليصول ويجول، ولكن عليه أن يحذر الكبوة التي تخرجه من حلبة السباق
وأعني ينبغي عليه ألا يستهين بالمخاطب اعتمادا على تفاوت الرتبة، فربما أدرك المخاطب مع تواضع رتبته مالا يدركه متكلمنا مع سمو منزلته، فتنقلب المراتب وتنعكس فلا يكون للقبول بعد ذلك من محل أو للكلام من معنى….
وفيما يشبه ذلك ما يغيب على المتحدث أثناء حماسه عن إثبات الكرامة، الإكثار من حدوثها لأناس، حتى يكاد يلغي خرقها للنواميس وبهاء الإكرام بها مما يجعله ساذجا في نظر السامع الذي ربما يكون له من العقل أكثر مما يكون لمتكلمنا من عاطفة وحماسة، فتسقط الرتبة ويرفض القبول
أو أن يكثر من تفنيد ما يحتاج إلى التقييد، أو يطيل في إيضاح واضح أو شرح مشروح مما يبعث على السآمة والملل، ويوقع في قلب السامع عدم معرفة المتحدث لقدره فيزيده على السآمة منه والملل نفورا
أو يعتمد على اعتقاده لِعُلُوِّ مرتبته فلا يُحَضِّرُ لما يريد قوله استخفافاً منه بمراتب الناس،
كخطيب الجمعة الذي حضرت له مرة فبدأ الخطبة بفضائل النكاح وختمها بالكلام على شرائط التوبة، فخرجت من المسجد لا أدري بأيتهما أعجب؟
باستخفافه بالناس أم بصبر الناس على استخفافه
وما دمنا في ذكر المسجد فلا بأس بذكر حادثة أخرى لبيان جهل بعض المتحدثين بما يحتاجه السامع
حدثني أحد الظرفاء يقول: دخلت مرة أحد المساجد لصلاة الجمعة وجلست أنتظر الخطيب والمسجد غاص بعمال النظافة و الوزارات، ودخل الخطيب ليخطب فكان موضوع الخطبة في شرائط وجوب الزكاة، وأنا أتطلع عن يميني وشمالي، ومن ورائي وأمامي، فلا أجد إلا الصنفين الأولين من أصناف الزكاة، وأعني الفقراء والمساكين، فكنت أضحك في نفسي وأقول: إما خطيبنا متدرب، أو دخل المسجد الخطأ فقال ما قال
أو جاهل، ما ظننت أن يبلغ به جهله ما بلغ.
بين أدب النصيحة وأدب النقاش
قبل أيام كنت أصلي العشاء بمسجدي، وبعد انتهاء الصلاة أحسست بمن ينظر إلي، فنظرت فإذا بشاب حسن الهيئة واللحية، قصير الثوب، وحين انتهيت من تسبيحي، وفرغ المسجد تقريباً من المصلين، اقترب الشاب مني حتى كاد يلامس بشفته أذني وقال:
صوتك جميل وأداؤك خاشع، وسررت كثيرا بالصلاة خلفك وعندي عليك ملاحظة،
فقلت: تفضل.
فقال وهو يبالغ في الإسرار: أنت مسبل وثوبك طويل
فهممت أن أرد عليه متأدباً بأدب النقاش، وأنني أقول بقول من اشترط الخيلاء في الإسبال كما هو معروف في الحديث، وأن المسألة محل خلاف، إلا أن أدبه الجم في النصيحة ألجم أدبي في النقاش، فلم أملك من أمري إلا أن قلت له:
حاضر، منكسرة بأدبه….
انظر كيف بدأ هذا السفير نصيحته، استهلال بثناء ومديح، وهو مما تطرب له النفوس وترتاح، لا يهمني إن كان محقا في ثنائه أم مجاملا، ما يهمني هو توطئته الجميلة لنصيحته الأجمل.. شكراً لسفيري المجهول.
سفير فوق العادة
سفيرنا يلعب أكثر من دور حسب ما يتطلبه الظرف والحال، فإن دعا الظرف إلى ضرورة العرض تحول إلى مندوب مبيعات، وإن دعا إلى علاج حالة تحول إلى طبيب، أو إلى ترويض تحول إلى مدرب أو دعا الحال إلى ذلك كله فعليه أن يلعب الأدوار كلها، فسفيرنا سفير فوق العادة.
الكلمة الحانية البسيطة تفعل في النفس مالا تفعله الكلمة الجافية صاحبة الحجة البالغة، وهذا ما تعتاده النفوس، والنصيحة هدية والعبرة في الهدية بكيفية تقديمها لا بقيمتها…
نحن نشتري الهدية وربما نصرف على تغليفها وتنميق عبارة تقديمها ما يعادل نصف قيمتها مبالغة في القبول.
والنصيحة سلعة نريد ترغيب المشتري بشرائها، فلابد من اختيار الوقت المناسب لعرض السلعة، ومن غير المناسب أن يتصل المندوب بالهاتف وقت القيلولة، ليعرض سلعته على الزبون الذي شرع في النوم أو غط فيه، ولك أن تتصور حالته وهو يرد على الهاتف في هذه الحالة
فكذلك النصيحة لا يأتي سفيرنا لغضبان قد غرق في الغضب لينصحه بذم الغضب، وأن الغضب شعلة من نار، وأن الغضبان شيطان، فربما صب من ناره وشيطنته عليه
ولابد لسفيرنا من تنويع نصيحته حسب حال المنصوح وليحذر الاقتصار على الترهيب أو الإكثار منه أمام العوام
وقد سألني أحدهم وكان من أهل المال واليسار، يقول: لماذا يخوفوننا بالنار؟
قلت هذا لا يصح، فمرة بالترهيب بالنار، ومرة بالترغيب بالجنة.
فقال: لا، لا نريد الكلام عن النار، نريد فقط الكلام عن الجنة،
فقلت: عندما تدرس جدوى مشروع، ألا تدرس محاذيره، ومخاوف فشله، واحتمال خسارته، أم تقتصر على ذكر أرباحه ومميزاته وإمكان فتح أفرع جديدة له؟ّ!
جهل أس2
رأيك بنفسك أهم من رأي الآخرين فيك، ولن يتأتَّى لك إدراك هذه الأهمية إلا بمعرفتك لنفسك قبل أن تعرف بها الآخرين
والذي يتعرف على نفسه من خلال الناس سيكون جهله بنفسه أشد من جهل الناس فيه، فاصنع ظلك على الناس بنفسك ولا تأخذه من ظل الناس عليك لترسله عليهم مرة أخرى
وما أكثر ما صنع ظل الآخرين على الآخرين من ألقاب، وما أخطر وما أشد أثر هذه الألقاب على أصحابها وعلى الآخرين
فاللقب هالة جامعة مانعة، جامعة لإعجاب الآخرين بك، مانعة بمعرفتك لنفسك، وهذه الألقاب قالبة للمفاهيم، فهي تعبث بالحقائق وتعكس الموازين وتورث جيلاً يحمل شؤم هذه الموروثات،
كما أنها تنوع الجهل بين الناس، فكأننا لا يكفينا جهل الناس بدينهم حتى يجمع عليه جهل الناس بأنهم يجهلون دينهم، وأعني الجهل المركب، وهو ما يعانيه كثير من حملة الألقاب، وما يعانيه الناس من هؤلاء الحملة أكبر
هؤلاء سفراء لم يتدرجوا في “السلك الدبلوماسي” بل تولى واحدهم السفارة وهو بعد لم يصل إلى رتبة سكرتير ثالث، ومع ذلك باشر تمثيل دولته فأساء…
وهذه طرفة لا بأس من إيرادها لنختم بها هذه الشجون….
حصل شاب على دبلوم بالكيمياء بالمراسلة، وكان بهذا الدبلوم فخورا، وفي أحد الأيام أصيب هذا الشاب بالتهاب في اللوزتين، فكتب لنفسه وصفة طبية…
وبعد أن قرأها الصيدلي سأل الشاب:
كم هو عمر الكلب المريض؟