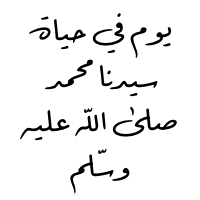مكاشفة الذات
مكاشفة الذات
مقدمة..
من ظن أن هناك من بلغ أعماق ذاته فقد تمغلط، لأنها تكشف له في كل مرة عن غور لم يكن يعتقد أنه سيصله أو انه سيظهر له أو يطلع إليه…
ومن ظن أن هناك من بلغ الصدق مع ذاته فقد بالغ، لأن الصدق متوقف على مكاشفة النفس، والنفس ترفض هذه المكاشفة والتفتيش…
ومن ظن أن هناك من استطاع الانتصار على نفسه فقد تخايل، لأنه إن لم يبلغ الغور ولم يطق المكاشفة فمن أين له بالانتصار..
ومادام هذا الاحتمال قائما فليس هناك ما لا يتوقع وقوعه من هذه الذات..
أنا لا أطعن في النوايا ولا أحاكم القلوب، ولكني احتكم دائما إلى العقل وواقع الحال، فكما أن النوايا مناط الأعمال،
فكذلك الأعمال كواشف للنوايا، لأن العمل إذا لم يكن له ما يبرره وينيطه بهذه النية، فمن الحمق والسذاجة أن نتعسف له في العذر بلغ صاحبه ما بلغ من الصلاح…
يظن البعض عندما ننتقد أحدا من أهل الفضل أو العلم والصلاح أننا نسيء إليه أو لا نحسن الظن فيه أو لا نحبه، وذلك لأنه كون له صورة كمال لا يريد أن يتصور فيها ما لا يمكن تصوره منها
وبناء عليه عنده فإن من تقوى الله ومخافته عدم التعرض له، فيخلط بهذا التصور العاطفي بين ذات هذا الشخص وبين أقواله وأفعاله.. فيصبح الكلام على قوله كلاما في ذاته..
القادم من تايلند
كنت مرة في مجلسي فدار الحديث حول مسألة من مسائل الإجماع، وأن المخالف لا يعتد بخلافه مالم يكن مجتهدا مطلقا، فقال أحدهم:
ولكن الشيخ فلان يقول بخلاف هذا الإجماع الذي ذكرت،
قلت: لايعتد بكلام فلان هذا الذي تقول،
قال: هذا الشيخ مجتهد مطلق..
قلت: من أنبأك هذا؟
قال: أنا أعلم أنه مجتهد مطلق..
قلت: هل تعلم أن ابن تيمية على جلال قدره والنووي على وفور علمه لا يعدان من أهل الاجتهاد المطلق؟
فهل يكفي وصفك إياه بهذه الصفة حتى يكون مجتهدا مطلقا؟
وما ضوابط المجتهد المطلق التي تعرفها؟
قال: هو رجل عالم والناس جميعها تحبه، بل وقد جاء رجل من تايلند يريد أن يستفتيه..
قلت: ومن قال إني لا أحبه أو أنني أنفي عنه صفة العلم، ولكن مجيء رجل من تايلند ليستفتي شخصا، ومحبة الناس للشخص ليست من ضوابط الاجتهاد المطلق،
قال: كتبه تدل على علمه..
قلت: صدقت.. فقط تدل على علمه… ثم أغلقت باب هذا النقاش العاطفي.
نحن نعاني كثيرا من هذه الظاهرة التي تريد إقصاء العقل، وإعمال العاطفة..
من قال إنني عندما أتكلم عن فلان أو أنتقده أنني لا أحبه، أو أعتبر نفسي أفضل منه أو أريد الإساءة إليه…
يقول يحيى بن معين: “إنا لنطعن على أقوام ربما حطوا رحالهم في الجنة منذ مائتي عام”.. ويحيى بن معين هو صاحب الإمام أحمد وأحد أئمة الجرح والتعديل..
وهو عندما يقول هذا الكلام يعني أنه يتكلم في الرجال، يجرح من يجرح، ويعدل من يعدل رعاية وحماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بغضا لواحد وحبا لآخر…
فمتى ما دعي الداعي جاز الكلام بضوابطه التي تحفظ للرجل هيبته مع بيان ماله وما عليه… هذا ما نريد.. عقلا نتحاكم إليه لا عاطفة نستأسر عقولنا لها.. نريد عقلا في جرأة، لا جرأة في عاطفة.. فلا معصوم إلا من عصم الله…
لاشك أن الغالب في الصالح الصلاح، وشرف صلاحه يدفع عنه كل مالا يمكن تصوره منه… يقول أهل الأدب:
كفى الصادق شرفا أن يصدقه الناس ولو كذب، وكفى الكاذب شؤما أن يكذبه الناس لو صدق.. فكذلك الصلاح يحجب ما لا يتصور من الصالح ما ينافي صلاحه…
ديننا دين الفطانة لا دين الدروشة والغفلة، وخبايا النفس لا يكاد ينجو منها أحد، وإليك من شأن هذه الخبايا ما يعجب…. ”
قال إمام الأئمة ابن خزيمة: يصف محمد بن الحكم ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الحكم..
ثم قال: لما مرض الشافعي رحمه الله جاء ابن عبد الحكم ينازع البويطي في مجلس الشافعي، فقال البويطي: أنا أحق به منك، فجاء الحميدي وكان بمصر، فقال:
قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه.
فقال له ابن عبد الحكم: كذبت،
فقال الحميدي: كذبت أنت وأبوك وأمك،
وغضب ابن عبد الحكم فترك مجلس الشافعي”..
طبقات الشافعية- 2\68
فيا أيها الأحبة.. أهل الفضل والعلماء رجال يعملون ويخطئون وليسوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون…
أنا لا أخص أحدا بكلامي دون أحد ولكنني أقرر حقائق أريد أن أدفع بها أحكاما تبنى غالبا على العاطفة والذوات، لا على العقل والاستدلالات…
هذه الخبيئة الخاملة الكامنة في أغوار النفس الصالحة، عندما تنشط لأي سبب تخرج منها على صورة ما لا يمكن تصوره من الصالح.. وصور ذلك كثيرة،
ولكني سأقصر كلامي على حب الشهرة والظهور لأنه الأكثر شيوعا والأشد خفاء وخطرا على الناس، فهو من باب ما لا يتصور وقوعه لمن عرف بالصلاح،
وحب الشهرة والظهور لا يكون ظاهرا في حق من عرف بالصلاح كظهوره على غيره، بل تتأوله النفس تأولا مرحليا حتى تظهر له حساب ما لم يكن في حسبانه،
وتحيل ما كان يرى فيه بأسا إلى ما لا بأس فيه، وتقلب عليه ترتيب تكاليفه، وتدفعه دفعا إلى البحث عن التعاليل والأسباب، ولن يعجز مثله عن التنظير بمثلها، وسأل في ذلك من كانوا، وماذا صاروا؟!
وحب الظهور مما تهفو إليه النفس وتطرب له، وهو من باب حب الثناء والمحمدة إلا أنه زائد عليه في انتشار ساحة المدح ومعرفة الناس للممدوح وفي ذلك مالا يخفى في الرغبة في طلبه…
ومن الطرائف في طلب الشهرة والظهور ما ذكر عن الحسن بن أحمد بن البقاء الحنبلي أنه قال: “هل ذكرني الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الثقات أو مع الكذابين؟
قيل ما ذكرك أصلا.. فقال يا ليته ذكرني ولو مع الكذابين..”
ألقاب وإقلاب
لا أظن أن هناك كثيرا من يخالفني رأيي عندما أقول أن الألقاب قد فقدت هيبتها وبهت بريقها وازدحم الناس على طلبها لسهولة الحصول عليها، ويحزنني أن أخص ألقاب الشريعة وما يحزنني أكثر هو استباحة هذه الألقاب وبالأخص لقب العلامة..
فما أكثر ما نسمع عن استضافة العلامة الفلاني، أو فتوى العلامة الفلاني، أو مفتي الأنام العلامة الفلاني، ويا ليت شعري ما يعنيه بمفتي الأنام التي لا أعرف من أين أتى بهذا اللقب، وهل يوجد هذا في الخارج أم هو من باب المطلق؟؟!د
أعود إلى لقب العلامة..
لا أريد أن أقطع وأقول، لو علم من يلقب هؤلاء الرجال بلقب العلامة، لو علم معناه لأحجم عن بذله هكذا دون حساب، وسأذكر تعريف العلامة، لعل في هذا التعريف من سبيل إلى رادع…
يعرف العلامة بأنه “من كان من العلوم بحيث يقضى له من كل علم بالجميع”..
ويلزم من هذا التعريف أنه لكي يكون الإنسان علامة، يجب أن يكون إماما في كل فن، فهو في اللغة إمام وفي الفقه إمام وفي الحديث إمام وفي التفسير إمام وفي الأصول إمام وفي علم الكلام إمام وفي الأدب إمام فهل من علاماتنا اليوم من حاز معشار هذا اللقب؟
بل إن بعض من يلقب بالعلامة اليوم من لا يحسن التجويد… ولكنها العاطفة والسطحية في المعرفة…
يقولون أقوالا ولا يعلمونها ●●● ولو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا
علم الله أنني عندما أتكلم في ذلك إنما أتكلم من باب إنزال الناس منازلهم، ومن باب إزاحة العاطفة والبعد عن التهاويل الفارغة، فما حاجتنا اليوم إلى هذه الألقاب؟
بل وما حاجتنا إلى علماء يحملون هذه الألقاب على الحقيقة.. هل بعث النظّام أو الجبّائي أو المريسي حتى نحتاج إلى من يناظرهم ويقارعهم الحجة.
كثير ممن يحمل هذه الألقاب لو فتحت صندوق علمه لوجدته فارغا إلا من بعض زواياه ومع ذلك يعده العوام عالما..
نحن لا نحتاج اليوم إلى علامة حقيقي بقدر ما نحتاج إلى علماء درسوا العلم على أصوله على الثقات من العلماء وتأدبوا بأدب الطلب، يجيبون على أسئلة العوام التي لا تتعدى الطهارة والصلاة وبعض الصور البسيطة في المعاملات ثم يتصدى فيما بقي له من علم لبحث ما يستجد من مسائل يحتاجها الناس، هذا ما نحتاجه قياسا على مستوى الناس…
سألني أحدهم هل ينتقض وضوئي إذا قصصت أظفاري؟
فأحسست بالبون الشاسع بين أمة اليوم وأمة الأمس حين يقول أحد الأئمة دخلت بغداد فوجدت خبازين يتناظران في مسألة من مسائل الكلام،..
فهل بعد سؤال نقض الوضوء بقص الأظفار تحتاج الأمة إلى علامة؟؟!
إمساك العصا من الوسط
لا يعلم حلاوة الشهرة إلا من اشتهر وذاع صيته، فما أجمل أن تسير بين العامة فيشار إليك ويسلم عليك، وتلتفت إليك رقاب النظار، وتقتحمك الأنظار…
استشعر معي قليلا ما أقول حتى تعلم معنى ما أعنيه…
هذه الحلاوة تدعو صاحبها إلى المحافظة عليها أو الاستزادة منها ودعنا نقول على غلبة الحال حتى نخرج من العموم..
والاستزادة أو المحافظة تجر إلى الميل إلى كسب القبول وبالتالي إلى البعد قدر الاستطاعة عما قد يغضب البعض…
وهذا هو ما نسميه الإمساك بالعصا من الوسط… والممسك بالعصا من الوسط رجل يحب الحق ولكنه يخشى منه ويتمنى من يكفيه مؤنة إظهاره فيكون في مأمن من النقد الذي يكون له بالمرصاد لو تكلم…
فهو يحب الحق بأقل الخسائر، وكم من حقوق تزحلقت على هذه العصا خوفا من الخسائر…
“أحسن الظن ولا تسئه، ألسنا مأمورين بإحسان الظن”..
هذا قول لابد له من قائل وأقول سمعا وطاعة لهذا الأمر ولكن ليس على إطلاقه..
حسن الظن على إطلاقه طيبة زائدة على حدها، وتقوى ليست في محلها، ولأن تسيء بعض الظن لتكون على علم خير لك من أن تحسن الظن ثم تكتشف بعد ذلك أنك مستغفل.. وحينئذ تكون ردة الفعل شديدة وربما نكوص بعد ذلك وإساءة في هذا النكوص..
الدعوة إلى الله ليست قصرا على أحد، ويعني ذلك أن الجميع مشارك، وأن له على غيره حق الشريك، والشريك لابد له أن يحاسب شريكه، لأن خطأ الواحد خطأ على جميع الشركاء،
فلماذا إذن الاستنكاف من المراقبة والمسائلة ولماذا استغرب الشك عندما يكون المقصد منه نبيلا ومطلوبا، ثم ما يضير العالم أو صاحب الفضل إن شككت فيما ارتبت منه، ثم أخطأت في شكي، أليس الحذر مطلوبا على كل حال؟!..
كنت أتكلم مع أحدهم ممن كان ملتزما في سبب تركه الالتزام، يقول: كنت أعمل مع بعض الإخوة، وكنت أرى بعض ما أستنكره من الممارسات، ولكنني في كل مرة كنت أفسر ذلك على محمل النية الحسنة، حتى اكتشفت مؤخرا أنني صادق في ظني، فكان لذلك على ردة فعل شديدة جعلتني أترك العمل مع الإخوة، ثم بالتالي تركت الالتزام…
انظر إلى حال هذا الرجل، أليس لو أساء الظن قليلا ثم تثبت، أليس من الممكن أن يكون أفضل حالا؟!
ومما يروى عن عمر رضي الله عنه “إساءة الظن من الحزم”.
عندما أقول لابد من إساءة الظن لا أعني بذلك نية الإساءة ولكني أعني أنه لا بد من إمرار القول أو الفعل عبر قناة المسائلة والاستفهام وجدوى التبرير..
وإلا فما معنى “من أين لك هذا” من عمر إلى كبار الصحابة.. أجرب عليهم ما يدعو مثله لمسائلة مثلهم؟
عند كثير من الناس يكفي لرفع الريبة كون الشخص متدينا، وعند كثير غيرهم يكفي كونه متدينا للريبة.. والفريقان على خطأ، فالريبة إن كان لها ما يبررها وإلا فالأصل السلامة من الريبة.
الجلاد القاتل
كنت أتكلم مرة مع أحدهم.. يقول: ذهبت إلى أحد المصارف الإسلامية أريد قرضا فرفض طلبي، لماذا يرفضون طلبي وأنا محتاج؟
أين الإسلام الذي يدّعونه..
قلت: على رسلك.. أنت ذهبت إلى مصرف أم إلى لجنة خيرية؟
المصرف شركة مساهمة كباقي الشركات، يريد أصحابها الربح كما تريده أنت ويريده غيرهم..
لماذا لا تأخذ شيئا بالأقساط؟
قال: وما الفرق بينهم وبين غيرهم؟
هذا ربا وذاك ربا..
قلت: كيف حكمت؟؟
قال: هذه زيادة وهذه زيادة.. ما هو الفرق؟ ألأن هذا بنك إسلامي؟
قلت: سامحك الله، الفرق في صفة العقد من حيث كونه شرعيا أو ربويا، فالعبرة في صيغة العقد لا في نوع البنك..
قال: هذه أقساط وهذه أقساط.. نفس الصورة،
قلت: خذ معي.. إذا قتل رجل شخصا ماذا تسميه؟
قال: قاتل،
قلت: لماذا سميته قاتلا؟
قال لأنه أزهق روحا، قلت وما جزاؤه؟
قال: القتل..
قلت: جميل.. فإذا قدم هذا القاتل إلى الجلاد فقام الجلاد بشنقه فما جزاء الجلاد؟
قال لا شيء عليه.. قلت: أليس الجلاد أزهق روح الرجل؟
قال: بلى، قلت: فلماذا لم يقتل به؟
قال: لأن الجلاد أزهقها بالقانون،
قلت: صورة القتل واحدة بين الجلاد والقاتل، فلم فرقت بين الحكمين هنا مادامت الصورة واحدة ولم تفرق هناك؟
المبالغة في المخالفة
عندما يرغب الإنسان أن يتميز ولا يجد له ما يميزه عن غيره يحدث ما لم يكن موجودا أو يخالف فيما هو موجود، وعند ذلك يخرج مما تعارفت عليه الناس، فحينئذ يتكلم الناس فيما خالف فيه بين مؤيد ومعارض، ومناصر ومناوئ، ومادح وقادح، فيصبح مشهورا فيما خالف فيه الناس بعد أن كان مغمورا بما كان يوافقهم عليه
وهذا ما لا يريد أن يتصوره البعض في حق بعض أهل الفضل والعلم ويجد في ذلك تحرّجا شديدا ويحاول دفعه ولو بالتعسف بالمعاذير التماسا لحسن الظن.
والخطب أيسر من ذلك بكثير.. فالكلام هنا على البعض لا الكل، وما نتكلم فيه مما يقع ليس بالأمر الذي لا يغتفر ولا يرجى من صاحبه صلاح، بل إن كلامي كله في مرض من أمراض الصالحين ولا يتنافى هذا المرض مع صلاح صاحبه ونيته وخدمته للدين، بل إنني أعتبره دليلا على القصور مهما بالغ الإنسان في طلب الكمال..
وغاية ما هناك أنني أحذر من عدم الاغترار بخطئه لا من شخصه وفضله، فما الذي يحرّجني أو يمنعني من أن أتكلم مع احتفاظي بفضله ببيان ما له وما عليه كما ذكرت ذلك أول حديثي
يقول الإمام الذهبي في ذلك: “ثم إن الكبير من أهل العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتساع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتّباعه، يغفر له زلـله ولا نضلله ونطّرحه وننسى محاسنه” 5-271..
وأما ما يفعله البعض من إعفاء للأثر وخلط للخير بالشر، ومسح لعظائم الحسنات بصغائر السيئات والنيل من أهل العلم والفضل بدعوى بيان الحق من الباطل، فليس مني ولست منه في شيء، وإنما أنا أتكلم فيما يقرره العقل واحتمال الوقوع فيما لا يندفع بعذر ولا يحتمل إلا على هذه الصورة،
وسأضرب مثلا..
عندما يأتي الشيخ الفلاني مثلا، ويخالف فعل الأمة في أمر لا حاجة للأمة اليوم فيه، وقد استقرت الأمة منذ مئات السنين على العمل على خلافه بعد أن أشبعته بحثا من حيث أحاديثه صحة وضعفا أو محكما أو منسوخا أو عاما أو خاصا، وغير ذلك مما يطرأ على الحديث،
ومن حيث الحكم راجحا أو مرجوحا، أو شاذا أو متروكا، فيأتي من يريد أن يصحح ما اتفق الأكابر على ضعفه، ويستصحب ما أجمع الفقهاء على تركه، ويتعسف في ذلك بل ويجتزئ من النصوص ما يوافق مراده..
فأين المسوّغ في العذر؟
بمخالفة الأمة أم بالكلام فيما لا تحتاجه الأمة أم بعدم الأمانة باجتزاء النصوص؟
إنني عندما أتكلم على هذا المثال من الناس إنما أتكلم من باب عدم الالتفات إلى ما يقول مما لا غناء فيه ولا طائل تحته، فما استقرت عليه الأمة لا نزعزعه، بل نبحث فيما تحتاجه الأمة اليوم مما لم يدون بفقه، ونبذل فيه الجهد خير لنا من بعثرة جهودنا فيما كفانا الأولون مؤنة البحث فيه، مع احتفاظي بالدعاء له ونصرته ومحبته..