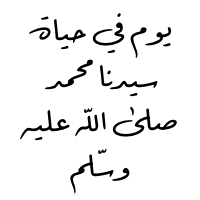بيان أخطاء الدكتور في الكلام على التوحيد،أول واجب على المكلف وما تورط فيه الدكتور من الأخطاء في بيان المسألة
38 – بيان أخطاء الدكتور في الكلام على التوحيد
وبعد الانتهاء من تحقيق مسألة التوحيد نعود إلى كلام الدكتور، فنقول: إن هذه الفقرة من كلام الدكتور قد اشتملت على أخطاء جمة:
الخطأ الأول: قوله: (التوحيد عند أهل السنة والجماعة معروف بأقسامه الثلاثة) حيث نسب تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات إلى أهل السنة، مع أن هذا التقسيم لم يكن معروفا عند أهل السنة قبل ابن تيمية، وإنما شهره وركز عليه ابن تيمية ولا يزال غير معروف ولا معترفا به إلا عند أولئك الذين اتخذوا ابن تيمية الإمام الوحيد لأنفسهم، وقد بينا فساد هذا التقسيم.
الخطأ الثاني: قوله: (وهو –أي التوحيد بأقسامه الثلاثة- عندهم –أي عند أهل السنة- أول واجب على المكلف) ولا أدرى من الذي قال من أهل السنة: إن التوحيد أول واجب على المكلف؟! وكيف يقوله قائل، ويقدم على القول به عاقل، والتوحيد لا يتصور اعتقاده إلا بعد اعتقاد وجود الله تعالى! وهل يقدم عاقل على القول بأن الواجب على المكلف أن يوحد الله تعالى توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم يعتقد وجوده؟؟!! نعم توحيد الله تعالى داخل في معرفته بحسب المعنى الذي أراده الأشاعرة من المعرفة حينما قالوا: (أول واجب على المكلف معرفة الله)، فإن مرادهم بمعرفة الله ليس اعتقاد وجوده تعالى فقط، بل معرفته بوجه يكون عدمها موجبا للكفر وعدم الإسلام واعتقاد ذلك، وهو أن يعرف أن للعالم ربا خلقه وخلق كل شيء يستحق العبادة على عباده واحد لا شريك له ويعتقد ذلك. وذلك لأن المقصود بوجوب المعرفة التخلص من الكفر، وهو لا يكون إلا بالمعرفة المذكورة والاعتقاد المذكور المشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الإ̃لهية وتوحيد الأسماء والصفات، بمعنى عدم الشريك له في صفاته وسنفصل الكلام على مسألة أول الواجب على المكلف قريبا.
الخطأ الثالث والرابع: قوله: (فالتوحيد عندهم –أي عند الأشاعرة- هو نفي التثنية والتعدد، ونفي التبعيض والتركيب، والتجزئة، أي بحسب تعبيرهم (نفي الكمية المتصلة والكمية المنفصلة) وقد اشتمل هذا الكلام على خطأين:
الخطأ الأول: حصر الدكتور للتوحيد عند الأشاعرة في الأنواع المذكورة من النفي، المفيد أنه لا يوجد عند الأشاعرة نوع آخر من التوحيد وهو التوحيد في العبادة الذي يُعَبَّر عنه بتوحيد الإ̃لهية، وقد صرح فيما يلي بأنه لا يوجد عندهم هذا النوع من التوحيد، حيث قال: (…..فهذا الذي أجزم به)
وقد علمت أن حقيقة التوحيد عند الأشاعرة: هو اعتقاد الوحدانية في الذات والصفات والأفعال، وبعبارة أخرى اعتقاد عدم الشريك في الإ̃لهية وخواصها، وقد نقلنا عن التفتازاني أنه قال: ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير العالم، وخلق الأجسام، واستحقاق العبادة، وقدم ما يقوم بنفسه كلها من الخواص.
الخطأ الثاني: سياقه لهذا الكلام مساق الإنكار على الأشاعرة، كأن الدكتور ينكر على الأشاعرة قولهم بالتوحيد بالمعنى المذكور، ولا أدرى لماذا ينكر الدكتور على الأشاعرة قولهم: التوحيد أن تعتقد أن الله تعالى واحد ليس اثنين ولا ثلاثة، ولا متبعض ولا مركب ولا متجزأ، وقد صرح الإمام أحمد وغيره بهذا، حيث قال: «إن الله عز وجل واحد لا من عدد، ولا يجوز عليه التجزؤ ولا القسمة، وهو واحد من كل وجه. وما سواه واحد من وجه دون وجه».[1]
أراد الإمام أحمد بقوله: «واحد لا من عدد» نفي إرادة الواحدة العددية من قولنا: «الله واحد» ولم يرد به نفي الوحدة العددية، وذلك لأن الوحدة من طريق العدد غير مختص بالله تعالى، بل هو لازم بين لكل جزئي حقيقي، فأنت واحد من طريق العدد أي لست اثنين ولا أكثر، وأنا واحد من طريق العدد ؛كما ان الله تعالى واحد من طريق العدد،ثم إن الوحدة العددية لا تنفي الشريك والشبيه والنظير، ومقصود الإمام أحمد بيان الوحدة لله تعالى بالمعنى المختص به وهو أنه لا يجوز عليه التجزؤ….الخ،وبمعنى نفي الشريك والشبيه والنظير؛فمن أجل ذلك نفى إرادة الوحدة العددية عن قوله: الله تعالى واحد؛ وقد سبق الإمام أحمد إلى هذا التعبير الإمام أبو حنيفة. قال-رحمه الله تعالى- في الفقه الأكبر: «الله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفُوًا أحدٌ»؟
وقال شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى: «وأما وصفه بأنه واحد فإنه يرجع إلى نفي الشريك، وأنه لا ثاني له، وإلى نفي التجزؤ والانقسام عن ذاته»[2] وقال ابن تيمية: «فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء»[3]
الخطأ الخامس: قوله: (ومن هذا المعنى فسروا الإ̃له بأنه الخالق أو القادر على الاختراع)
وقد علمت أن الأشاعرة قد فسروا الإ̃لهية بالاتصاف بالصفات التي لأجلها استحق أن يكون معبودا، فالإ̃له عندهم على هذا هو المتصف بتلك الصفات، وليس هو الخالق أو القادر على الاختراع كما يقول الدكتور. وليت شعري من الذي فسر الإ̃له منهم بالخالق أو القادر على الاختراع؟!
الخطأ السادس: قوله: (وأنكروا بعض الصفات كالوجه واليد والعين، لأنها تدل على التركيب والأجزاء عندهم) أقول: نعم قد أنكر الأشاعرة تلك الصفات بمعنى الجارحة لاستلزامه التركيب والأجزاء، وهذا النفي مما اتفق عليه سلف الأمة وخلفها، ولا أدري هل الدكتور يثبتها بمعنى الجارحة لله تعالى كما يدل عليه سياق كلامه!! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا!
الخطأ السابع: قوله: (وأما التوحيد الحقيقي وما يقابله من الشرك ومعرفته والتحذير منه فلا ذكر له في كتب عقيدتهم إطلاقا .. إلى آخر كلامه).
أقول: قدمنا أن الأشاعرة قد ذكروا التوحيد بتعريف واضح جامع مانع يتضح منه تعريف الشرك كذلك، ولكن ماذا نقول للذي يتكلم عن عدم معرفة وعدم رغبة في معرفة ما يتكلم فيه، وإنما يتكلم مندفعا عما تَمَلّكَ نفسَه وتمكن في قلبه من الحقد على أئمة الأمة وقادتها.
صحيح أنه لم يتوسع الأشاعرة في كتبهم العَقَدية في الكلام على الشرك العملي كالعبادة لغير الله تعالى والذبح له لأن موضوع كتب العقيدة هو العقيدة وليس العمل، وقد توسعوا في الكلام عليه في كتب الفقه في باب الردة وفي كتبهم في التفسير وفي شروح الحديث. نعم الشرك العملي مبني على الشرك الإعتقادي وهو إثبات شيء من خواص الإ̃لهية لغير الله تعالى، وقد بينوا الشرك الإعتقادي في كتبهم العقدية كما تقدم في كلام التفتازاني وكلام ابن الهمام وابن أبى شريف، وقال الباقلاني في “الإنصاف”: «ويجب أن يعلم أن صانع العالم جلت قدرته واحد أحد، ومعنى ذلك أنه ليس معه إ̃له سواه، ولا من يستحق العبادة إلا إياه ولا نريد بذلك أنه واحد من جهة العدد، وكذلك قولنا: أحد وفرد وجود ذلك، إنما نريد به أنه لا شبيه له ولا نظير، ونريد بذلك أنه ليس معه من يستحق الإ̃لهية سواه. وقد قال الله تعالى: (إنما الله إ̃له واحد ومعناه لا إ̃له إلا الله» وقال عز الدين بن عبد السلام: «فإن الألوهية ترجع إلى استحقاق العبادة، ولا يستحق العبودية إلا من اتصف بجميع ما ذكرناه» ثم قال: «ولا يستحق الإ̃لهية إلا من اتصف بجميع ما قررناه»[4] وقال السنوسي: «وأنواع الشرك ستة: شرك الاستقلال، وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس، وشرك التبعيض، وهو تركيب إ̃له من آلهة كشرك النصارى، وشرك تقرب، وهو عبادة غير الله تعالى ليتقرب إلى الله تعالى زلفى، كشرك متقدمي الجاهلية، وشرك تقليد، وهو عبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخري الجاهلية…»[5]
39- أول واجب على المكلف وما تورط فيه الدكتور من الأخطاء في بيان المسألة
قال الدكتور: {أما أول واجب عند الأشاعرة فهو النظر، أو القصد إلى النظر أو أول جزء من النظر، أو…! إلى آخر فلسفتهم المختلف فيها. وعندهم أن الإنسان إذا بلغ وجب عليه النظر، ثم الإيمان، واختلفوا فيمن مات قبل النظر أو أثنائه، أيحكم له بالإسلام أم بالكفر؟! وينكر الأشاعرة المعرفة الفطرية، ويقولون: من آمن بالله بغير طريق النظر فإنما هو مقلد ورجح بعضهم كفره، واكتفى بعضهم بتعصيته… وإن لازم قولهم تكفير العوام، بل تكفير صدر الأول}
قد أشار الدكتور سفر بهذا الكلام إلى مسألتين من مسائل علم الكلام، الأولى: مسألة أول واجب على المكلف، والثانية: مسألة وجوب النظر في معرفة الله تعالى، وقد وقع فيهما في أخطاء جسيمة، فلا بد أن يحقق المسألتين المشار إليهما.
أما المسألة الأولى فننقل فيها كلام القاضي عضد الدين الإيجي في المواقف مع شرحه للسيد الشريف الجرجاني مع الاختصار فيهما. ونفتتح بها الكلام، وأما المسألة الثانية فنبينها فيما بعد. وإليك كلام “المواقف” وشرحه في المسألة:
(المقصد السابع: قد اختلف في أول واجب على المكلف) أنه ماذا (فالأكثر) ومنهم الشيخ أبو الحسن الأشعري (على أنه معرفة الله تعالى إذ هو أصل المعارف) والعقائد (الدينية، وعليه يتفرع وجوب كل واجب) من الواجبات الشرعية (وقيل: هو النظر فيها) أي في معرفة الله سبحانه (لأنه واجب) اتفاقا كما مر (وهو قبلها) وهو مذهب جمهور المعتزلة والأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني (وقيل): هو (أول جزء من النظر) لأن وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه: فأول جزء من النظر واجب، وهو متقدم على النظر المتقدم على المعرفة (وقال القاضي واختاره ابن فورك) وإمام الحرمين: إنه (القصد إلى النظر) لأن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد المتقدم على أول أجزائه.
(والنزاع لفظي إذ لو أريد الواجب بالقصد الأول،) أي لو أريد أول الواجبات المقصودة أولا وبالذات (فهو المعرفة) اتفاقا (وإلا) أي وإن لم يرد ذلك، بل أريد أول الواجبات مطلقا (فالقصد إلى النظر) لأنه مقدمة للنظر الواجب مطلقا فيكون واجبا أيضا..
(وقال أبو هاشم هو) أي أول الواجبات (الشك) ثم رد الإيجي هذا القول بوجهين ثم قال: (إن قلنا: الواجب) الأول (النظر فمن أمكنه زمان يسع فيه النظر التام) والتوصل به إلى معرفة الله تعالى (ولم ينظر) في ذلك الزمان، ولم يتوصل بلا عذر (فهو عاص) بلا شبهة (ومن لم يمكنه زمان أصلا) بأن مات حال البلوغ (فهو كالصبي) الذي مات في صباه (ومن أمكنه) من الزمان (ما يسع بعض النظر دون تمامه) فإن شرع فيه بلا تأخير واخترمته المنية قبل انقضاء النظر وحصول المعرفة فلا عصيان قطعا، وأما إذا لم يشرع فيه، بل أخره بلا عذر ومات (ففيه احتمال، والأظهر عصيانه) لتقصيره بالتأخير. [6]
وههنا ينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أن المراد بمعرفة الله تعالى التي هي أول الواجبات المقصودة بالذات معرفته بوجه يكون عدم الاتصاف بها موجبا للكفر وعدم الإسلام، من معرفة وجوده تعالى ووحدانيته وعلمه وإرادته وقدرته إلى غير ذلك مما يكون عدم معرفتها موجبا للكفر، وليس المراد منها معرفة وجوده فقط. وذلك لأن المقصود من وجوب المعرفة التخلص من الكفر، وهو لا يكون إلا بالمعرفة المذكورة.
وهذه المعرفة ليست فطرية بالمعنى الذي قصده الدكتور هنا، وصرح به سابقا من أنه يولد عليها الإنسان، وينشأ عليها المسلم بلا تلقين ولا تعلم، وقد قال الله تعالى: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) بل المراد بالفطرة في قوله تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها) وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم (كل مولود يولد على الفطرة…إلخ) ما جبل عليه الإنسان من ميله إلى معرفة الحق، ورغبته في نبذ الباطل، وكونه أكثر استعدادا لقبول الخير منه لقبول الشر، وليس ذلك الحق والخير إلا الإسلام.
قال الإمام النووي في شرح الحديث: والأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئا للإسلام. انتهى
والثاني: أن المراد بالواجبات في قولهم (أول الواجبات على المكلف ما هو)
أعم مما يكون عدم القيام به موجبا للكفر أو موجبا للمعصية وذلك لأن عدم المعرفة موجب للكفر، وأما عدم النظر أو عدم القصد إلى النظر مع الإيمان على وجه التقليد فموجب للمعصية والإثم، كما تقدم في كلام المواقف وشرحه. وليس موجباً للكفر إلا عند أبي هاشم من المعتزلة. وهذه هي مسألة التقليد في الإيمان، وقال فريق من أهل السنة بعدم تأثيم المقلد بعدما جزم بما يجب الإيمان به جزما قاطعا. ولم يكفره أحد منهم.
الثالث: أن المراد بالنظر والاستدلال على القول بوجوبه هو النظر والاستدلال الإجمالي وإن لم يستطع صاحبه الإفصاح به وتقريره ودفع القوادح عنه، وهذا النوع من الاستدلال قلما يخلو عنه مؤمن، بل لو قيل بعدم خلو مؤمن عنه لم يكن بعيداً، فإن كلام العوام محشو بمثل هذا الاستدلال، ومن أجل ذلك قال بعض المحققين: إن التقليد إنما يتصور فيمن نشأ في شاهق جبل بدون أن يجري في خلده وجود الله تعالى، فأخبره مخبر بوجود الله تعالى وبصفاته، فصدقه وثوقا به بدون أن يستند إلى دليل، وأما المسلم الذي نشأ بين المسلمين فلا بد أن يحصل عنده دليل إجمالي، وغالبا ما يكون بدون نظر ولا قصد إلى النظر، ومن أقوى الدلائل الاستناد إلى صدق الرسول المؤيد بالمعجزات، وذلك لأن المراد بالتقليد الأخذ بقول الغير بغير حجة. ومن قامت عليه حجة ثبوت النبوة حتى حصل له القطع بها، فما سمعه من النبي كان مقطوعا عنده بصدقه، فإذا اعتقده لم يكن مقلدا فيه لأنه لم يأخذ بقول الغير بغير حجة.
وبهذا التحقيق ظهر ما في كلام الدكتور سفر من أخطاء.
الأول: نسبته الخلاف في أول الواجبات إلى الأشاعرة فقط مع أن المعتزلة داخلين في الخلاف، فكان عليه أن يقول: أما أول واجب عند المتكلمين.
والثاني: قوله: (وعندهم أن الإنسان إذا بلغ وجب عليه النظر ثم الإيمان) هذا مفروض عند الأشاعرة في غير المسلم الذي بلغ، أما المسلم الذي بلغ مقلدا فيجب عليه النظر عند القائلين بوجوب النظر منهم، وأما الإيمان فحاصل من قبل، ثم إن الوجوب بالنسبة إليه بمعنى أن المقلد عاص وليس بمعنى أنه غير مسلم كما حمله عليه الدكتور. نعم هو كذلك عند أبى هاشم من المعتزلة. وكذلك الاحتمالان اللذان أبداهما القاضي فيمن مات في أثناء النظر مفروض في المسلم المقلد الذي ابتدأ في النظر مع تأخيره عن زمن الوجوب بلا عذر ومات قبل الإنتهاء منه هل هو عاص عند القائلين بوجوب النظر أم لا كما تقدم في كلام المواقف وشرحه، وليس الاحتمالان في الحكم بالإسلام له وعدمه. نعم يجرى الاحتمالان في الحكم بالإسلام وعدمه بالنسبة إلى من بلغ غير مسلم، أو بلغته الدعوة بالغا وشرع في النظر بعد تأخيره عن أول زمن الوجوب بلا عذر ومات في أثنائه. فكلام المواقف عام للمكلف المسلم وغير المسلم ومن أجل ذلك عبر بالعصيان الشامل للكفر والإثم.
الخطأ الثالث: قوله: (واختلفوا فيمن مات قبل النظر أو في أثنائه أيحكم عليه بالإسلام أم بالكفر) وذلك أنه التبس على الدكتور الاحتمالان اللذان أبداهما القاضي فيمن مات في أثناء النظر بعد تأخير الشروع فيه عن أول زمن الوجوب هل هو عاص أم لا، التبس عليه ذلك بالاختلاف، كما التبس عليه الحكم بالعصيان وعدمه بالحكم بالإسلام والكفر!!!
الخطأ الرابع: نسبته القول بكفر المقلد في العقيدة إلى بعض الأشاعرة مع أن كفر المقلد لم يقل به إلا أبو هاشم من المعتزلة. قال الآمدي في إبكار الأفكار: ذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى أن من لم يعرف الله بالدليل فهو كافر، لأن ضد المعرفة النكرة، والنكرة كفر. قال: وأصحابنا مجمعون على خلافه، وإنما اختلفوا فيما إذا كان الاعتقاد موافقا لكن من غير دليل، فمنهم من قال: إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب. ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق، وإن لم يكن عن دليل وسماه علما، وعلى هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب النظر. انتهى نقله في فتح الباري.[7]
الخطأ الخامس: دندنته بالمعرفة الفطرية.
الخطأ السادس: قوله: (وإن لازم مذهبهم تكفير العوام بل تكفير الصدر الأول)
أقول: قد قررنا أن العوام كلهم أو جلهم مستدلون عند الأشاعرة استدلالا إجماليا، وهو كاف في الاستدلال عندهم. وقررنا أنه لا خلاف عند الأشاعرة في صحة إيمان المقلد، وإنما الخلاف في تعصيته! وأما الصدر الأول فحاشاهم أن يكونوا غير مستدلين. ولا أدرى كيف تجاسر الدكتور على التكلم بهذا الكلام!!! ثم إن هذا التكفير لو سلمنا أنه لازم لقول أحد فإنما هو لازم لقول أبى هاشم من المعتزلة، وليس بلازم لقول أحد من الأشاعرة مع أنه غير لازم لقول أبى هاشم أيضا، لأنه يقول بعدم صحة إيمان المقلد، وهل العوام كلهم، والصدر الأول كلهم مقلدون في الإيمان!! سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين.
[1] ذيل طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى 2/293.
[2] المعتمد 26.
[3] الرسالة التدمرية 119.
[4] العقائد 11-12.
[5] شرح المقدمات 32-40.
[6] المواقف مع شرحه 1/375-380.
[7] فتح الباري 13/351.