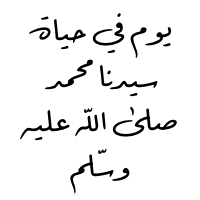التأويل مذهب سلفى وعربي أصيل
التأويل مذهب سلفي وعربي أصيل
قد يظن البعض وذلك بسبب الرهج الذي يثار أمام البصائر والعقول في هذه القضية أن التأويل مذهب مبتدع ومنهج ضلال، لا سيما إذا مثل له بتأويلات المبتدعة من الفرق الباطنية وتعطيلات الجهمية وغيرها من الفرق التي اتخذت التأويل المتكلَّف مركباً وجسراً تعبر منه لهدم الدين ونقض الشريعة، والحق الذي لا يماري فيه منصف عاقل أن التأويل منهج سديد لابد منه لفهم الكتاب والسنة، ومذهب ثابت عن جماعات من السلف كما نقل ذلك علماء الأمة وأئمتها.
قال الإمام الزركشي – رحمه الله تعالى – (البرهان في علوم القرآن 2 / 207):
(وقد اختلف الناس في الوارد منها – يعني المتشابهات – في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق:
أحدها: أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجرى على ظاهرها، ولا نؤول شيئاً منها، وهم المشبهة.
الثانية: أن لها تأويلاً ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه، والتعطيل، ونقول لا يعلمه إلا الله وهو قول السلف.
والثالثة: أنها مؤولة وأولوها على ما يليق به.
والأول باطل – يعني مذهب المشبهة – والأخيران منقولان عن الصحابة) اهـ.
فأثبت رحمه الله تعالى مذهب التأويل للصحابة.
وقال الإمام النووي – رحمه الله – في سياق شرحه لحديث من أحاديث الصفات (شرح مسلم 6 / 36):
(هذا حديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء… أحدهما وهو مذهب السلف… والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها) اهـ.
ومالك والأوزاعي من كبار علماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وقد مر معنا تأويل مالك لنزول الرب وتعليق ابن عبد البر على ذلك.
وقال الإمام أبو محمد الجويني([1]) والد إمام الحرمين رحمهما الله تعالى (إتحاف السادة المتقين 2 / 110):
(أما ما ورد من ظاهر الكتاب والسنة مما يوهم بظاهره تشبيهاً فللسلف فيه طريقان، الإعراض عن الخـوض فيها وتفويض علمها إلى الله تعالى… وإليها ذهب كثير من السلف… والطريقة الثانية: الكلام فيها وفي تفسيرها بأن يردها عن صفات الذات إلى صفات الفعل، فيحمل النزول على قرب الرحمة واليد على النعمة والاستواء على القهر والقدرة، وقد قال ‘ ” كلتا يديه يمين ” ومن تأمل هذا اللفظ انتفى عن قلبه ريبة التشبيه، وقد قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى )وقال ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) فكيف يكون على العرش ساعة كونه سادسهم إلا أن يُردَّ ذلك إلى معنى الإدراك والإحاطة لا إلى معنى المكان والاستقرار والجهة والتحديد) اهـ.
وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى – (إرشاد الفحول 176):
(الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل، وهو قسمان، أحدهما، أغلب الفروع، ولا خلاف في ذلك. والثاني، الأصول كالعقائد وأصول الديانات وصفات الباري عز وجل، وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجرى على ظاهرها ولا يؤوَّل شيء منها، وهذا قول المشبهة.
والثاني: أن لها تأويلاً ولكنا نمسك عنه، مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله ) ، قال ابن برهان وهذا قول السلف…
والمذهب الثالث: أنها مؤولة. قال ابن برهان، والأول من هذه المذاهب باطل، والآخران منقـولان عن الصحابة، ونقل هذا المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة) اهـ.
وهذه أقوال صريحة للعلماء. بإثبات مذهب التأويل للسلف الصالح.
ونحن نقول: لنفترض أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح التصريح بتأويل شيء من ذلك، أي حرج على من سلك سنن العرب في فهم الكلام العربي، وحمل هذه النصوص على ما تجيزه لغتهم، والعرب شائع في لسانهم تسمية الشيء باسم غيره إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب، كتسمية المطر بالنوء، والقوة باليد، وشائع أيضاً عندهم نسبة الفعل إلى غير فاعله، إذا كان برضاه أو بأمره ونحو ذلك، كأن يقال: فعل الأمير كذا، وضرب الأمير فلاناً، والفاعل والضارب حقيقة عامله، وإنما نسب الفعل إليه لأنه أمر به أو رضي به، وعلى الجملة فإن هذا ونظائره كثير دارج على ألسنتهم، ولا سبيل إلى إنكاره وجحده، والقرآن وأحاديث الرسول ‘ جاءا بلسان العرب ولغتهم.
على أن الكلام إذا خلا من المجازات والاستعارات سمج وأصبح فجاً ثقيلاً لا تقبله الأسماع ولا تهضمه.
ونقل الحافظ بن حجر عن الإمام المازري (الفتح 13 / 144) أثناء شرحه لحديث ” إنكم سترون ربكم ” وفيه قوله ‘” وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه “.
قال الحافظ: (قـال المازري كان النبي ‘ يخاطب العرب بما تفهم، ويخرج لهم الأشياء المعنوية إلى الحس ليقرب تناولهم لها، فعبر عن زوال المـانع ورفعه عن الأبصـار بذلك) اهـ.
ثم قال الحافظ ابن حجر (المصدر السابق):
(قال عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراً، وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازها، ومنه قوله تعالى: ( جناح الذل ) فمخاطبة النبي ‘ لهم بـ ” رداء الكبرياء على وجهه ” ونحو ذلك من هذا المعنى، ومن لم يتضح له، وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها، وإما أن يؤولها، كأن يقول: استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانعِ إدراكَ أبصارِ البشرِ مع ضعفها لذلك رداءَ الكبريـاء، فإذا شـاء تقويـة أبصـارهم وقلوبهم كشف عنهم حجـاب هيبته وموانع عظمته) اهـ.
ورجّح الإمـام العزبن عبد السلام – رحمه الله – طريـقة التأويـل فقــال (إتحاف السادة المتقين 2 / 109):
(طريقة التأويل بشرطها أقربها إلى الحق) وعلق الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى على قول العز بقوله (ويعني بشرطها أن يكون على مقتضى لسان العرب) اهـ.
وقال الإمام العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى (روح المعاني 3 / 89) حاثاً على حمل المتشابه على المجاز: (الحمل على المجاز الشائع في كلام العرب والكناية البالغة في الشهرة مبلغ الحقيقة أظهر من الحمل على معنى مجهول) اهـ.
وقال أيضاً (3 / 116): (والتأويل القريب إلى الذهن الشائع نظيره في كلام العرب مما لا بأس به عندي، على أن بعض الآيات مما أجمع على تأويلها السلف والخلف) اهـ.
فأثبت رحمه الله للسلف تأويل بعض الآيات وأنها مما أُجمِع على تأويلها.
وقال الدكتورالشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالـى (كبرى اليقينيات ص/ 138 وما بعدها):
(مذهب السلف هو عدم الخوض في أي تأويل أو تفسير تفصيلي لهذه النصوص، والاكتفاء بإثبات ما أثبته الله تعالى لذاته، مع تنزيهه عزّ وجلّ عن كل نقص ومشابهة للحوادث، وسبيل ذلك التأويل الإجمالي لهذه النصوص وتحويل العلم التفصيلي بالمقصود منها إلى علم الله عزّ وجلّ، أما ترك هذه النصوص على ظاهرها دون أي تأويل لها سواء كان إجمالياً أم تفصيلياً فهو غير جائز، وهو شيء لم يجنح إليه سلف ولا خلف…. ولكنك عندما تنزه الله حيال جميع هذه الآيات عن مشابهة مخلوقه في أن يتحيز في مكان وتكون له أبعاد وأعضاء وصورة وشكل، ثم أثبتَّ لله ما أثبته هو لذاته على نحوٍ يليق بكماله وذلك بأن تكِلَ تفصيل المقصود بكلٍّ من هذه النصوص إلى الله جلّ جلاله سَلِمْتَ بذلك من التناقض في الفهم وسَلَّمْتَ القرآن من توهم أي تناقض فيه، وهذه هي طريقة السلف رحمهم الله ألا تراهم يقولون عنها ” أمروها بلا كيف ” إذ لولا أنهم يؤولونها تأويلاً إجمالياً بالمعنى الذي أوضحنا لما صحّ منهم أن يقولوا ذلك…
ومذهب الخلف الذين جاءوا من بعدهم هو تأويل هذه النصوص بما يضعها على صراط واحد من الوفاق مع النصوص المحكمة الأخرى التي تقطع بتنزّه الله عن الجهة والمكان والجارحة…
واعلم أن مذهب السلف في عصرهم كان هو الأفضل والأسلم والأوفق مع الإيمان الفطري المرتكز في كلٍّ من العقل والقلب.
ومذهب الخلف في عصرهم أصبح هو المصير الذي لا يمكن التحول عنه، بسبب ما قامت فيه من المذاهب الفكرية والمناقشات العلمية…. والمهم أن تعلم بأن كلاًّ من المذهبين منهجان إلى غاية واحدة، لأن المآل فيهما إلى أن الله عزّوجلّ لا يشبهه شيء من مخلوقاته، وأنه منزّه عن جميع صفات النقص، فالخلاف الذي تراه بينهما خلاف لفظي وشكلي فقط) اهـ.
وقال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى (تعريف عام بدين الإسلام ص/81):
(القرآن أنزل بلسان العرب، وخوطب به العرب، وكل ما يفهمه منه العربي الصميم وفق قواعد العربية ومصطلح أهلها – حقيقة حيث ينصرف إلى الحقيقة أو مجازاً حيث يفهم منه المجاز – يكون فهماً صحيحاً، ولكن اللغات كلها إنما وضعت للتعبير عن المعاني الأرضية المادية، فلا تستطيع أن تحيط بالمشاعر الإنسانية فضلاً عن الصفات الإلهية) اهـ.
وهذه حقيقة لا ريب فيها بين العقلاء، إذ الكلام يتعين في الحقيقة والظاهر متى أمكن ذلك، وإلا فبالمجاز مندوحة وسَعة، وبما أن هذه الألفاظ حقائقها مادية حسية إذن من الخطأ بمكان حمل اللفظ عليها، بل يتعين الانصراف إلى المجاز.
فإذا كان الأمر كذلك، فلا ملامة ولا حرج حينئذ على علماء الأمة إذا فسروا كلام الله تعالى وكلام رسوله ‘ العربيين على طريقة العرب وحسب أسلوب تخاطبهم وتحاورهم وبما يليق بجلال الله تعالى، وبما يدفع شبه المشبهين، وهل هم في هذا إلا مـهتدون بهدي جمهور السلف الذين فهموا عن الله تعالى وعن رسوله ‘، لكنهم – كما ذكرنا – لم يتطرقوا – في الغالب – لإعلانه والتصريح به لعدم الحاجة إلى ذلك في عصورهم، ومضى قرنهم على هذا.
وهكذا كان الحـال مع الذين جاءوا من بعدهم، إلى أن جاء زمن نبتت فيه رؤوس البدعة، ورفع فيه أهل الزيغ عقيرتهم، وجابهوا الناس بما لم يكن لهم به عهد، واستولوا بمقالاتهم الفاسدة على عقول العامة، وحملوا كلام الله تعالى وكلام رسوله ‘ على ما لا يجوز حملهما عليه من المعاني، حينها تعين على علماء أهل السنة الذود عن عقائد المسلمين، وغاية ما فعلوه ـ رضي الله تعالى عنهم ـ هو أنهم جهروا بما كان يجتنب جمهور السلف الصالح من الصحابة والتابعين الجهر به، لعدم الحاجة إليه في أزمنتهم.
قال الإمام العز بن عبد السلام (فتاوى العز بن عبد السلام ص / 22) رحمه الله تعالى:
(وليس الكلام في هذا – يعني التأويل – بدعة قبيحة، وإنما الكلام فيه بدعة حسنة واجبة لَمَّا ظهرت الشبهة، وإنما سكت السلف عن الكلام فيه إذ لم يكن في عصرهم من يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما لا يجوز حمله عليه، ولو ظهرت في عصرهم شبهة لكذبوهم وأنكروا عليهم غاية الإنكار، فقد رد الصحابة والسلف على القدرية لما أظهروا بدعتهم، ولم يكونوا قبل ظهورهم يتكلمون في ذلك) اهـ.
وقال الشيخ الإمام القدوة الرباني عدي بن مسافر الشامي – رحمه الله تعالى – (اعتقاد أهل السنة والجماعة ص / 26):
(ونؤمن بما ورد به الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم أن الله عز وجل لا يشبه شـيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها، فإن كل ما تمثل في الوهم فهو مُقدِّرُه قطعاً وخالقُهُ، وهذا الذي درج عليه السلف قبل ظهور الأهواء وتشعب الآراء، فلما ظهرت البدع وانتشر في الناس التشبيه والتعطيل فزع أهل الحق إلى التأويل)’اهـ.
وهذا الذي قاله رضي الله عنه هو عين ما يراه الأشاعرة ويعتقدونه، إذ لولا ظهور الفتن ومقالات أهل الزيغ وتشويشهم على عقائد العامة ما صرحوا وبينوا ما كان السلف يعتقدونه إجمالاً ويمرون عليه مروراً.
وقال العلامة ملا على القاري – رحمه الله تعالى – معتذراً عن علمـاء الأمة لأخذهم بالتأويل (مرقاة المفاتيح 2 / 136): (ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح – معاذ الله أن يظن بهم ذلك – وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك، لكثرة المجسمة والجهمية وغيرها من فرق الضلال، واستيلائهم على عقول العامة، فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم، ومن ثم اعتذر كثير منهم وقالوا: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين في زمنهم لم نخض في تأويل شيء من ذلك) اهـ.
وقال الإمام الزركشي – رحمه الله تعالى – (البرهان في علوم القرآن 2/ 209):
(قلت وإنما حملهم على التأويل وجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته، لقيام الأدلة على استحالة المشابهة والجسمية في حق البارئ تعالى) اهـ.
وقال الحافظ بن حجر – رحمه الله تعالى – (مرقاة المفاتيح 1/134):
(أكثر السلف لعدم ظهور أهل البدع في أزمنتهم يفوضون علمها – آيات الصفات – إلى الله تعالى مع تنزيهه سبحانه عن ظاهرها الذي لا يليق بجلال ذاته، وأكثر الخلف يؤولونها بحملها على محامل تليق بذلك الجلال الأقدس والكمال الأنفس، لاضطرارهم إلى ذلك لكثرة أهل الزيغ والبدع في أزمنتهم) اهـ.
وقال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى (المصدر السابق):
(لو بقي الناس على ما كانوا عليه لم نؤمر بالاشتغال بعلم الكلام، أما الآن فقد كثرت البدع فلا سبيل إلى ترك أمواج الفتن تلتطم) اهـ.
وقال الإمام النووي – رحمه الله تعالى – (المجموع 1 / 25):
(فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأوّلوا حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا) اهـ.
وقال العلامة ملا علي القاري – رحمه الله تعالى – (مرقاة المفاتيح 1/ 189):
(اتـفـق السلف والخلف على تنـزيه الله تعالى عن ظواهر المتشابهات المستحيلة على الله تعالى… وخاض أكثر الخلف في التأويل لكن غير جازمين بأن هذا هو مراد الله تعالى من تلك النصوص، وإنما قصدوا بذلك صرف العامة عن اعتقاد ظواهر المتشابه، والرد على المبتدعة المتمسكين بأكثر تلك الظواهر) اهـ.
وقال العلامة محمود بن خطاب السبكي – رحمه الله تعالى – في كتاب (الدين الخالص 1 / 27) ما نصه:
(أما ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهة فقد أجمع السلف والخلف رضي الله عنهم على أنها مصروفة عن ظاهرها لقوله تعالى ( قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ) وقوله سبحانه ( ليس كمثله شئ وهوالسميع البصير ) ثم اختلفوا في بيان معاني تلك الآيات والأحاديث، فالسلف يفوضون علم معانيها إليه تعالى، فيقولون إن الاستواء في آية ( الرحمن على العرش استوى ) لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مع جزمهم بأنه جل جلاله يستحيل عليه الاستقرار على العرش أو اتصاله به أو جلوسه عليه، لأنه تعالى إله قديم موصوف باستوائه على العرش قبل خلق العرش، لأن القرآن الذي منه هذه الآية موجود قبل إيجاد العرش، فكيف يعقل أنه تعالى استقر على عرش غير موجود؟
ولما خلق الخلق لم يحتج إلى مكان يحل فيه، بل هو غني عنه. فهو تعالى لم يزل بالصفة التي كان عليها.
والخلف يقولون فيها: الاستواء معناه الاقتدار والتصرف أو نحو ذلك. ومذهب السلف أسلم…
ووجه صحة مذهب الخلف أنهم فسروا الآية بما يدل عليه اللفظ العربي، والقرآن عربي، وحملهم على التفسير المذكور ولم يفوضوا كما فوض السلف وجود المشبهة في زمانهم زاعمين – أي المشبهة- أن ظاهر الآيات يدل على أنه تعالى جسم، ولم يفقهوا أنه مستحيل عليه عز وجل الجسمية والحلول في الأمكنة…
فوجب عليهم – يعني الخلف – أن يبينوا للعامة معنى تلك الآيات والأحاديث المتشابهة حسب مدلولات القرآن والأحاديث النبوية بما يصح اتصاف الله تعالى به، ليعرفوا الحق فيعملوا عليه ويتركوا الباطل وأهله فجزاهم الله تعالى خير الجزاء.
وقد نقل العلامة زروق عن أبي حامد أنه قال: (لا خلاف في وجوب التأويل عند تعين شبهة لا ترتفع إلا به).
والحاصل: أن الخلف لم يخالفوا السلف في الاعتقاد وإنما خالفوهم في تفسير المتشابه للمقتضي الذي حدث في زمانهم دون زمان السلف كما علمت، بل اعتقادهم واحد، وهو أن الآيات والأحاديث المتشابهات مصروفة عن ظاهرها الموهم تشبيهه تعالى بشيء من صفات الحوادث وأنه سبحانه وتعالى مخالف للحوادث، فليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا مستقر على عرش ولا في سماء ولا يمر عليه زمان وليس له جهة إلى غير ذلك مما هو من نعوت المخلوقين.) اهـ.
وعلى الجملة، فإن التأويل حق سواء ثبت النقل فيه عن السلف – وهو الحق كما سيأتي – أم لم يثبت، لأنه أسلوب عربي أصيل لفهم الكلام العربي، ويدخل في ضمنه كلام الله تعالى وكلام رسوله ‘، والقائل به لم يأت بدعاً من الأمر، ولكنه اتبع طريق العرب في فهم الكلام.
* * * * *
([1]) هو عبدالله بن يوسف والد إمام الحرمين، أوحد زمانه علماً وديناً وزهداً قال فيه شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: لو كان الشيخ أبو محمد في بني إسرائيل لنُقل إلينا شمائله ولافتخروا به. اهـ توفي رحمه الله تعالى سنة 438هـ. له من المصنفات ” الفروق ” و” السلسلة ” و” التذكرة ” و” التبصرة” وغيرها، أما رسالة الاستواء التي يحاول البعض ترويجها وإلصاقها به فمنسوبة له زوراً، إذ إن آخر كتاب صنَّفه هو الرسالة التي سماها ” عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله وكافة أهل السنة والجماعة ” وأثنى فيها على الإمام أبي الحسن الأشعري ثناء طيباً، كما في تبيين كذب المفتري ص/115، وقبله ص/ 113 إعطاؤه خطَّه راضياً مؤيداً ضمن خطوط جمع من أكابر الأئمة مثل الإمام شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وابنه أبي نصر وغيرهم على مكتوب بخط الإمام أبي القاسم القشيري وفيه (اتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه كان إماماً من أئمة أصحاب الحديث ومذهبه مذهب أصحاب الحديث، تكلَّم في أصول الديانات على طريقة أهل السنة… ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبَّه فقد بسط لسان السوء في جميع أهل السنة) وذلك سنة 436هـ، وتعرَّف على الخط المذكور الحافظ ابن عساكر. وانظره أيضاً في الطبقات الكبرى للتاج السبكي 3/374.
وعدَّه الحافظ ابن عساكر ضمن الطبقة الثالثة من أتباع الإمام الأشعري (انظر التبيين ص/257) وكذلك فعل التاج السبكي في الطبقات الكبرى 3/370، كما أن هذه الرسالة المزعومة لم يذكرها أحد ممن ترجم له على كثرتهم. ولو افترضنا ثبوت نسبتها له رحمه الله لردّ عليه العلماء من معاصريه ومن بعدهم، فقد ردّوا عليه بأقلّ من ذلك، كما فعل الحافظ البيهقي في الرسالة التي أرسلها إليه إثر شروعه في الكتاب الذي سماه المحيط، ونصّ الرسالة موجود في طبقات التاج السبكي 5/77.
وهذا النص الذي نقله عنه الزبيدي هو من رسالة (كفاية المعتقد) لأبي محمد رحمه الله تعالى.