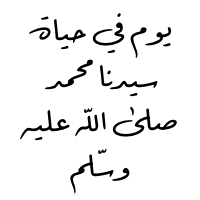التفويض والتأويل / مذهب جمهور السلف التفويض
التفويض والتأويل
التفويض: مأخوذ من قولهم فوض إليه الأمر. أي ردّه إليه.
والمعنى الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي، فهو شرعاً: ردُّ العلم بهذه المتشابهات إلى الله تعالى وعدم الخوض في معناها وذلك بعد تنزيه الله تعالى عن ظواهرها غير المرادة للشارع.
والتأويل: أصله من الأَوْلِ وهو الرجوع.
وهو شرعاً: صرف اللفظ عن الظاهر بقرينة تقتضي ذلك.
وهذان المذهبان كما أسلفنا هما المذهبان المعتبران المأثوران عن أهل السنة والجماعة في أبواب المتشابه، ولا اعتبار لمن جنح إلى التعطيل أو التشبيه من المذاهب الأخرى التي رفضتها الأمة ولفظتها.
· انحصار الحق في التفويض والتأويل:
هذه النصوص المتشابهة في الصفات إما أن تُثبت أو تُنفى، ونفيها تعطيل ظاهر، لأنه نفيٌ لما أثبت الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإثبات إما أن يكون معه حمل الكلام على ظاهره وحقيقته التي يعهدها البشر، أو يصرف الكلام معه عن هذا الظاهر وهذه الحقيقة، والأول نعني حملَ الكلام على الظاهر والحقيقة يفضي قطعاً إلى التشبيه، لأن حقائق وظواهر هذه الألفاظ أجسام وكيفيات مخلوقة، والله تعالى منزه عنها.
ولا يقال: نحملها على الظاهر ونفوض العلم بالكيفية إلى الله تعالى.
لأن هذا القول تناقض صريح أوقعت فيه الغفلة، إذ ليس من ظاهر ولا حقيـقة هنـا إلا الجسم، وهذا لا يصح قطعاً وصف الله تعالى به.
بقي القسم الأخير الذي هو صرف الكلام عن الحقيقة والظاهر، ثم بعد صرفه عن الظاهر إما أن يُتوقفَ عن التماس معنى له ويوكلَ العلمُ به إلى الله تعالى، وهذا هو التفويض الذي عليه جماهير السلف الصالح، أو يلتمسَ له معنى لائقٌ بالله تعالى حسب مناحي الكلام عند العرب وما تسيغه لغتهم، وهذا هو التأويل الذي عليه خلف الأمة وجماعات من سلفها الصالح.
بهذين المذهبين تنحصر القسمة الصحيحة في هذه القضية.
لهذا نرى العلماء ينصّون عندما يعرض لهم شيء من هذه المتشابهات على أنه (إما تفويض وإما تأويل) إذ ليس بعدهما إلا التشبيه أو التعطيل.
قال الإمام الأبّي رحمه الله تعالى (شرح صحيح مسلم للأبي 7 / 190) أثناء شرحه لحديث ” إن الله يمسك السموات على أصبع “:
(والحديث من أحاديث الصفات فيصرف الكلام عن ظاهره المحال الموهم للجارحة، ويكون فيه المذهبان المتقدمان، إما الإمساك عن التأويل والإيمان به على ما يليق، ويصرف علمه إلى الله تعالى، أو يتأول) اهـ.
وقال الإمام العلامة بدر الدين بن جماعة (إيضاح الدليل ص/103):
(واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من ذلك بجلال الرب تعالى غير مراد… واختلفوا في تعيين ما يليق بجلاله من المعاني المحتملة… فسكت السلف عنه، وأوله المتأولون) اهـ.
وقال الإمام ابن الجوزي – رحمه الله تعالى – في حديث النزول (دفع شبه التشبيه 194):
(روى حديث النزول عشرون صحابياً، وقد تقدم أنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والنقلة والتغير، فيبقى الناس رجلين: أحدهما، المتأول بمعنى أنه يقرب برحمته… والثاني، الساكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التنزيه) اهـ.
وقال الإمام النووي – رحمه الله تعالى – في شرحه على صحيح مسلم (5 / 24) أثناء الكلام على حديث الجارية، ما نصه:
(هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان، أحدهما، الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقات، والثاني، تأويله بما يليق)’اهـ.
وقـال أيضـاً أثنـاء الكلام على حديث إمساك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع (17 / 129) ما نصه: (هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فيها المذهبان، التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بها ومع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد) اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر قول ابن دقيق العيد مؤيداً له وموافقاً عليه في حديث ” لا شخص أغير من الله ” (الفتح 13 / 411): (قال ابن دقيق العيد: المنزهون لله إما ساكت عن التأويل، وإما مؤول) اهـ.
وعلى الجملة فإن أقوال العلماء في حصر الحق في هذين المذهبين لا تحصى كثرة، وبما نقلناه من نصوصهم مقنع
* * * * *
مذهب جمهور السلف التفويض
قال الإمام التـرمذي – رحمه الله – (سنن الترمذي 4 / 492) مثبتاً للسلف الصالح مذهب التفويض:
(والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه) اهـ.
وقوله (يؤمن بها) إثبات لها، وبه يفارقون أصحاب التعطيل، وقوله (ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف) تفويض لله تعالى في معانيها، وقوله (ولا يقال كيف) أي بلا استفسار عن معانيها، أو تعيين المراد بها، وبه يفارقون أصحاب التشبيه.
وروى الخلال بسند صحيح عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال في مثل هذه النصوص: (نؤمن بها ونصدق ولا كيف ولا معنى) اهـ.
وروى الإمـام الحـافظ البيهقي رحمه الله تعالى بسنده عن الإمام والأوزاعي ـ رحمه الله (الاعتقاد ص / 93) قال:
(كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه) اهـ.
والنصوص في هذا المعنى عن السلف كثيرة جدّاً كلها يفيد إيمانهم بها وإمرارها وعدم الخوض في تفسير معناها.
ولقد نقـل الحـافظ ابن حجر (الفتح 6 / 48) عن الحافظ ابن الجوزي معنى قولهم: أمـروهـا كمـا جاءت. قال:
(قال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ـ يشير إلى حديث يضحك الله إلى رجلين ـ ويمرونه كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد([1]) منه مع اعتقاد التنزيه)’اهـ.
قال الإمام عدي بن مسافر([2]) رحمه الله تعالى (اعتقاد أهل السنة والجماعة ص / 26):
(وتقرير مذهب السلف كما جاء من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا حمل على الظاهر) اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن المنير (الفتح 13 / 190) قوله:
(لأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال… والثالث إمرارها على ما جاءت مفوضاً معناها إلى الله تعالى، وقال الشيخ السهروردي في كتاب العقيدة له: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح) اهـ.
وقال الإمام النووي – رحمه الله تعالى – (المجموع 1 / 25):
(اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين، وقال آخرون: لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحوادث عنه، فيقال مثلاً: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به، مع أنا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث، وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم) اهـ.
قال الإمام الجلال السيوطي – رحمه الله تعالى – (الإتقان في علوم القرآن 2 / 10):
(من المتشابه آيات الصفات… وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له – تعالى – عن حقيقتها) اهـ.
هذه نصوص صريحة في إثبات التفويض للسلف الصالح لا سبيل إلى إنكارها أو حملها على معاني أخرى لا تتفق وجلالة أقدارهم وتنزيههم للباري سبحانه، كمن ينسب لهم إثبات الحقائق الظاهرة المتعارف عليها بين البشر وتفويض كيفياتها لله تعالى، فيقول إنهم يثبتون المعنى الحقيقي ويفوضـون الكيف، وقائل هذا لا يدري ما يقول، وقد جره إلى هذا الفهم عبـارة (بلا كيف) التي كثيراً ما ترد على ألسنة السلف عند الكلام على النصوص المتشابهة، ففهم منها أنهم يثبتون المعنى الحقيقي ويفوضون الكيف، وهذا فهم باطل، بل هي عبارةٌ المقصودُ منها زجرُ السائل عن البحث والتقصِّي، لا إثبات المعنى الحقيقي وتفويض الكيف!!
فإن أي لفظ يدلُّ في حقيقته على شيء من الجسمانيات والكيفيات متى ما جُهِل معناه كان السؤال عن المراد منه بكلمة (كيف)، وفي حديث فضل عيادة المريض الذي أخرجه مسلم ما يدل على هذا، وذلك حين يقول الله تعالى لعبده (مرضت فلم تعدني.. استطعمتك فلم تطعمني.. استسقيتك فلم تسقني..) كل ذلك والعبد يقول: (رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟!.. رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟!.. رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟!) فهو لم يفهم المعنى المراد من اللفظ بعد أن استحالت حقيقته في عقله، فسأل بـ (كيف؟) عن المعنى المراد، لا أنه أثبت حقيقة المرض والاستطعام والاستسقاء لله تعالى لكنه لم يعلم كيفياتها!!
فعندما يقال في جواب السائل (بلا كيف) يفهم منه أنه (بلا معنى) لأن لفظ الـ (كيف) هنا مستفهم به عن المعنى، وبنفيه ينتـفي المعنى المستفهم عنه به، فهو من قبيل نفي الملزوم عن طريق نفي اللازم، فالكيف لازم للمعنى الظاهر، وبنفيه نفيٌ للمعنى الظاهر، وذلك كمن يقول لك: إن هذا العدد ليس بزوج. فتفهم منه أنه ليس اثنين ولا أربعة ولا ستة… الخ لأن الزوجية لازم غير قابل للانفكاك عن الاثنين والأربعة والستة.. الخ.
من هنا يتبين مراد السلف بقولهم (بلا كيف)، ومنه تعلم أن من ينسب للسلف إثبات المعاني الحقيقية لهذه الألفاظ والتفويض في كيفياتها ينسب لهم التشبيه من حيث لا يدري.
تنبيه
هل كان السلف يدركون أي معنى لهذه النصوص المتشابهة؟ أم أنها بالنسبة لهم كالحروف التي في أوائل السور؟
وإذا كانوا يدركون لها معنى، كيف يُوفَّق بين إدراكهم هذا وبين ما مرَّ من تفسير الإمرار بأنه عدم العلم بالمراد؟
يبدو للوهلة الأولى أن ثمة تعارض بين إدراك معاني هذا النصوص وبين إمرارها الذي هو عدم العلم بالمراد منها، وفي الحقيقة ليس ثمة أي تعارض بين الأمرين، فالمقصود بعدم العلم بالمراد الذي فُسِّر به الإمرار هو عدم العلم بالمراد تفصيلاً وعلى سبيل القطع والتحديد، وهذا لا يقتضي عدم علمهم بالمراد إجمالاً.
مثال على هذا قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) يفهم منه على سبيل الإجمال معنى الكرم والجود المطلق والعطاء الذي لا ينقطع اللائق بصفة الرب تعالى، أما لفظ اليدين المضاف لله تعالى في الآية فبعد استبعاد المعنى الظاهر المتبادر من إطلاقه وهو الحقيقة اللغوية التي وضع اللفظ ليدلَّ عليها بين المخلوقين وهي الجارحة، نقول بعد استبعاد هذه الحقيقة احتمل اللفظ عدة معانٍ مجازية، ولهذا الاحتمال توقف جمهور السلف عن التعيين والقطع بأحدها، وهذا هو معنى عدم علمهم بالمراد لا أنهم لا يفهمون لهذه النصوص أي معنى، تعالى الله أن يخاطب الناس بما لا يُفهم.
هذا هو اللائق بمقامات السلف في العلم، إذ لا يعقل أنهم كانوا يسمعون مثلاً قول الله تعالـى ( يد الله فوق أيديهم ) أو ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) أو ( الرحمن على العرش استوى ) أو ( ثم استوى إلى السماء ) أو ( يوم يكشف عن ساق ) ، أو قول رسول الله ‘ (يضحك ربنا) أو (ينزل ربنا) أو (يعجب ربنا) الخ، ثم لا يفهمون من كل ذلك أي معنى، كما هو الحال مع الحروف التي في فواتح السور، كلا، فإن هذه الألفاظ لها في لغة العرب معانٍ مجازيةٌ معروفةٌ ومشهورةٌ لا شك أن السلف فهموها إجمالاً، ولكنهم لفرط تقواهم وخشيتهم لله تعالى وتهيبهم لذلك المقام الأقدس ثم لعدم الاضطرار إلى التعيين لأحد المعاني لخلو عصرهم من المبطلين الذين يحملون كلام الله تعالى وكلام رسوله ‘ على وجوه فاسدة لا تحتملها لغة العرب وتتنافى مع التقديس والتنزيه، لهذا ولذاك أحجموا عن التعيين والتصريح، واكتفوا بهذا الفهم الإجمالي لها، وصرح بها الخلف بعدهم لطروِّ ما اقتضى ذلك وحتّمه عليهم.
قـال الشيـخ العلامـة العزامـي القضـاعي (فرقان القرآن مطبوع في ذيل الأسماء والصفات للبيهقي ص / 104):
(وقال تعالى: ( الله نور السموات والأرض ) هل فهم أحد من السلف أنه هو ذلك النور الفائض على الحيطان والجدران المنتشر في الجو؟ جل مقام العلماء بالله وكتابه أن يفهموا هذا المعنى الظـاهر العامي. قال حبر الأمة ابن عباس فيما رواه عنه الطبري بالسند الصحيح: الله سبحانه هادي أهل السموات والأرض. وروى نحوه عن أنس بن مالك. وروى عن مجاهد أن معناه المدبر. ورجح الإمامُ الأوّلَ وزيف ما عداه … تعالى الله عن صفات الأجسام وسمات الحدوث. وهكذا لو استقريت أقوال السلف من مظانها لرأيت الكثير الطيب من بيان المعاني اللائقة بالله تعالى على سبيل التعيين، فمن نقل عدم التعيين مطلقاً عن السلف فما دقق البحث ولا اتسع اطلاعه) اهـ.
وقال أيضاً مُوضّحاً هذا المعنى:
(تنبيه مهم: إذا سمعت في عبارات بعض السلف ” إننا نؤمن بأن له – تعالى – وجها لا كالوجوه ويداً لا كالأيدي ” فلا تظن أنهم أرادوا أن ذاته العلية منقسمة إلى أجزاء وأبعاض، فجزءٌ منها يدٌ وجزءٌ منها وجهٌ غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي للخلق!! حاشاهم من ذلك، وما هذا إلا التشبيه بعينه، وإنما أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل في معنى من المعاني، وصفة من الصفات التي تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة، غير أنهم يتورعون عن تعيين تلك الصفة تهيباً من التهجم على ذلك المقام الأقدس) اهـ.
وجاء في كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة – رحمه الله – (1 / 237) ما نصه:
(فهل يتصور أن الذين يبايعون النبي ‘ تحت الشجرة عندما يتلون قوله تعالى ( إنّ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما ) يفهمون أن اليد هنـا يد ليست كيد المخلوقات – يعني يدا حقيقية كما يقول أصحاب الظاهر ولكنها ليست كيد المخلوقات – ولا يفهمون أن المراد سلطان الله تعالى وقدرته، بدليل ما فيها من تهديد لمن ينكث بأن مغبة النكث تعود عليه. ولذلك نحن نرجح منهاج الماتريدي ومنهاج ابن الجوزي ومنهاج الغزالي، ونرى أن الصحابة كانوا يفسرون بالمجاز إن تعذر إطلاق الحقيقة، كما يفسرون بالحقيقة في ذاتها) اهـ.
يؤيد هذا ما نقل عن جماعات منهم من التصريح بذكر هذه المعاني المجازية مثل سيدنا ابن عباس وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم والحسن البصري ومالك والأوزاعي وقتادة والثوري ومجاهد وعكرمة رحمهم الله وغيرهم ممن تزخر بنصوصهم كتب التفسير والحديث وغيرها.
وسيأتي معنا باب خاص في تأويلات السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم.
* * * * *
([1]) سنبين بعد قليل معنى عدم العلم بالمراد، إذ ليس المقصود أنهم لا يفهمون للكلام أي معنى، كلا، وإلا لأصبح الكلام مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، وهذا يجعل كلامه تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بلا فائدة، وهو محال من الله تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام.
([2]) هو أبو محمد عدي بن مسافر الشامي الهكّاري الشيخ الإمام الصالح القدوة زاهد وقته، ساح سنين كثيرة، وصحب المشايخ وجاهد أنواعاً من المجاهدات، ثم سكن بعض جبال الموصل في موضع ليس فيه أنيس، ثم آنس اللهُ تلك المواضع به، وعمرها ببركاته. توفي رحمه الله تعالى سنة سبع وخمسين وخمسمائة.(السير 20/342، وفيات الأعيان 3/254).