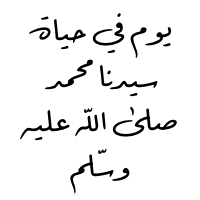المتشابه عند السلف والخلف / مفهوم المتشابه
المتشابه عند السلف والخلف
يصرّ البعض على تضليل الأشاعرة والماتريدية لأن جمهورهم أجاز التأويل بشروطه في نصوص المتشابه التي تتعلق بصفات الله تعالى، وينسى هؤلاء أن جُلَّ الأمة على مذهب التأويل وأن جماعات من السلف قالوا به.
قال الإمام الزركشي – رحمه الله تعالى – مبيناً المذاهب في المتشابه (البرهان في علوم القرآن 2 / 207):
(… والثالث أنها مؤولة، وأولـوها على ما يليق به، والأول – يعني مذهب الأخذ بالظاهر – باطل، والأخيران منقولان عن الصحابة… وممن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم) اهـ.
وقال الإمام النووي – رحمه الله تعالى – عن مذهب التأويل:
(مذهـب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي عن مالك والأوزاعي) اهـ. (شرح صحيح مسلم 6 / 36).
* * * * *
مفهوم المتشابه
قال تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هـن أم الكتاب وأخر متشابهات)
المتشابه في الأصل كل ما لا يهتدي إليه الإنسان، والمراد به هنا ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة المشهورة من النصوص التي يوهم ظاهرها مشابهة الله تعالى لخلقه.
قال الراغب الأصفهاني – رحمه الله تعالى – (مفردات القرآن مادة ” شبه “):
(والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف يوم القيامة، فإن تلك الصفات لا تتصور لنـا، إذ كـان لا يحصل في نفوسـنا صورة مـا لا نحسه، أو لم يكن من جنس ما نحسه) اهـ.
ومثـال المتشابه من القرآن قوله تعالى: ( الرحمن على العرش استوى) وقوله عز وجل: ( يد الله فوق أيديهم ) وقوله سبحانه: ( فإنك بأعيننا ) ، ( ولتصنع على عينى ) ، ( لما خلقت بيدىّ ) ومثـاله من السنة قوله ‘: (ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل…) وقوله ‘: (ضحك الله الليلة من فعالكما) (إن الله خلق آدم على صورته) ونحو ذلك مما يوهم ظاهره مشابهة الله تعالى لخلقه.
وحكم المتشابه من هذه النصوص هو الإيمان به على الوجه الذي أراد الله تعالى، والقطع بأن له معنىً عظيماً شريفاً عند الله تعالى، بعد أن ننزه الله تعالى عن الظاهر المستحيل في حقه سبحانه.
هذا هو القدر المشترك بين العلماء في حكمهم على المتشابه، ثم اختلفوا في ما وراء ذلك، ومنشأ الاختلاف جاء من فهمهم لآية المتشابهات واختلافهم في محل الوقوف في قوله تعالى: ( وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون فى العلم ) قال جمهـور السلف إن الوقـوف في الآيـة على لفـظ الجلالـة لازم، وعليه، قوله تعـالى ( والراسخون ) الواو فيه استئنافية والجملة بعده مستأنفة، وبناء على ذلك يكون المعنى أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى، ويفوّض العلم بتأويله إليه سبحانه إذ هو تعالى أعلم بمراده، ولا نشتغل بتأويل شيء من ذلك، هذا بعد قطعهم بأن الظاهر المستحيل في حق الله تعالى غير مراد له سبحانه ولا لرسوله ‘.
أما الخلف فقالوا إن الواو في قوله تعالى ( والراسخون ) عاطفة وما بعدها معطوف على لفظ الجلالة، وعليه يكون معنى الآية، أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه.
وعلى أية حال فإن كلاّ ًمن الفريقين لا يضلل الآخر، كيف وقد نُقِلَ كلٌّ من المذهبين عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
ولقد أجمل حجة الإسلام الغزالي – رحمه الله تعالى – ما يجب على المسلم عند سماعه لهذه النصوص بقوله (إلجام العوام عن علم الكلام ص/4 من الطبعة الأزهرية للتراث سنة 1418هـ):
(اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف، أعني مذهب الصحابة والتابعين. وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه، فأقول:
حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه سبعة أمور، التقديس ثم التصديق ثم الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم الإمساك ثم الكف ثم التسليم لأهل المعرفة.
أما التقديس: فأعني به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها.
وأما التصديق: فهو الإيمان بما قاله ‘، وأن ما ذكره حق وهو فيما قاله صادق، وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراده.
وأما الاعتراف بالعجز: فهو أن يقر بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته، وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته.
وأما السكوت: فأن لا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه، ويعلم أن سؤاله عنه بدعة، وأنه في خوضه فيه مخاطر بدينه، وأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه من حيث لا يشعر.
وأما الإمساك: فأن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى، والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق، بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة.
وأما الكف: فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه.
وأما التسليم لأهلـه: فأن لا يعتقد أن ذلـك إن خفي عليـه لعجـزه فقد خفي على رسول الله ‘ أو على الأنبياء أو على الصديقين والأولياء.
فهذه سبع وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على كل العوام، لا ينبغي أن يظن بالسلف الخلاف في شي منها) اهـ.
وقال الشيخ العلامة محمود خطاب السبكي – رحمه الله تعالى – (إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات ص/ 167):
(المراد به – يعني المتشابه – هنا كل ما ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة موهماً مماثلته تعالى للحوادث في شيء ما،وقامت الدلائل القاطعة على امتناع ظاهره في حق الله تعالى، ولذا أجمع السلف والخلف على تأويله تأويلاً إجمالياً بصرف اللفظ عن ظاهره المحال على الله تعالى، لقيام الأدلة القاطعة على أنه تعالى ليس كمثله شيء، ثم إن السلف لا يعينون المعنى المراد من ذلك النص بل يفوضون علمه إلى الله تعـالى بناء على أن الوقف على قوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله ) والخلف يؤولونه تأويلاً تفصيلياً بتعيين المعنى المراد منه لاضطرارهم إلى ذلك ردّاً على المبتدعين الذين كثروا في زمانهم، بناء على أن الوقف على قوله تعالى ( والراسخون فى العلم ) اهـ.
وقال الشيخ علي الطنطاوي – رحمه الله تعالى – (تعريف عام بدين الإسلام ص/84):
(بيّن الله في القرآن أن فيه آيات محكمات واضحة المعنى، صريحة اللفظ، وآيات وردت متشابهات، ولا يَضِحُ ـ الفعل المضارع من (وضح) ـ المعنى المراد منها تماماً، وإن على المؤمن ألا يطيل الغوص في معناها، ولا يتتبعها فيجمعها ليفتن الناس بالبحث فيها، ومن المتشابه آيات الصفات)
وعلّق – رحمه الله – على هذا في الهامش قائلاً: (ومن جمعها كلها وألقاها إلى التلاميذ فقد جانب طريقة السلف، لا سيما إذا ضمّ إليها أحاديث الآحاد المروية في مثلها، والتي لا تعتبر دليلاً قطعياً في أمور العقائد) اهـ.
ثم بين – رحمه الله تعالى – موقف المسلمين منها فقال:
(المسلمون الأولون وهم سلف هذه الأمة وخيرها وأفضلها لم يتكلموا فيها، ولم يخوضوا في شرحها، بل آمنوا بها كما جاءت من عند الله على مراد الله، فلما انتشر علم الكلام، وأوردت الشبه على عقائد الإسلام، وظهرت طبقة جديدة من العلماء انبرت لِرَدِّ هذه الشبه، تكلم هؤلاء العلماء في آيات الصفات، وفهموها على طريقة العرب في مجاوزة المعنى الأصلي للكلمة إذا لم يمكن فهمها به إلى معنى آخر، وهذا ما يسمى المجاز أو التأويل، وقيل في هذا: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أحكم، وكلهم متفقون على أن هذه الآيات نزلت من عند الله، من أنكر شيئاً منها كفر، وأن من عطلها تماماً فجعلها لفظاً بلا معنى كفر، ومن فهمها بالمعنى البشري وطبقه على الله فجعل الخالق كالمخلوق كفر، والمسلك خطر، والمفازة مهلكة، والنجاة منها باجتناب الخوض فيها) اهـ.
ولقد أجاد رحمه الله تعالى وأحسن، فالمسلك خطر جدّاً، والنجاة باجتناب الخوض جملة، وليس من الحكمة في شيء إلقاء مثل هذه النصوص على العامة وتعريضهم بهـذا الصنيع للفتنة، وقد تواردت الأخبار في النهي عن ذلك، منها ما خرّجه مسلم في مقدمة الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: (ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)، وعند البخاري في ” كتاب العلـم ” باب (من خصَّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا) عـن عليّ موقوفــاً (حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله؟).
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – (الفتح 1/272) في شرحه للحديث:
(فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة… وضابط ذلك أن يكون الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يُخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب) اهـ.
ولقد نهى الإمام مالك أن يُحَدَّث بما قد يلتبس على الناس كما نقل عنه الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى (النوادر والزيادات 14/ 553) (ولا ينبغي لأحد أن يصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، ولا يشبهه كذلك بشيء، وليقل: له – تعالى – يدان كما وصف به نفسه، وله وجه كما وصف به نفسه. تقف عند ما في الكتاب، لأن الله سبحانه لا مثل له ولا شبيه له ولا نظير له، ولا يروي أحدٌ مثلَ هذه الأحاديث، مثلُ ” إن الله خلق آدم على صورته ” ونحوُ ذلك مـن الأحاديث. وأعظمَ مالكٌ أن يتحدث أحدٌ بمثل هذه الأحاديث أو يُردِّدَها).
(وانظر أيضاً في هذا البيان والتحصيل 18/504، والسيـر 8/104، الموافـقات 4/549، فتح الباري 1/272).
هذه نصوص واضحة في النهي عن التحديث بالمتشابهات، منها تعلم مجازفة من يخوض في هذه النصوص، ويلقيها على الناس على أنها مما لا يجوز الجهل به، بل ويزيد على هذا بحملها على ما يعهده الناس من هذه الظواهر، ويضلل من يصرفها عن ظاهرها المحال، الذي هو قطعاً ليس مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما فهمه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من خطابه الشريف!!
* * * * *
قال الأستاذ الدكتور الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله تعالى (كبرى اليقينيات الكونية ص/137) موضحاً شأن هذه المتشابهات:
(يُشْـكِل ـ بحسب الظاهر ـ آيات في كتاب الله، وأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفيد بظاهر ألفاظها وتعابيرها ثبوت بعض النقائص أو النقائض التي نفيناها عن ذات الله جلّ جلاله، كالجهة والجسمية والجوارح والأعضاء والتحيز في المكان. كقوله سبحانه وتعالى ( وجاء ربك والملك صفّا صفّا ) ، وقوله ( يد الله فوق أيديهم ) ، وقولـه ( .. بل يداه مبسوطتان كيف يشاء ) وقوله ( الرحمن على العرش استوى ) وكقوله عليه الصلاة والسلام ” إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن “، وقوله ” إن الله خلق آدم على صورته “.
إن هذه النصوص القرآنية من نوع المتشابه الذي ذكر الله عزّ وجلّ أن في كتابه آيات منه، والمقصود بالمتشابه كل نصّ تجاذبته الاحتمالات حول المعنى المراد منه، وأوهم بظاهره ما قامت الأدلة على نفيه.
غير أن هنالك آيات تتعلق بصفات الله تعالى أيضاً، ولكنها محكمات أي قاطعة في دلالتها لا تحتمل إلا معناها الواضح الصريح، كقوله جلّ جلاله ( ليس كمثله شئ ) ، وقوله ( قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ) وقد أوضح الله في كتابه بصريح العبارة ضرورة اتباع المؤمن للنصوص المحكمة في كتابه، وبناء عقيدته في الله بموجبها، ووضع النصوص المتشابهة من ورائها من حيث فهمها والوقوف على المعنى المراد منها…) ثم قال:
(وبناء على ذلك فقد اتفق المسلمون كلهم على تنزيه الله تعالى عمّا يقتضيه ظاهر تلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية من الصفات المنافية لكمال الله وألوهيته… وبعد أن اتفقوا على ذلك ـ وهذا القدر الذي يجب أن يعتقده المسلم ـ اختلفوا في موقفهم من النصوص المتشابهة إلى مذهبين: أولهما تمسك به السلف المتقدمون، وثانيهما جنح إليه مَن بعدهم مِنَ المتأخرين) اهـ.
وعلى الجملة، فإنه لم يؤثر عن علماء الأمة في المتشابه إلا هذان المذهبان المعتبران فقط، مذهب التفويض، وهو مذهب أكثر السلف، ومذهب التأويل، وهو مذهب الخلف وجماعات من السلف، ولا عبرة بمن قال بالأخذ بظاهر نصوص المتشابه، لمناقضته للمنقول وبداهة العقول.
قال الإمـام النووي – رحمه الله تعالى – أثنـاء شرحـه لحديـث مـن أحاديـث الصفـات (شرح مسلم 6 / 36):
(هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، ومختصرهما أن أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين، أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق، والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها) اهـ.
فاقتصر رحمه الله تعالى على ذكر هذين المذهبين، ونص على أن مذهب التأويل منقول أيضاً عن السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهذا ليعلم من ينحى على الأشاعرة والماتريدية باللوائم ويصفهم بالابتداع لكونهم سوّغوا مسلك التأويل بشروطه أنه على السلف يعيب وإياهم ينتقص.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مثل هـذه النصـوص (فتح الباري 13 / 466): (إما تفويض وإما تأويل) اهـ.
وقال أيضاً أثناء رده على أبي إسماعيل الهروي حين اعترض على من أوّل أحاديث النزول، وذكر – أي الهروي – عدة أحاديث في الصعود زاعماً أنها لا تقبل التأويل، فردّ عليه الحافظ بعد أن وصفه بالمبالغة في الإثبات ونقـل طعـن البعض عليه بسبب ذلك، قال الحافظ (الفتح 13 / 476): (فهذه الطرق كلها ضعيفة، وعلى تقدير ثبوتها لا يقبل قوله ” إنها لا تقبل التأويل ” فإن مُحصِّلها ذكرُ الصعود بعد النزول، فكما قَبِلَ النزولُ التأويلَ لا يُمنع قبولُ الصعودِ التأويلَ، والتسليم أسلم) اهـ.
فانظر إلى قوله رحمه الله (والتسليم أسلم) يتبين لك كونهم – رحمهم الله تعالى – ما طرقوا سبيل التأويل إلا مضطرين ملجئين، ولولا ذلك لوقفوا حيث وقف السلف رضوان الله على الجميع.
وقال الإمام الكرماني – رحمه الله تعالى – في حديث من أحاديث الصفات (الفتح 13 / 13):
(حكم هذا حكم سائر المتشابهات، إما التفويض وإما التأويل)’اهـ.
وقال أيضاً عن حديث آخر (13 / 441):
(هذا الحديث من المتشابهات فإما مفوض وإما مؤول) اهـ.
وقـال الإمـام بدر الديـن بـن جمـاعة عنـد قولـه تعـالى (ثم استوى على العــرش) (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة، طبع دار السلام القاهرة ص/103):
(… واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من ذلك بجلال الرب تعالى غير مراد، كالقعود والاعتدال… فسكت السلف عنه – يعني تعيين المراد – وأوله المتأولون) اهـ.
وقـال الإمـام أبو عبد الله الأبي في شرحه على صحيح مسلم عند كلامه على حديث النزول (2 / 385):
(… ومذهب أهل الحق في جميع ذلك أن يصرف اللفظ عن ظاهره المحال، ثم بعد الصرف هل الأولى التأويل أو عدمه، بأن يؤمن باللفظ على ما يليق، ويكل علم حقيقة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى… ثم الأظهر من قول أهل الحق التأويل) اهـ.
وقال الإمام العلامة ملا علي القاري – رحمه الله تعالى – بعد أن نقل قول الإمام النووي المارّ معنا قريباً (مرقاة المفاتيح 2 / 136):
(وبكلامه وبكلام الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من أئمتنا وغيرهم يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر كالمجيء والصورة والشخص والرجل والقدم واليد والوجه والغضب والرحمة والاستواء على العرش والكون في السماء وغير ذلك عما يفهمه ظاهرها، لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان تستلزم أشياء يحكم بكفرها بالإجماع، فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره.
وإنما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نؤوله بشيء آخر، وهو مذهب أكثر أهل السلف وفيه تأويل إجمالي، أو مع تأويله بشيء آخر وهو مذهب أكثر أهل الخلف، وهو تأويل تفصيلي، ولم يريدوا بذلك مخـالفة السلف الصالح – معاذ الله أن يظن بهم ذلك – وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك، لكثرة المجسمة والجهمية وغيرها من فرق الضلال، واستيلائهم على عقول العامة، فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم، ومن ثم اعتذر كثير منهم وقالوا: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين في زمنهم لم نخض في تأويل شيء من ذلك) اهـ.
وقال الإمام الزركشي – رحمه الله تعالى – (البرهان في علوم القرآن 2/ 207):
(اختلف الناس في الوارد منها – يريد المتشابهات – في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق:
أحدها: لا مدخل للتأويـل فيها، بل تجرى على ظاهرها، ولا نؤول شيئاً منها، وهم المشبهة.
والثاني: أن لها تأويلاً ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل ونقول لا يعلمه إلا الله، وهو قول السلف.
والثالث: أنها مؤولة، وأولوها على ما يليق به. والأول باطل، والأخيران منقولان عن الصحابة… وممن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم) اهـ.
وقال العلامة محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث النزول من الموطأ (أوجز المسالك 4/334): (فالعلماء في ذلك على قسمين: الأول المفوّضة… والقسم الثاني: المؤوّلة) اهـ.
بهذا يكون الصبح قد استبان لذي عينين، وثبت أن التفويض والتأويل هما المذهبان الصحيحان في المتشابه من نصوص الصفات. بقي أن نبين سبب ورود مثل هذه الألفاظ في الكتاب والسنة مع كونها مثاراختلاف ومزلة قدم، فنقول: لا يبعد أن يكون ورود مثل هذه الألفاظ اختباراً وابتلاءً للناس، ليتبين من يلتزم الحد ويقف حيث أُمِر، ومن يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وتضليل الخلق، قال تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتِّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون كلٌّ من عند ربنا ، وما يتذكر إلا أولوا الألباب )
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى (إلجام العوام ص/49):
(إن قال قائل ما الذي دعا رسول الله ‘ إلى إطلاق هذه الألفاظ الموهمة مع الاستغناء عنها، أكان لا يدري أنه يوهم التشبيه ويغلّط الخلق ويسوقهم إلى اعتقاد الباطل في ذات الله تعالى وصفاته، وحاشا منصب النبوة أن يخفى عليه ذلك، أو عرف ولكن لم يبالِ بجهل الجهال وضلالة الضلاّل، وهذا أبعد وأشنع لأنه بُـعِـَث شـارحاً لا مـبهماً ملـبّساً ملغزاً، وهذا إشكال له وقع في القلوب حتى جرّ بعض الخلق إلى سوء الاعتقاد فيه، فقالوا: لو كان نبِيّاً لعرف الله ولو عرفه لما وصفه بما يستحيل عليه في ذاته وصفاته، ومالت طائفة أخرى إلى اعتقاد الظواهر، وقالوا لو لم يكن حقاً – أي هذه الظواهر المُحالة – لما ذكره كذلك مطلقاً، ولعدل عنها إلى غيرها أو قرنها بما يزيل الإيهام عنها في سبيل حلّ هذا الإشكال العظيم.
فالجواب: أن هذا الإشكال مُنْحَلٌّ عند أهل البصيرة، وبيانه أن هذه الكلمات ما جمعها رسول الله دفعةً واحدة وما ذكرها، وإنما جمعها المشبهة، وقد بيّنا أن لجمعها من التأثير في الإيهام والتلبيس على الأفهام ما ليس لآحادها المفرّقة، وإنما هي كلمات لهج بها في جميع عمره ‘ في أوقات متباعدة، وإذا اقتصر منها على ما في القرآن والأخبار المتواترة رجعت إلى كلمات يسيرة معدودة، وإن أضيفت إليها الأخبار الصحيحة فهي أيضاً قليلة، وإنما كثرت الروايات الشاذة الضعيفة التي لايجوز التعويل عليها، ثم ما تواتر منها إن صح نقلها عن العدول فهي آحاد كلمات وما ذكر‘ كلمة منها إلا مع قرائن وإشارات يزول معها إيهام التشيبه، وقد أدركها الحاضرون المشاهدون، فإذا نُقلت الألفاظ مجردة عن تلك القرائن ظهر الإيهام، وأعظم القرائن في زوال الإيهام المعرفة السابقة بتقديس الله تعالى عن قبول هذه الظواهر، ومن سبقت معرفته بذلك كانت تلك المعرفة ذخيرة له راسخة في نفسه مقارنة لكل ما يسمع، فينمحق معه الإيهام انمحاقاً لا يشك فيه، ويعرف هذا بأمثلة:
الأول: أنه ‘ سمى الكعبة بيت الله تعالى، وإطلاق هذا يوهم عند الصبيان وعند من تقرب درجتهم منهم أن الكعبة وطنه ومثواه لكن العوام الذين اعتقدوا أنه في السماء وأن استقراره على العرش ينمحق في حقهم هذا الإيهام على وجه لايشكون فيه، فلو قيل لهم: ما الذي دعا رسول الله ‘ إلى إطلاق هذا اللفظ الموهم المخيل إلى السامع أن الكعبة مسكنه؟ لبادروا بأجمعهم وقالوا: هذا إنما يوهم في حق الصبيان والحمقى أما من تكرر على سمعه أن الله مستقر على عرشه فلا يشك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس المراد به أن البيت مسكنه ومأواه، بل يعلم على البديهة أن المراد بهذه الإضافة تشريف البيت أو معنىً سواه غير ما وُضع له لفظ البيت المضاف إلى ربه وساكنه. أليس كان اعتقاده أنه على العرش قرينة أفادته علماً قطعياً بأنه ما أريد بكون الكعبة بيته أنه مأواه، وأن هذا إنما يوهم في حق من لا يسبق إلى هذه العقيدة، فكذلك رسول الله ‘ خاطب بهذه الألفاظ جماعة سبقوا إلى علم التقديس ونفي التشبيه وأنه منزّه عن الجسمية وعوارضها، وكان ذلك قرينة قطعية مزيلة للإيهام لا يبقى معه شك، وإن جاز أن يبقى لبعضهم تردد في تأويله وتعيين المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ ويليق بجلال الله تعالى) اهـ.
ثم أخذ الإمام الغزالي رحمه الله يزيل كل توهم في هذه القضية ببيانه المحكم وعبارته الفصيحة، فليراجع فهو غاية في الأهمية.
وبهذا يعلم أن من قال بظواهر هذه النصوص قد خالف السلف والخلف، وأتى بقول مبتدع ليس له نصيب من الحق، إذ ليس في هذه المسألة إلا التفويض أو التأويل، كما يعلم أيضـاً بأن التأويل ليس بدعة في الدين كما يروجه البعض – جهلاً – على العامة، بل هو مذهب حق ثابت عن سلف الأمة، وجارٍ على سنن لغة العرب.
فلماذا كل هذا التهويل في أمر لا يستلزم ذلك، لا سيما والحق فيه مـع الأشاعـرة والماتريدية؟!
ولماذا كل هذا الإصرار على تفريق الأمة والفتِّ في عضدها وخَضْدِ شوكتِها؟! وكأن الأمة لا يكفيها ما تئنُّ تحت وطأته من مصائب وإحن؟!!
* * * * *