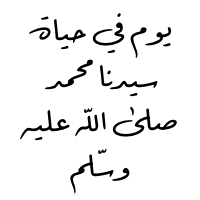نماذج من تأويل علماء الأمة وأئمتها لنصوص الصفات
نماذج من تأويل علماء الأئمة وأئمتها لنصوص الصفات
قال الإمام الخطابي – رحمه الله تعالى – عند شرحه قول النبي ‘ “وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب ” (معالم السنن 4 / 328):
(هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية، والكيفية عن الله وصفاته منفية، فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة، ولا تحديده على هذه الهيئة، وإنما هو كلام تقريب أريد به عظمة الله وجلاله سبحانه، وإنما قصد به إفهام السائل من حيث يدركه فهمه إذ كان أعرابياً جلفاً لا علم له بمعاني ما دق من الكلام وبما لطف منه عن درك الإفهام، وفي الكلام حذف وإضمار، فمعنى قوله ” أتدري ما الله ” معناه أتدري ما عظمة الله وجلاله، وقوله ” إنه ليئط به ” معناه إنه ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به، إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله، فقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدر وفخامة الذكر لا يجعل شفيعاً إلى من هو دونه في القدر وأسفل منه في الدرجة، وتعالى الله أن يكون مشبهاً بشيء أو مكيفا بصورة خلق أو مدركاً بحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) اهـ.
وأوّل محيي السنة الإمام البغوي حبَّ الله تعالى للمؤمنين بثنائه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم (تفسير البغوي 1 / 293).
وتفسيره زاخر بما تقرّ به أعين المنزّهين لله تعالى.
وقال الإمام أبو نصرالقشيري رحمه الله تعالى (إتحاف السادة المتقين 2/ 110):
(كيف يسوغ لقائل أن يقول: في كتاب الله تعالى ما ليس لمخلوق سبيل إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله، أليس هذا من أعظم القدح في النبوات؟! وأن النبي ‘ ما عرف تأويل ما ورد في صفـات الله تعالى، ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم، أليس الله يقول ( بلسان عربي مبين ) فإذاً – على زعمهم – يجب أن يقولوا كذب حيث قال ( بلسان عربي مبين ) إذ لم يكن معلوماً عندهم، وإلا فأين هذا البيان، وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعى بأنه مما لا تعلمه العرب؟ ولو كان كذلك لما كان ذلك الشيء عربياً… ونسبة النبي ‘ إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل، أمر عظيم لا يتخيله مسلم، فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف. والغرض: أن يستبين من معه مسكة من العقل أن قول من يقول: استواؤه صفة ذاتية لا يعقل معناه، واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها، والقدم صفة ذاتيـة لا يعقل معناه، تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى الجهل، وقد وضح الحق لذي عينين. وليت شعري، هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الإنكار في كل شيء وفي كل آية، أم يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى؟ فإن امتنع من التأويل أصلاً فقد أبطل الشريعة والعلوم، إذ ما من آية وخبر إلا ويحتاج إلى تأويل وتصرفٍ في الكلام، لأن ثَمّ أشياء لابد من تأويلها لا خلاف بين العقلاء فيه إلا الملحدة الذين قصدهم التعطيل للشرائع، والاعتقاد لهذا يؤدي إلى إبطال ما هو عليه من التمسك بالشرع.
وإن قال: يجوز التأويل على الجملة إلا فيما يتعلق بالله وصفاته فلا تأويل فيه. فهذا يصير منه إلى أن ما يتعلق بغير الله تعالى يجب أن يعلم، وما يتعلق بالصانع وصفاته يجب التقاصي عنه، وهذا لا يرضى به مسلم. وسر الأمر أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه غير أنهم يدلسون ويقولون: له يد لا كالأيدي وقدم لا كالأقدام، واستواء بالذات لا كما نعقل فيما بيننا، فليقل المحقق: هذا كلام لابد فيه من استبيان، قولكم: نُجري الأمر على الظاهر ولا يعقل معناه تناقض، إن أجريت على الظاهر فظاهر السياق في قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ) هو العضو المشتمل على الجلد واللحم والعظم والعصب والمخ، فإن أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاء فهو الكفر، وإن لم يمكنك الأخذ بها فأين الأخذ بالظاهر؟ ألست قد تركت الظاهر وعلمت تقدس الرب تعالى عما يوهم الظاهر فكيف يكون أخذاً بالظاهر؟! وإن قال الخصم: هذه الظواهر لا معنى لها أصلاً. فهو حكم بأنها ملغاة وما كان في إبلاغها إلينا فائدة وهي هدر، وهذا محال. وفي لغة العرب ما شئت من التجوز والتوسع في الخطاب وكانوا يعرفون موارد الكلام ويفهمون المقاصد، فمن تجافى عن التأويل فذلك لقلة فهمه بالعربية، ومن أحاط بطرف من العربية هان عليه مدرك الحقائق، وقد قيل ( وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم ) فكأنه قال والراسخون في العلم أيضاً يعلمونه ويقولون آمنا به فإن الإيمان بالشيء إنما يتصور بعد العلم، أما ما لا يعلم فالإيمان به غير متأت، ولهذا قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم) انـتـهى قول الإمام القشيري رحمه الله.
ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد مؤيداً له في شرحـه لحديث ” لا شخص أغير من الله ” (الفتح 13 / 411) قال:
(قال ابن دقيق العيد: المنزهون لله إما ساكت عن التأويل، وإما مؤول، والثاني – يعني المؤول – يقول المراد بالغيرة المنع من الشيء والحماية، وهما من لوازم الغيرة، فأطلقت على سبيل المجاز، كالملازمة وغيرها من الأوجه الشائعة في لسان العرب) اهـ.
وقال الإمام النووي – رحمه الله – (شرح مسلم 5 / 24) في شرح حديث إمساك السموات على أصبع والأرضين على أصبع ” ما نصه:
(هذا من أحاديث الصفات وقد سبق فيها المذهبان التأويل والإمساك…) ثم قال بعد صفحات (وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة، وكنى عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين، فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح وأوكد في النفوس، ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمعية المسماة باليد التي ليست بجارحة، والله تعالى أعلم بمراد نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما ورد في هذه الأحاديث من مشكل ونحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولا نشبه شيئاً به ولا نشبهه بشيء) اهـ.
وقال الإمام اللغوي النحوي ابن السيد البطليوسي – رحمه الله تعالى – بعد أن ذكر حديث النزول في سياق إثباته للمجاز (الإنصاف ص/ 82):
(جعلته المجسمة نزولا على الحقيقة، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وقد أجمع العارفون بالله عز وجل على أنه لا ينتقل لأن الانتقال من صفات المحدثات، ولهذا الحديث تأويلان صحيحان لا يقتضيان شيئاً من التشبيه:
أحدهما أشار إليه مالك رحمه الله وقد سئل عن هذا الحديث فقال: ينزل أمره كل سحر، فأما هو عز وجل فإنه دائم لا يزول ولا ينتقل سبحانه لا إله إلا هو.
وسئل الأوزاعي فقال: يفعل الله ما يشاء([1]).
وهذا تلويح يحتاج إلى تصريح، وخفي إشارة يحتاج إلى تبيين عبارة)
ثم أخذ رحمه الله ببيان حقيقة ما قالاه على أساليب العرب واستعاراتها، وذكر أن العرب تنسب الفعل إلى من أمر به كما تنسبه إلى من فعله وباشره ومعنى النزول في الحديث أن الله تعالى يأمر ملكاً بالنزول إلى السماء الدنيا فينادي بأمره، ثم قال رحمه الله: (فهذا تأويل كما تراه صحيح جار على فصيح كلام العرب في محاوراتها والمتعارف من أساليبها ومخاطباتها، وهو شرح ما أراده مالك والأوزاعي رحمهما الله) اهـ.
قال الإمام أبو بكر بن العربي – رحمه الله – (القبس شرح الموطأ 1 / 288 – 289):
(وأما الأوزاعي – وهو إمام عظيم – فنزع بالتأويل حين قال وقد سئل عن قول النبي ‘ “ينزل ربنا ” فقال: يفعل الله ما يشاء. ففتح باباً من المعرفة عظيما ونهج إلى التأويل صراطا مستقيما).
ثم قال رحمه الله تعالى:
(إن الله سبحانه منزه عن الحركة والانتقال لأنه لا يحويه مكان كما لا يشتمل عليه زمان، ولا يشغل حيزاً كما لا يدنو إلى شيء بمسافة ولا يغيب بعلمه عن شيء، متقدس الذات عن الآفات منزه عن التغير والاستحالات، إله في الأرض إله في السماوات. وهذه عقيدة مستقرة في القلوب ثابتة بواضح الدليل) اهـ.
وقال أيضاً في شرحه على سنن الترمذي (2 /234):
(اختلف الناس في هذا الحديث وأمثاله على ثلاثة أقوال فمنهم من ردّه لأنه خبر واحد ورد بما لا يجوز ظاهره على الله وهم المبتدعة، ومنهم من قبله وأمرّه كما جاء ولم يتأوله ولا تكلم فيه مع اعتقاده أن الله ليس كمثله شيء، ومنهم من تأوله وفسره. وبه أقول، لأنه معنى قريب عربي فصيح.
أما إنه قد تعدى إليه قوم ليسوا من أهل العلم بالتفسير فتعدوا عليه بالقول بالتكثير، قالوا: في هذا الحديث دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات.
قلنا:هذا جهل عظيم وإنما قال ” ينزل إلى السماء ” ولم يقل في هذا الحديث من أين ينزل ولا كيف ينزل.
قالوا – وحجتهم ظاهره – : قال الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) .
قلنا: وما العرش في العربية؟ وما الاستواء؟…) إلى أن قال رحمه الله تعالى:
(والذي يجب أن يعتقد في ذلك أن الله كان ولا شيء معه ثم خلق المخلوقات من العرش إلى الفرش فلم يتغير بها ولا حدث له جهة منها ولا كان له مكان فيها فإنه لا يحول ولا يزول قدوس لا يتغير ولا يستحيل، وللاستواء في كلام العرب خمسة عشر معنى ما بين حقيقة ومجاز، منها ما يجوز على الله فيكون معنى الآية، ومنها ما لا يجوز على الله بحال، وهو إذا كان الاستواء بمعنى التمكن أو الاستقرار أو الاتصال أو المحاذاة، فإن شيئاً من ذلك لا يجوز على الباري تعالى، ولا يضرب له الأمثال في المخلوقات، وإما أن لا يفسر كما قال مالك وغيره: إن الاستواء معلوم. يعني مورده في اللغة. والكيفية التي أراد الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة، فمن يقدر أن يعيّنها، والسؤال عنه بدعة، لأن الاشتغال به وقد تبين طلب التشابه ابتغاء للفتنة. فتحصل لك من كلام إمام المسلمين مالك أن الاستواء معلوم وأن ما يجوز على الله غير متعين وما يستحيل عليه هو منزه عنه، وتعيُّن المراد بما لا يجوز عليه لا فائدة لك فيه إذ قد حصل لك التوحيد والإيمان بنفي التشبيه والمحال على الله سبحانه وتعالى فلا يلزمك سواه، وقد بينا ذلك في المشكلين على التحقيق، وأما قوله: ينزل ويجيء ويأتي، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز على الله في ذاته معانيها فإنها ترجع إلى أفعاله، وهنا نكتة وهي: أن أفعالك أيها العبد إنما هي في ذاتك، وأفعال الله سبحانه لا تكون في ذاته ولا ترجع إليه وإنما تكون في مخلوقاته، فإذا سمعت الله يقول كذا فمعناه في المخلوقات لا في الذات، وقد بين ذلك الأوزاعي حين سئل عن هذا الحديث ـ أي حديث النزول ـ فقال: يفعل الله ما يشاء. وإما أن تعلم وتعتقد أن الله لا يتوهم على صفة من المحدثات ولا يشبهه شيء من المخلوقات ولا يدخل باباً من التأويلات.
قالوا- أي أصحاب الظواهر – : نقول ينزل ولا نكيف.
قلنا: معاذ الله أن نقول ذلك، إنما نقول كما علمنا رسول الله ‘ وكما علمنا من العربية التي نزل بها القرآن، قال النبي ‘: ” يقول الله عبدي مرضت فلم تعدني.. وجعت فلم تطعمني.. وعطشت فلم تسقني ” وهو لا يجوز عليه شيء من ذلك ولكن شرّف هؤلاء بأن عبّر به عنهم، كذلك قوله: ينزل ربنا، عبّر به عن عبده وملَكه الذي ينزل بأمره باسمه فيما يعطي من رحمته… والنزول قد يكون في المعاني وقد يكون في الأجسام، والنزول الذي أخبر الله عنه إن حملته على أنه جسم فذلك ملَكُه ورسوله وعبده، وإن حملته على أنه كان لايفعل شيئاً من ذلك ثم فعله عند ثلث الليل فاستجاب وغفر وأعطى وسمّى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة ومن صفة إلى صفة فتلك عربية محضة خاطب بها من هم أعرف منكم – أهل الظاهر – وأعقل وأكثر توحيداً وأقلّ بل أعدم تخليطاً. قالوا بجهلهم: لو أراد نزول رحمته لما خص بذلك الثلث من الليل لأن رحمته تنزل بالليل والنهار. قلنا: ولكنها بالليل وفي يوم عرفة وفي ساعة الجمعة يكون نزولها أكثر وعطاؤها أوسع وقد نبّه الله على ذلك بقوله تعالى ( والمستغفرين بالأسحار ) اهـ.
ولقد أطلنا بنقل كلامه رحمه الله لنفاسته وإحكامه. ولا ندري – والله – كيف يكون مثل هذا الكلام الرفيع الرائع الرائق ضلالاً؟!
وجاء في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد (الجد) رحمه الله تعالى (18 / 504، وانظر السير 8/104، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد 14/553) ما نصه:
(قال – يعني ابن القاسم صاحب مالك – وسألت مالكاً عن الحديث في أخبار سعد بن معاذ في العرش، فقال: لا تتحدث به… وعن الحديث ” إن الله خلق آدم على صورته ” وعن الحديث في الساق، وذلك كله، قال ابن القاسم: لا ينبغي لمن يتقي الله ويخافه أن يحدث بمثل هذا. قال ابن رشد بعد أن ذكر الأحاديث التي أشار إليها ابن القاسم: وإنما نهى مالك أن يتحدث بهذين الحديثين وبالحديث الذي جاء بأن الله خلق آدم على صورته، ونحو ذلك من الأحاديث التي يقتضي ظاهرها التشبيه، مخافة أن يتحدث بها، فيكثر التحدث بها، وتشيع في الناس، فيسمعها الجهال الذين لا يعرفون تأويلها، فيسبق إلى ظنونهم التشبيه بها، وسبيلها – إذا صحت الروايات بها – أن تتأول على ما يصح، مما ينتفي به التشبيه عن الله عز وجل بشيء من خلقه، كما يصنع بما جاء في القرآن مما يقتضي ظاهره التشبيه وهو كثير، كالإتيان في قوله عز وجل ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل ) والاستواء في قوله ( الرحمن على العرش استوى ) وكما يفعل أيضاً بما جاء من ذلك في السنن المتواترة كالضحك والنزول وشبه ذلك مما لم يكره روايتها لتواتر الآثار بها، لأن سبيلها كلها في اقتضاء ظاهرها التشبيه وإمكان تأويلها على ما ينتفي به تشبيه الله عز وجل بشيء من خلقه سواء) اهـ.
ولقد نقل الحافظ أبو الحسن على بن القطان – رحمه الله تعالى – الإجماع على التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي، قال (الإقناع في مسائل الإجماع 1 / 32 – 43):
(وأجمعـوا أنه تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المؤمنين، ويعذب منهم من يشاء كما قال تعالى، وليس مجيئه بحركة ولا انتقال.
وأجمعوا أنه تعالى يرضى عن الطائعين له، وأن رضاه عنهم إرادته نعيمهم.
وأجمعوا أنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضبه إرادته لعذابهم وأنه لا يقوم لغضبه شيء) اهـ.
وفي صرف المجيء عن ظاهره الذي هو الحركة تأويل إجمالي، وفى حمل الرضا على إرادة النعيم، وحمل الغضب على إرادة العذاب تأويل تفصيلي.
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى (الاعتصام، بتحقيق محمد رشيد رضا، 1/297):
(إن للراسخين طريقاًً يسلكونها في اتباع الحق، وإن الزائغين على طريق غير طريقهم، فاحتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبها، كما نبين الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكها).
ثم أخذ ببيان طرق الزائغين فقال:
(فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة… ومنها ضد هذا، وهو ردّهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم… ومنها تخرّصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العُروِّ عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله… ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف).
وضرب مثلاً لهذا الصنف من غير أمة الإسلام بالنصارى، ثم قال رحمه الله: (ومثاله في ملة الإسلام مذهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب ـ المنزه عن النقائص ـ من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات) اهـ.
ومعنى كلامه ظاهر، أي أن المحظور هو حملها على المحسوسات، وهو اللازم من حملها على الظاهر والحقيقة، أما إثباتها مع تنزيه الله تعالى عن ظواهرها وحقائقها اللغوية المعروفة فهو حق، وهو مذهب جماهير سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم.
وقال أيضاً رحمه الله تعالى في تأويل حُبِّه تعالى وبغضه (الموافقات 2/116):
(والحب والبغض من الله تعالى إما أن يراد بهما نفس الإنعام والانتقام، فيرجعان إلى صفات الأفعال على رأي من قال بذلك، وإما أن يراد بهما إرادة الإنعام والانتقام، فيرجعان إلى صفات الذات، لأن نفس الحب والبغض المفهومين في كلام العرب حقيقة محالان على الله تعالى) اهـ.
وقال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى (النهاية في غريب الحديث 5/300):
( ” الحجر يمين الله في الأرض ” هذا الكلام تمثيل وتخييل، وأصله أن الملك إذا صافح رجلاً قبّل الرجل يده، فكأن الحجر الأسود لله بمنزلة اليمين للملك، حيث يستلم ويلثم.
ومنه الحديث الآخر ” وكلتا يديه يمين ” أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال، لانقص في واحدة منهما، لأن الشمال تنقص عن اليمين، وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة، والله منزه عن التشبيه والتجسيم ) اهـ.
وقال أيضاً عن حديث النزول (5/42): ( النزول والصعود والحركة والسكون من صفات الأجسام، والله يتعالى عن ذلك ويتقدس، والمراد به نزول الرحمة والألطاف الإلهية، وقربها من العباد، وتخصيصها بالليل والثلث الأخير منه لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عمّن يتعرض لنفحات رحمة الله، وعند ذلك تكون النية خالصة، والرغبة إلى الله وافرة، وذلك مظنة القبول والإجابة ) اهـ.
وقال الإمام القرطبي – رحمه الله تعالى – (المُفهم 6 / 672) في شرح حديث “قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن “:
(ظاهر الأصبع محال على الله تعالى قطعاً… وقد تأول بعض أئمتنا هذا الحديث فقال: هذا استعارة جارية مجرى قولهم: فلان في كفي وفي قبضتي. يراد به أنه متمكن من التصرف فيه والتصريف له كيف يشاء…) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى (الفتح 1/189) مؤولاً للفظ الحياء المضاف إلى الله تعالى في الحديث: (قوله ” فاستحيا الله منه ” أي رحمه ولم يعاقبه، وقوله ” فأعرض الله عنه ” أي سخط عليه..)’اهـ.
وقال أيضاً (الفتح 1/419) مؤوّلاً للفظ اليد (والمراد باليد هنا القدرة) اهـ.
وقال قبل ذلك (هدي الساري ص/219): (ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافاً إلى الله تعالى، واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات، وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به، فمنهم من وقف ولم يتأوّل، ومنهم من حمل كلّ لفظ منها على المعنى الذي ظهر له، وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك) اهـ
فأنت ترى أن الأمر يسير، ولا يستدعي كلّ ما أثير حوله من تهويل، فليس في حمل الكلام على المعنى المجازي كبير خطر، ما دام ذلك ضمن ما يفهم من اللسان العربي عن قرب، وهذا الحافظ ابن حجر يقول: إن أهل السنة ـ بعد التنزيه عن الظاهر ـ ما بين مفوض ومؤول، ولا نكير من أحدهم على الآخر.
وللإمام الأُبّي – رحمه الله تعالى – كـلام يعتبر قـاعدة ذهبية في هذا الباب، قال رحمه الله (شرح مسلم 7 / 54):
(القاعدة التي يجب اعتبارها أن ما يستحيل نسبته للذات أو الصفات يستحيل أن يرد متواتراً في نص لا يحتمل التأويل، وغاية المتواتر أن يرد فيما دلالته على المحال دلالة ظاهرة، والظاهر يقبل التأويل، فإن ورد فيجب صرف اللفظ عن ظاهره المستحيل، ثم اختلف، فوقف أكثر السلف عن التأويل، وقالوا نؤمن به على ما هو عند الله سبحانه في نفس الأمر، ونَكِلُ علم ذلك إلى الله سبحانه، وقال قوم بل الأولى التأويل… وإن ورد خبر واحد نصاً في محال قطع بكذب راويه، وإن كان محتملاً للتأويل يتصرف فيه كما سبق) اهـ.
وهذا كلام محكم نفيس في عبارة موجزة شاملة.
وقوله رحمه الله (وإن ورد… قطع بكذب راويه) لأنه ظني عارض القطعي، وقد ثبت بالقطعي من دليل النقل والعقل أنه تعالى ليس كمثله شيء، فكل خبر يأتي على خلاف ذلك يقطع بكذب راويه، لأن أدلة الشرع تتعاضد ولا تتضاد.
ومن اطلع على كتب التراث الإسلامي لأئمة الإسلام وجد ما لا يدخل تحت الحصر من هذه النصوص التي اكتفينا هنا بذكر شذرة منها، مما يدفع العاقل الأريب إلى الإيقان بصحة هذا المنهج الذي اجتمعت عليه الأمة.
قال الشيخ الزرقاني في ” مناهل العرفان ” (2 / 286) ما نصه:
(علماؤنا أجزل الله مثوبتهم قد اتفقوا على ثلاثة أمور تتعلق بهذه المتشابهات، ثم اختلفوا فيما وراءها:
فأول: ما اتفقوا عليه صرفها عن ظواهرها المستحيلة، واعتقاد أن هذه الظواهر باطلة بالأدلة القاطعة وبما هو معروف عن الشارع نفسه في محكماته.
ثانيه: أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل لهذه المتشابهات وجب تأويلها بما يدفع شبهات المشتبهين ويرد طعن الطاعنين.
ثالثه: إن المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه قريباً وجب القول به إجماعاً، وذلك كقوله تعالى ( وهو معكم أينما كنتم ) فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعاً، وليس لها بعد ذلك إلا تأويل واحد، هو الكينونة معهم بالإحاطة علماً وبصراً وقدرة وإرادة.
وأما اختلاف العلماء فيما وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة مذاهب)’اهـ.
فعد مذهب التفويض ومذهب التأويل، ثم جعل للإمام ابن دقيق العيد مذهباً ثالثاً متوسطاً بين المذهبين لقوله (الفتح 13 / 395) (نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه، وإن كان بعيداً توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه)، وهو في حقيقة الأمر داخل ضمن مذهب التأويل، لأنه ليس من أهل السنة أحد إلا وهو متفق معه على ما ذهب إليه من رفض التأويلات البعيدة التي ليست على مقتضى لسان العرب.
وقال الشيخ العلامة محمد الحامد – رحمه الله تعالى – (ردود على أباطيل 2/ 10):
(النصوص السمعية المحكمة أي الواضحة المعنى هي الأصل الذي يجب أن يحمل عليه المتشابه، أي الذي يسبق إلى الوهم معنى التشبيه منه ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنَّ أمُّ الكتاب وأخر متشابهات ، فأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنّا به كلٌّ من عند ربنا ، وما يتذكّر ألا أولوا الألباب ) أي آمنا به جميعاً محكمه ومتشابهه، لكن إيمانهم بالمتشابه لا ينقض إيمانهم بالمحكم الذي هو الأصل، فهم لا يشبهون الله بخلقه، بل يكلون العلم بمعنى المتشابه إلى الله عز وجل معتقدين أن له معنى شريفاً يليق به سبحانه، فلا هم بالمعطلين للنصوص ولا هم بالمشبهين، ومذهبهم وسط بين الطائفتين الشاذتين عن سبيل أهل الحق وهما المعطلة والمشبهة. وعلى هذا درج سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ولو ذهبت أسرد لك كلماتهم في هذا لطال بي القول وامتد الكلام، لكن لما ظهرت البدعة وتطلعت رؤوس أهل الزيغ وصاروا يشوشون على المسلمين عقائدهم، خشي علماء المسلمين على العقائد أن يلحقها لوث وفساد فاعتمدوا تأويل النصوص المتشابهة في إطار اللغة العربية وضمن سور الشريعة) اهـ.
وقوله رحمه الله (لكن إيمانهم بالمتشابه لا ينقض إيمانهم بالمحكم الذي هو الأصل) واضح في الرد على من حمل المتشابه على مقتضى الحس، فهؤلاء بدلاً من أن يحملوا المتشابه على المحكم ويرجعوه إليه، فعلوا العكس، فنقضوا بفعلهم هذا إيمانهم بالمحكم من مثل قوله تعالى ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ) وقال الداعية الكبير سيد قطب رحمه الله تعالى (في ظلال القرآن، سورة الحديد):
(وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره، لا نعلم حقيقته، أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، استناداً إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء، والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسرقوله تعالى ( ثم استوى ) ، والأولى أن نقول: إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا، والتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا إليه آنفاً، لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا) اهـ.
وبالجملة، فإن منهج سيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال دائر بين التأويل الذي أخذ به أولاً قبل العودة على الظلال بالتنقيح، وبين التفويض الذي آل إليه رأيه أخيراً، وكلا الطريقين حق، بل إن طريق التفويض الذي كان عليه جمهور السلف الصالح أولى بالاتباع ما لم تدعُ حاجة إلى التأويل.
وهذا الذي آل إليه رأي سيد قطب رحمه الله تعالى هو من قبيل ما ينسب إلى بعض الأئمة مثل الإمام الجويني والرازي والغزالي وغيرهم، ففهم البعض منه أنهم هجروا منهج الإمام الأشعري، وقد ردَدْنا هذا الفهم وبيَّنّا بطلانه، كما بيَّنا أيضاً أن منهج الأشعري تفويض وتأويل، وأنهم تركوا التأويل ورجعوا إلى التفويض الذي كان عليه جمهور السلف، وذكرنا أنه ليس بين المسلكين تناقض، إذ كلاهما قائل بتنزيه الله تعالى عن سمات النقص والحدوث، وكلاهما مؤوّل، فالسلف أوّلوا إجمالاً، والخلف أوّلوا تفصيلاً.
وقال الشيخ عمر التلمساني رحمه الله تعالى (بعض ما علمني الإخوان ص/17) في قوله تعالـى ( والسموات مطويات بيمينه ) (إن هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن من طي السموات والأرض، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيفما تشاء عندما تشاء) اهـ.
وكذا قال سيد قطب عند هذه الآية (الظلال 5/3062):
(وكل ما ورد في القرآن والحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر إدراكها بغير أن توضع لهم في تعبير يدركونه، وفي صورة يتصورونها، ومنه هذا التصوير لجانب من حقيقة القدرة المطلقة التي لا تتقيد بشكل ولا تتحيز في حيز ولا تتحدد بحدود) اهـ.
وقال الإمام الداعية حسن البنا رحمه الله (مجموعة رسائل الإمام ص 411):
(انقسم الناس في هذه المسألة على أربع فرق:
الأولى: أخذت بظواهرها كما هي فنسبت إلى الله وجهاً كوجوه الخلق ويداً أو أيدٍ كأيديهم وضحكاً كضحكهم… وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة، وليسوا من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيب من الصحة.
والثانية: عطلت معاني هذه على أي وجه، يقصدون بذلك نفي مدلولاتها عن الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى عندهم لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر… وهؤلاء هم المعطلة ويطلق عليهم بعض علماء تاريخ العقائد الإسلامية الجهمية… هذان رأيان باطلان لا حظ لهما من النظر.
وبقي أمامنا رأيان هما محل أنظار العلماء في العقائد وهما رأي السلف والخلف.
مذهب السلف: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب… الخ، وكل ذلك بمعان لا ندركها، ونترك لله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها…
أما الخلف: فقد قالوا إننا نقطع بأن معاني ألفاظ هذه الآيات والأحاديث لا يراد بها ظواهرها، وعلى ذلك فهي مجازات لا مانع من تأويلها…) اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى (بين السلف والخلف: قد علمت أن مذهب السلف في الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى أن يُمِرّوها على ما جاءت عليه ويسكتوا عن تفسيرها أو تأويلها، وأن مذهب الخلف أن يؤولوها بما يتفق مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه) اهـ.
ثم بين رحمه الله تعالى أن كلا المذهبين حق ولا يستلزم اختلافهم تكفيراً ولا تفسيقاً.
وهو كما قال رحمه الله إذ لا خلاف بين السلف والخلف في هذا الباب، وإنما هو اختلاف جائز مباح، فَرَضَه اختلاف الظروف التي كان يعيشها كل من السلف والخلف، فزمن السلف كان خاليـاً من بدعة القول بالظاهر والتجسيم فاقتضى ذلك أن يتوقفوا ولا يقدموا على تفسير هذه النصوص، بخلاف أزمنة الخلف التي شاعت فيها مقالات المبطلين مما دعاهم إلى التصريح بالتأويل.
ولكن الخلاف الحقيقي هو الواقع بين السلف والخلف من جانب ومن يحملون هذه النصوص على ظواهرها وعلى مقتضى الحس من جانب آخر.
إن السلف الصالح والخلف متفقون جميعاً على صرف هذه النصوص عن ظاهرها المحال في حق الله تعالى، بل الأمة مجمعة على ذلك، كيف لا وهذه الظواهر منفية عن الله تعالى بالقطعي من الأدلة النقلية والعقلية، وهؤلاء الذين يصرون على إثبات هذه الظواهر المستلزمة لمعان باطلة ولوازم مستحيلة، لا يختلفون معنا في كون هذه اللوازم الباطلة من الجسمية والحد ونحوها منفية عن الله تعالى، إلا أنهم يجهلون أن إثبات الحقائق اللغوية المعهودة والظواهر المتبادرة من المتشابه يستلزم إثبات ما قد نفوه وأجمعت الأمة على نفيه وعلى تنزيه الله تعالى عنه وهو الحد والتحيز والجسمية ونحوها، وكونهم لا يقرون بهذه اللوازم أمرٌ لا يُقضى منه العجب، لأن إثبات الملزوم وهو المعنى الظاهر هنا ثم نفي اللازم وهو الجسمية ونحوها لا يعقل لأنه لازم لا ينفكّ.
وإذا قيل لهم: إن هذه الألفاظ إنما وضعت للدلالة على المخلوق، وأنه لا يفهم منها إذا حملت على الظاهر إلا ذلك. قالوا: إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أثبتم ذاتاً لا كالذوات متصفة بالحياة والعلم والسمع والبصر، وغيرها مما أطلقتم عليه صفات المعـاني، ولم تؤولوا شيئاً منها، أثبتوا له تعـالى استواء ووجهاً ويداً وضحكاً ومللاً وأصبعاً.. الخ على الحقيقة وبلا تأويل!!
وهذه مغالطة وكلام يوهم ظاهره أنه حق، وقد يلتبس عند الخاطر الأول على من لم يدقق ويمعن النظر، ولكن مع قليل من التروي ينجلي للعقل فساد باطنه.
وقضية هذا الكلام التسوية بين ما يعرف بصفات المعاني وهذه الألفاظ والإضافات الواردة في نصوص المتشابه، وهي قضية خاسرة كما سنبين.
إن الفرق الذي بين الألفاظ التي تدل على الأجسام وما إليها وبين الألفاظ التي تدل على المعاني كبير وشاسع، فالأولى منها أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماعها العضو والجسم الذي وضعت للدلالة عليه، فإذا أضيف ذلك اللفظ إلى الله تعالى قطع العارف بالله أن ذلك المعنى المتبادر والظاهر من اللفظ محال هنا ومنفي عن الله تعالى وإنما سيق الكلام على سبيل
الاستعارة والمجاز، وذلك كلفظ (اليد، والأصبع، والقدم، والساق، والوجه، والضحك، والاستواء، والنزول) ونحوها من الألفاظ التي ترجع حقائقها المتبادرة منها إلى الحس.
أما الثانية منها وهي التي ترجع إلى المعنى مثل القدرة والإرادة والسمع والبصر ونحوها فلا يلزم من حملها على ظاهرها وحقيقتها مشابهة لأنها معانٍ مجردة وحقائقها واسعة، فإذا أضيفت للخالق كان لها حقيقة لائقة به تعالى، وإذا أضيفت للمخلوق كانت لها حقيقة لائقة به ولهذا السبب لم يضطر علماء الأمة إلى صرفها عن ظاهرها.
ومما يعضد هذا القول أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه قال في شيء من صفات المعاني أمرّوها بلا كيف، أو لا تفسر ولا تكيف..الخ. وما هذا إلا لفطنتهم لهذا الفارق بين النوعين من الألفاظ، والأمر واضح وبيِّن لمن كان له شيء من الاطلاع على علوم اللغة.
وانظر إلى قول الإمام أحمد رضي الله عنه كما جاء في عقيدته المروية عنه في طبقات الحنابلة (2/291):
(إن لله تعالى يدين، وهما صفة له في ذاته، ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين ولا جسم، ولا من جنس الأجسام، ولا من جنس المحدود والتركيب، ولا الأبعاض والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق ولا عضد، ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم: يد، إلا ما نطق به القرآن الكريم أو صحَّت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة فيه) اهـ.
فقد نفى الإمام أحمد رضي الله عنه كلَّ ما يعلق باللفظ من الظواهر الباطلة من الجوارح والأبعاض والتركيب ونحوها، وأوضَحَه بقوله: (ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم: يـد) أي كلُّ ما يقتضيه إطلاق لفظ اليد من هذه المعاني التي مرَّت من الجارحة والجسم ونحوه، كلُّه منفيٌّ عن ربِّنا عزَّ وجلَّ.
وقال أيضاً رضي الله عنه في صفة الاستواء (ولا يجوز أن يقال: استوي بمماسَّة ولا بملاقاة، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً) اهـ.
وهذا نصٌّ في نفي الظاهر المتبادر من إطلاق اللفظ، وهو ما يقول به الأشاعرة، فيثبتون لله تعالى يدين ووجهاً وعيناً وأنه تعالى استوي على عرشه كما قال سبحانه مخبراً عن نفسه، يثبتون كل ما أثبته تعالى لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له وينزهونه عن ظواهر هذه الألفاظ مما يعهده الخلق من أنفسهم وما يفهمونه من لغاتهم التي وضعوها لأجل التعبير بها عما يحتاجون إليه من شؤونهم، والله متعالٍ عن كل ذلك.
ولعل قائلاً أن يقول:
إنكم حين نفيتم الظواهر عطَّلتم ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليـه وسلم.
فنقول: نحن إنما نفينا الظواهر ونزهنا الله تعالى عنها، وليس الظاهر – قطعاً – هو مراد الله تعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، بل إن هذه الظواهر باتفاق السلف والخلف منفية عن الله تعالى عقلاً ونقلاً.
ونحن نفينا هذه الظواهر ولم ننفِ الصفة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فلم يَقُلْ أحد من أهل السنة أن الله تعالى ليس له يدان أو ليس له عين أو غير مستوٍ على عرشه، كلا، بل قالوا لله تعالى يدان ولكن يده تعالى ليست بجارحة، وهذا قول السلف كما مرَّ عن الإمام أحمد، ولله تعالى وجه وهو ليس بجارحة أو صورة أو جسم، وهو قول السلف كما في عقيدة الإمام أحمد، ولله تعالى عين ليست بجارحة، والله تعالى استوى على عرشه استواءً لائقاً به تعالى ليس بمماسة ولا بملاقاة، وهذا الذي قاله الإمام أحمد كما مرَّ، وهكذا، فتراهم يثبتون ما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة وينزهون الله تعالى عن الظاهر الذي يُفهَم من اللفظ بيـن الخلق، وحين يُستبعد الظاهر والحقيقة اللغوية المتبادرة من اللفظ لا يبقى إلا المجاز، فترى جمهور السلف لاحتمال اللفظ أكثر من معنى لديهم يتوقفون عن تعيين أحدها مكتفين بالفهم الإجمالي للفظ حسب موطنه من الكلام، فيفهمون من قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ) أن الله تعالى جوادٌ كريم لا تفنى خزائنه ولا ينقطع عطاؤه، ويفهمون من قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) النصرة والثواب، وهكذا، لكن جمهورهم لم ينطق بهذه المعاني، لوضوحها عندهم وعدم الحاجة إلى التصريح بها لخلوِّ عصرهم مما يقتضي ذلك، بيد أن هذا لم يمنع البعض منهم رضي الله عنهم من التصريح ببعض هذه المعاني كما سيأتي معنا في مبحث تأويلات السلف.
على أننا نقول: إن الله تعالى هو من علمنا كيف ننزهه وننفي عنه كلَّ ما لا يليق بذاته العلية من هذه الظواهر، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في فضل عيادة المريض والذي يقول فيه الرب تعالى لعبده يوم القيامة: (يا ابن آدم مرضت فلم تعدني… يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني… يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني) كل ذلك والعبد يقول (رب كيف أعودك وأنت رب العالمين… رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين.. رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين) فإنه عندما استحال في عقل العبد الذي ينزه مولاه عن صفات المخلوقين وسمات الأجسام وعوارض النقص والآفات أن يمرض ربه ويعوده على الحقيقة وأن يستطعم ويستسقي على الحقيقة سأل (رب كيف.. وأنت رب العالمين) أي أن حقائق هذه الألفاظ لا تليق به تعالى وهي محالة قطعاً في حقه، وما دامت منفية الظاهر والحقيقة فهي عنده بلا معنى مفهوم. ولهذا سأل (رب كيف)، وهذا شأن كل لفظ من هذه الألفاظ التي من هذا القبيل عندما يستحيل معناه الظاهر والحقيقي يستفسر عن المـراد منـه بـ (كيف)، وهذا الذي حدث من بعض العوام في الصدر الأول حين أخذوا يسألون عن مثل هذه الألفاظ: كيف استوي؟ كيف ينزل؟ كيف يضحك؟ فنهاهم علماء السلف عن الاستفسار عن معانيها بقولهم (بلا كيف) وألزموهم تنزيه الله تعالى عن ظواهرها ثم السكوت بعد الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء.
قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى (الإشارة إلى الإيجاز ص/7):
(وأما قوله عليه السلام حكاية عن ربِّه ” مرضت فلم تعدني واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني ” فيحمل على حذف المضاف تقديره مرض عبدي فلم تعدْه، واستطعمك عبدي فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلم تسْـقِه… ويدلُّ على هذا أن الملوم لمَّا قيل له استطعمتك فلم تطعمني. قال استبعاداً لذلك وتعجباً منه – لمَّا لم يتفطن لحذف المضاف وإرادة الرب – كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ حملاً للكلام على ظاهره، فأظهر الرب سبحانه وتعالى مرادَه من تأويل كلامه فقال: ” مرض عبدي فلم تعدْه واستطعمك عبدي فلم تطعمْه واستسقاك عبدي فلم تسْقه) اهـ.
وقوله (حملاً للكلام على ظاهره) أي أن العبد قال ذلك مستبعداً له لمّا لم يتفطن لغيره من المعاني اللائقة بالله تعالى.
وقال العلامة ابن خلدون – رحمه الله تعالى – (المقدمة 3 /1088، بتحقيق علي عبدالواحد وافي):
(إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري وناظر مشيختهم – أي المعتزلة – في مسائل الصلاح والأصلح، فرفض طريقتهم وكان على رأي عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحارث المحاسبي من أتبـاع السلف وعلى طريقة السنة فأيد مقالاتهم – يعني السلف – بالحجج الكلامية وأثبت الصفات القائمة بذات الله تعالى من العلم والقدرة والإرادة… وكان من مذهبهم إثبات الكلام والسمع والبصر، لأنها] يعني هذه الصفات [وإن أوهم ظاهرها النقص بالصوت والحرف الجسمانيين، فقد وجد للكلام عند العرب مدلول آخر غير الحروف والصوت وهو ما يدور في الخلد والكلام حقيقة فيه دون الأول…. وأما السمع والبصر وإن كان يوهم إدراك الجارحة فهو يدلُّ لغةً على إدراك المسموع والمبصر وينتفي إيهام النقص حينئذ لأنه حقيقة لغوية فيهما) اهـ.
هذا فيما يتعلق بصفات المعاني، أما الصفات الأخرى التي يريد هؤلاء التسوية بينها وبين صفات المعاني وذلك بقولهم يجب إثبات حقائقها ومعانيها الظاهرة كما هو الحال في صفات المعاني فيقول العلامة ابن خلدون عنها:
(وأما لفظ الاستواء والمجيء والنزول والوجه واليدين والعينين([2]) وأمثال ذلك، فعدلوا عن حقائقها اللغوية لما فيها من إيهام النقص بالتشبيه إلى مجازاتها على طريقة العرب حين تتعذر حقائق الألفاظ، فيرجعون إلى المجاز، كما في قوله تعالى: ( يريد أن ينقضّ ) وأمثاله، طريقة معروفة لهم غير منكرة ولا مبتدعة) اهـ.
ثم قال موضحاً سبب أخذ الخلف بالتأويل: (وحملهم على هذا التأويل وإن كان مخالفاً لمذهب السلف في التفويض أن جماعة ارتكبوا في محمل هذه الصفات فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى مجهولة الكيفية فيقولون في ( استوى على العرش ) ، نثبت له استواء بحيث مدلول اللفظ] أي على الحقيقة [فراراً من تعطيله، ولا نقول بكيفيته فراراً من القول بالتشبيه الذي تنفيه آيات السلوب من قوله تعالى
( ليس كمثله شئ ) ( سبحان الله عمّا يصفون ) ( تعالى الله عمّا يشركون ) ( لم يلد ولم يولد ) ولا يعلمون مع ذلك أنهم ولجوا من باب التشبيه في قولهم بإثبات استواءٍ] يعني ظاهره اللغوي وحقيقته المعهودة عند الخلق [والاستواء عند أهل اللغة إنما موضوعه الاستقرار والتمكن وهو جسماني. وأما التعطيل الذي يشنعون بإلزامه وهو تعطيل اللفظ ـ أي ظاهره ـ فلا محذور فيه وإنما المحذور في تعطيل الإله([3])… ثم يدعون أن هذا مذهب السلف، وحاشا لله من ذلك، وإنما مذهب السلف ما قررناه أولاً من تفويض المراد بها إلى الله والسكوت عن فهمها… ثم طردوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين والنزول والكلام بالحرف والصوت يجعلون لها مدلولات أعم([4]) من الجسمانية وينزهونه عن مدلول الجسماني منها، وهذا شيء لا يعرف في اللغة، وقد درج على ذلك الأول والآخر منهم، ونافرهم أهل السنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية ورفضوا عقائدهم في ذلك) اهـ.
وهذا الذي قرره وحرره العلامة ابن خلدون هو ما أطبقت عليه الأمة.
فإن قيل: قول السلف (بلا كيف) و(أمروها كما جاءت) ونحو ذلك مما نقل عنهم، تفويض في الكيف إلى الله بعد إثبات المعنى الظاهر.
قلنا: إن نفي هذه المعاني الظاهرة متفق عليه عند جميع العارفين بالله تعالى، وقد ذكرنا قبل أن هذه الكيفيات المحسوسة مما يتنزه الله تعالى عنها ولا يجوز وصفه بها لأنها لوازم لا تنفك عن المعاني الظاهرة من هذه الألفاظ، وحاشا السلف الصالح أن يثبتوا لله تعالى ما يستحيل في حقه وهم أعرف الخلق كافة بالله بعد رسول الله ‘.
وهذه نصوص العلماء في تنزيه الله تعالى عن الكيفيات المحسوسة:
من ذلك ما جاء في كتاب ” الاعتقاد ” للحافظ البيهقي (ص / 93):
قال الحافظ البيهقي: قال الأوزاعي: (كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه).
قال البيهقي (وإنما أراد – والله أعلم – فيما تفسيره يؤدي إلى تكييف، وتكييفه يقتضي تشبيهه له بخلقه في أوصاف الحدوث) اهـ.
نقول: إن كل ما جاء من نصوص المتشابه في الصفات من هذا القبيل، لأن ظاهره ومعناه الحقيقي يؤدي إلى التكييف المقتضي للتشبيه لا محالة، فلا فرق بين إثبات المعنى الحقيقي لهذه الألفاظ وبين التكييف المستحيل في حق الله تعالى، وهذا بعينه ما أشار إليه الإمام مالك رضي الله عنه في القول المشهور عنه في الاستواء (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول..) أي لا يعقل، ولا يجوز على الله تعالى، لأن التكييف تحديد، والله تعالى منزه عن الحدود.
ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض مؤيداً له ما نصه (شرح مسلم 5 / 24):
(لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء… ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم… وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟!! لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوي على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره وهو قوله تعالى ” ليس كمثله شيء ” عصمة لمن وفقه الله تعالى) اهـ.
ونحن نتساءل بعجب مع القاضي عياض والإمام النووي وباقي أئمة الدين وأعلام المسلمين ونقول: وهل بين التكييف والقول بظواهر هذه النصوص فرق؟!!
وما هذا إلا للزوم التكييف لهذه الظواهر لزوماً غير قابل للانفكاك.
وقول الإمام أحمد المارّ قريباً (نؤمن بها ونصدق ولا كيف ولا معنى) صريح في كونهم رضي الله عنهم يفوضون المعنى، ولا يحتمل التفسير بغير ذلك.
وقال الإمام الخطابي معلقاً على حديث أطيط العرش ما نصه (معالم السنن 4 / 328):
(هذا الكـلام إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية، والكيفية عن الله وصفاته منفية..) ثم أخذ بتأويل الحديث على ما يليق، وقد مر معنا قريباً.
وقال الحافظ ابن عبد البر – رحمه الله تعالى – (التمهيد 7 / 144) أثناء كلامه على حديث النزول بعد أن نقل قول القائلين: ينزل تعالى بذاته. قال: (ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة، لأن هذا كيفية وهم يفزعون منها لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عياناً، وقد جل الله وتعالى عن ذلك) اهـ.
وقال الحافظ ابن كثير مفوضاً وذامّاً الذين يحملون المتشابه على ظاهره وذلك في تفسيره لقوله تعالى في سورة الأعراف (ثم استوي على العرش) (2 / 220) ما نصه:
(فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه) اهـ.
وقال الشيخ سلامة العزامي القضاعي – رحمه الله تعالى – (الفرقان في ذيل الأسماء والصفات للبيهقي ص / 78):
(ومجمل القول في هذا الباب أن صفات المحدثات على قسمين:
القسم الأول :
ما يدل على الحدوث والإمكان والافتقار والاحتياج من حيث ذاته وماهيته أو ملزوماته أو لوازمه المساوية، كالكون في الجهة والمكان، وكالصغر والكبر والجسمية وقبول الانقسام، فهذا مختص بالكائنات لا يجوز أن يتصف الخالق منه بشيء ثم منه ما يكون القول به في الله كفراً إجماعا ً، ككونه – تعالى – والداً أو مولوداً أو ذا صاحبة أو له شريك، ونحو ذلك من كل ما النقص فيه جلي، ومنه ما اختلف فيه على أقوال ليس هذا محل بسطها، أرجحها أن ذلك ضلال وبدعة وفسق شنيع، أشد من فسق الجوارح بكثير، وقد يعذر العامي في الجهل ببعض ذلك، وأما من ارتفعت درجته عن العامية فلا يعذر وإنما يعزر، فإن كان داعية إلى رأيه كان الذنب أعظم والأمر أخطر – عياذاً بالله من ذلك.
القسم الثانى :
ما لا يدل على مـا سبق من حيث ذاته بل من حيث نقصه عن الدرجة العليا في كماله، كالوجود والحياة والعلم والإرادة والقدرة وأشباهها من كل صفة هي من حيث ذاتها كمال، فهذا القسم هو للحق تعالى بالأصالة على أكمل درجاته وأبعدها عن شوب النقص، وأرفعها عن الإمكان ولوازمه، واجب بوجوب موصوفه تبارك وتعالى، قديم بقدمه باق ببقائه، أما ما للخلق منه فهو له بالعرض حادثٌ فيه بإحداث الحق ممكنٌ غيرُ واجب، على درجة نازلة لائقة بحال الممكن، بحيث لا نسبة بين ما اتصف به الحق جل وعز وما اتصف به الممكن – أي المخلوق – وأين وجودٌ ممكنٌ حادثٌ قابلٌ للزوال غيرُ مملـوكٍ للمتصفِ به حين اتصافه به، من الوجودِ الواجبِ الأزليِّ الأبدي الذي يجل عن الابتداء والانتهاء، ويرتفع عن قبول الفناء؟!
… وبهذا يبين لك معنى قوله تعالى في صفة ذاته العلية وكمالاته المقدسة ( ليس كمثله شئ ) ( هو الحي ) ( وهو اللطيف الخبير ) ( وهو العليم القدير ) ( لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ) إلى أمثال هذه الآيات الشريفة من كل ما دل على انحصار هذه الصفات فيه عز وجل، وقصرها عليه. ولبُـعْدِ ما بين حقائق هذه الصفات في الممكن – يعني المخلوق – وحقيقتِها في الواجب -يعني الله تعالى – قال بعض الفضـلاء: إن إطلاق الوجود والحياة والعلم ونحوها على الممكن ما هو إلا بالمجاز.
… وأرجو بعد هذا البيان لهذين القسمين أن تكون قد تكشفت لك تلك المغالطة التي قد يفوه بها بعضهم في مناظرة أهل السنة… وهو قولهم: إن الوجه والعين واليدين والقدمين والساق صفات كما أن الحياة والعلم والإرادة والقدرة صفات، وقد قلتم بها في ذات الله، فلماذا لا تقولون بتلك الصفات الوجه وما ذكر معه؟ فكما قلتم له علم لا كالعلوم، وقدرة لا كالـقُـدَر، فقولوا له وجه على الحقيقة لا كالوجوه ويد على الحقيقة لا كالأيدي ورجل على الحقيقة لا كالأرجل وساق على الحقيقة لا كالسوق، ويتوسعون في ذلك حتى انخدع بهذا الكلام من أهل الفضل من تروج عليه الحيل، ويغره الزخرف من القول، ويزيد في رواج هذا الزخرف أن هذه العبارة: ” له وجه لا كالوجوه ” توجد من بعض الأكابرالمنزهين للحق عن الأجزاء والجسمية كما هو الحق، وهي من هؤلاء ـ أي مثبتي الظواهرالحسية ـ مغالطة.. فإن الوجه والعين واليد والرجل والساق أجزاء وأبعاض وأعضاء لما هي فيه من الذوات،لا معان وأوصاف تقوم بموصوفاتها، فأين هي مما ألحقوها به من الحياة والعلم والإرادة والقدرة؟!.
وهل هذا إلا كتشبيه العالم بالعلم والأبيض بالبياض؟!
… فإن قالوا: إنا لا نريد بالوجه وأخواته ما هو أجزاء وأبعاض، بل نريد ما هو صفات حقيقة كالعظمة والملك والبصر والقدرة، ولكنا لا نعين المراد.
قلنا لهم: مرحبا بالراجعين إلى الحق… ولا نزاع بيننا وبينكم) انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير.
وجاء في كتاب مناهل العرفان للشيخ الزرقاني – رحمه الله تعالى – (2 / 291) ما نصه:
(لقد أسرف بعض الناس في هذا العصر، فخاضوا في متشابه الصفات بغير حق، وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها بما لا يأذن به الله، ولهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه.. حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات ومن المؤسف أنهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا، ومن المحزن أنهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح… من ذلك قولهم: إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية!! وله من الجهات الست جهة الفوق، ويقولون إنه – تعالى – استوى على العرش بذاته استواءً حقيقياً، بمعنى أنه استقر عليه استقراراً حقيقياً، غير أنهم يعودون فيقولون: ليس كاستقرارنا وليس على ما نعرف، وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية، وليس لهم فيما نعلم إلا التشبث بالظواهر، ولقد تجلى لك مذهب السلف والخلف فلا نطيل بإعادته… لو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة، واكتفوا بتنزيه الله تعالى عما توهمه ظواهرها من الحـدوث ولوازمـه، ثم فوضـوا الأمـر إلى الله وحـده) اهـ.
وقال العلامة محمود بن خطاب السبكي – رحمه الله تعالى – (الدين الخالص 1 / 28):
(وأما السلف والخلف فإنهم مجمعون على ثبوت صفات الله تعالى الواردة في الكتاب العزيز والسنة المحمدية، وإنما خلافهم في تفويض معنى المتشابه وهو مذهب السلف، وفي بيان معناه وهو مذهب الخلف) اهـ.
قال الإمام ابن الجوزي – رحمه الله تعالى – (دفع شبه التشبيه ص / 97 وما بعدها):
(ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح، فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات، وعينين وفما ولهوات، وأضراسا وأضواء لوجهه هي السبحات، ويدين وأصابع وكفّاً وخنصراً وإبهاماَ وصدراً وفخذاً وساقين ورجلين.
وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس.
وقالوا: يجوز أن يَمَسَّ ويُمَسَّ، ويُدْني العبد من ذاته.
وقال بعضهم: ويتنفس.
ثم يرضون العوام بقولهم: لا كما يعقل!!
وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات، فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى، ولا إلى إلغاء ما يوجبه الظاهر من سمات الحدوث، ولم يقنعوا بأن يقولوا: صفة فعل. حتى قالوا: صفة ذات، ثم لما أثبتوا أنها صفات ذات، قالوا: لا نحملها على توجيه اللغة مثل يد على نعمة وقدرة، ومجيء وإتيان على معنى بر ولطف، وساق على شدة، بل قالوا: نحملها على ظواهرها المتعارفة، والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين، والشيء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن، ثم يتحرجون من التشبيه، ويأنفـون من إضافته إليهم، ويقولون: نحن أهل السنة. وكلامهم صريح في التشبيـه، وقد تبعهم خلق من العـوام…).
إلى أن قال: (فلو أنكم قلتم نقرأ الأحاديث ونسكت، ما أنكر عليكم أحد، إنما حَـمْـلُكم إياها على الظاهر قبيح) اهـ.
وقال الإمام ابن القشيري – رحمه الله تعالى – (إتحاف السادة المتقين 2 / 109):
(يقولون – يعني أهل الظاهر – نحن نأخذ بالظاهر ونجري الآيات الموهمة تشبيهاً والأخبار المقتضية حداً وعضواً على الظاهر، ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك، ويتمسكون بقوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله ) … وأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدع وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهات، فمن أصغى إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيل المحسوسات فيعتقد الفضائح، فيسيل به السيل وهو لا يدري) اهـ.
قال الشيخ الزرقاني – رحمه الله تعالى – (مناهل العرفان 2 / 292):
(فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلة القطعية التي توافرت على أنه تعالى ليس جسماً ولا متحيزًا ولا متجزئًا ولا مركبًا، ولا محتاجًا لأحد ولا إلى مكان ولا إلى زمان، ولا نحو ذلك، ولقد جاء القرآن بهذا في محكماته، إذ يقول: ( ليس كمثله شئ ) ويقول ( قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ) ويقول: ( إن تكفروا فأنّ الله غنىٌّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ، وإن تشكروا يرضه لكم ) ويقول: ( ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ، والله هو الغنىُّ الحميد ) وغير ذلك كثير في الكتاب والسنة، فكل ما جاء مخالفاً بظاهره لتلك القطعيات والمحكمات فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتباعها، كما تبين لك فيما سلف.
ثم إن هؤلاء – يعني القائلين بالظواهر – متناقضون، لأنهم يثبتون تلك المتشابهات على حقائقها، ولا ريب أن حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث، كالجسمية والتجزؤ والحركة والانتقال، لكنهم بعد أن يثبتوا تلك المتشابهات على حقائقها ينفون هذه اللوازم، مع أن القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه لنفسه عاقل، فضلاً عن طالب أو عالم، فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة: إن الاستواء باق على حقيقته يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز، وقولهم بعد ذلك ليس هذا الاستواء على ما نعرف، يفيد أنه ليس الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز، فكأنهم يقولون: إنه مستو غير مستو ومستقر على العرش غير مستقر، أو متحيز غير متحيز، وجسم غير جسم، أو أن الاستواء على العرش ليس هو الاستواء على العرش، والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه… فإن أرادوا بقولهم الاستواء على حقيقته، أنه على حقيقته التي يعلمها الله ولا نعلمها نحن، فقد اتفقنا، لكن تعبيرهم هذا موهم، لا يجوز أن يصدر من مؤمن، خصوصاً في مقام التعليم والإرشاد وفي موقف النقاش والحجاج، لأن القول حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده، ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة، والاستواء في اللغة العربية يدل على ما هو مستحيل على الله في ظاهره فلابد إذن من صرفه عن هذا الظاهر، واللفظ إذا صرف عما وضع له واستعمل في غير ما وضع له خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا محالة، ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس على العامة وفتنة لهم فكيف يواجهونهم به ويحملونهم عليه؟!
وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وحدة الأمة، الأمر الذي نهانا القرآن عنه، والذي جعل عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ يفعل ما فعل بصبيغ، وجعل مالكا ـ رحمه الله تعالى ـ يقول ما قال ويفعل ما فعل بالذي سأله عن الاستواء.
ولو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة، واكتفوا بتنزيه الله تعالى عما توهمه ظواهرها من الحدوث ولوازمه، ثم فوضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده) اهـ.
وبأقوال أئمة الإسلام وأعلام الأمة ينجلي في هذه القضية وجه الحق، وتتضح المحجة، ويتبين على وجه اليقين أنه ليس لأهل الحق في هذه المسألة إلا قولان، التفويض الذي عليه أكثر السلف، والتأويل الذي عليه أكثر الخلف وجماعات من السلف، وليس بعد هذين المذهبين إلا التعطيل أو التشبيه.
* * * * *
([1]) ذكر قول الأوزاعي هذا الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى ثم قال: أي يظهر الله من أفعاله ما يشاء. اهـ الرسالة الوافية ص/137.
([2]) لم يرد لفظ العينين في القرآن والسنة، فلعلَّ هذا من تصحيفات النساخ. انظر ما مرَّ ص 18 ـ 19.
([3]) أي نفي صفاته تعالى كأن يقال: لم يستو أو غير مستو، أو ليس لله يدان أو وجه أو لا يغضب أو لا يحب ونحو ذلك مما وقعت به بعض الفرق المعطلة فهذا هو المحظور، أما نفي الظاهرالمحال وإثبات الصفة التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام فليس بمحظور، وهذا ما فعله أهل السنة الأشاعرة.
([4]) وهذا الذي ذكره العلامة ابن خلدون هو ما عنيناه بقولنا إن صفات المعاني لها مدلولات واسعة أعم من الجسمانيات لذا لم يضطر العلماء معها إلى صرفها عن مدلولها الظاهر، فهي لها مدلول خاص إذا أضيفت إلى الله تعالى ومدلول آخر إذا أضيفت إلى المخلوق، أما ألفاظ المتشابه فمدلولها الظاهر ضيق لا يفهم منه إلا الجسمانيات، ولهذا اضطر العلماء معها إلى الصرف عـن هـذا الظاهر فإما التفويض وإما التأويل وهذا بعينه ما أراده العلامة ابن خلدون في هذه العبارة فإنه لا يعقل ـ مثلاً ـ أن يقولوا لا نثبت لله تعالى جارحة ثم يحملون هذه الألفاظ على الظاهر فإنه لا ظاهر هنا إلا الجارحة والجسمانيات.