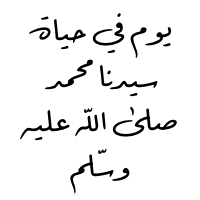الإستدلال بالخطاب هل يفيد القطع؟ ،تحقيق مسألة حجية خبر الواحد في العقيدة وكلام الرازي في ذلك
27 – الإستدلال بالخطاب هل يفيد القطع؟
قال الدكتور: { ب- صرح متكلموهم… ومنهم من سبق في فقرة (أ) أن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة، ولا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشرة عوارض منها:
الإضمار والتخصيص والنقل والاشتراك والمجاز … الخ، وسلمت بعد هذا من المعارض العقلي بل قالوا: من احتمال المعارض العقلي!}
أقول: قد أشار الدكتور سفر بكلامه هذا إلى مسألة مهمة من مسائل علم أصول الفقه بدون أن يكون محيطا بها.
وقد عنونوا المسألة «بمسألة تعارض ما يخل بالفهم»، وهذا تعبير البيضاوي في المنهاج. وبمسألة «أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا؟» وهذا هو عنوان الرازي في المحصول.
فلا بد أن نبين المسألة، فننقل فيها أولا كلام الإمام الرازي في المحصول. قال تحت العنوان المذكور «منهم من أنكره، (أي أنكر إفادة الخطاب القطع) وقال: إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على المقدمات الظنية ظني، فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن.
وإنما قلنا: “إنه مبني على مقدمات ظنية” لأنه مبني على نقل اللغات، ونقل النحو والتصريف، وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ، والمعارض، وكل ذلك أمورٌ ظنية. ثم أفاض الرازي في بيان أن هذه الأمور ظنية، ثم قال في آخر الكلام: واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا بالتواتر». هذا هو كلام الرازي في المحصول.[1] فنقل الإنكار عن غيره ثم بين رأيه الذي هو الإنصاف، وكذلك فعل في الأربعين.
وعبَّرَ بعض العلماء عن المسألة بتعبير آخر، فقال: إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفي عشرة احتمالات: الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص، والتقديم، والتأخير، والناسخ، والمعارض العقلي، وتغير الإعراب.
قال القرافي شارحا رأي الرازي واختياره: تقريره أن الوضع بما هو وضع تتطرق إليه هذه الاحتمالات، ومع القرائن يقطع بأن المراد ظاهر اللفظ، ثم القرائن تكون بتكرر تلك الألفاظ إلى حد يقبل القطع، أو سياق الكلام، أو بحال المخبر الذي هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والقرائن لا تفي بها العبارات، ولا تنحصر تحت ضابط، ولذا قطعنا بقواعد الشرع، وقواعد الوعد والوعيد وغيرها بقرائن الأحوال والمقال، وهو كثير في الكتاب والسنة.[2]
وقال المحقق البياضي: «إن الدليل النقلي يفيد الاعتقاد واليقين في المعتقدات عند التوارد على معنى واحد بالعبارات والطرق المتعددة، والقرائن المنضمات… واختاره متقدموا الأشاعرة. وقال صاحب الأبكار والمقاصد: هو الحق… وبينه في التلويح والمقاصد بأن من الأوضاع ما هو معلوم بطريق التواتر كلفظ السماء والأرض، وكأكثر قواعد الصرف والنحو مما وضع لهيئات المفردات وهيئات التراكيب، والعلم بالإرادة يحصل بمعونة القرائن بحيث لا يبقى شبهة، كما في النصوص الواردة في إيجاب الصلاة والزكاة، وفي البعث إذا اكتفى فيه بمجرد السمع كقوله تعالى: (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم)،[3] ونفي المعارض العقلي حاصل عند العلم بالوضع والإرادة وصدق المخبر، وذلك لأن العلم بتحقق أحد المتنافيين يفيد العلم بانتفاء الآخر، على أن الحق أن إفادة اليقين إنما تتوقف على انتفاء المعارض وعدم اعتقاد ثبوته، لا على العلم بانتفائه، إذ كثيراً ما يحصل اليقين من الدلائل، ولا يخطر المعارض بالبال إثباتاً أو نفيا فضلاً عن العلم بذلك». انتهى.[4]
هذا هو تحقيق المسألة، وقد ظهر به أن ما ذهب إليه الرازي هو الحق الحقيق بالقبول، وأنه قد وافق في ذلك متقدمي الأشاعرة، وقد وافقه عليه الآمدي صاحب “الأبكار”، والسعد التفتازاني صاحب “المقاصد والتلويح”. أقول: وقد ذهب إلى هذا الرأي إمام الحرمين والغزالي. وانظر “التلخيص” لإمام الحرمين «فصل القول في تقسيم الخطاب وما يفيده»[5] و”المستصفى” للغزالي «فصل الكلام المفيد»،[6] و«فصل طريق فهم المراد من الخطاب».[7]
وبهذا التحقيق ظهر مدى صحة نسبة الدكتور سفر الرأي الذي أشار إليه بإطلاقه إلى متكلمي الأشاعرة وإلى من ذكرهم في فقرة (أ)
وذلك لأن سياق كلامه يدل على أنه يقصد أن الأشاعرة يرون أن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة، ولا يفيد اليقين قطعا لأنها لا تسلم من المعارضات المذكورة أو من بعضها، مع أنهم قد قالوا: إنها تفيد اليقين إذا اقترن بها قرائن تفيد اليقين والقرائن لا تدخل تحت الضابط والحصر، وأما إذا كان مراد الدكتور الإنكار على الأشاعرة مع هذه الضميمة التى بها يكتمل مذهبهم، فلا ريب أن هذا الإنكار غير صحيح.
وظهر أيضا خطأ قوله: وسلمت بعد هذا من المعارض العقلي. فإن المعارض العقلي داخل في العشرة وواحد منها. وكلامه يفيد أنه خارج عنها.
28- تحقيق مسألة حجية خبر الواحد في العقيدة وكلام الرازي في ذلك
قال الدكتور: {ج- موقفهم من السنة خاصة أنه لا يثبت بها عقيدة. بل المتواتر منها يجب تأويله، وآحادها لا يجب الاشتغال بها حتى على سبيل التأويل، حتى إن إمامهم الرازي قطع بأن رواية الصحابة كلهم مظنونة بالنسبة لعدالتهم وحفظهم سواء. وأنه في الصحيحين أحاديث وضعها الزنادقة… إلى آخر مالا استجيز نقله لغير المختصين، وهو في كتابيه أساس التقديس والأربعين}
أقول: قد احتوى كلام الدكتور أيضا –على عادته- على مجموعة من الأخطاء الجسيمة:
الأول: نسبته إلى الأشاعرة أن السنة لا يثبت بها عقيدة عندهم.
ومن اجل أن المسألة من أهم المسائل في حد ذاتها، ومن أجل كونها من أعظم المسائل التي انتقدت على الأشاعرة عن جهل بمذهبهم… من أجل ذلك تحتاج إلى تفصيل وتحقيق، ولقد فصلنا الكلام فيها في كتابنا “السنة النبوية حجية وتدوينا”, فننقل ما كتباه هناك، ثم نعقبه ببيان ما في كلام الدكتور فيها من أخطاء فنقول:
{مدى حجية خبر الواحد في العقيدة}
العمل بخبر الواحد في الأحكام العملية مما أجمع عليه علماء الأمة ولم يخالف فيه أحد من علماء الإسلام من حيث إنه خبر واحد، والمقصود هنا الكلام على العمل بخبر الواحد في المسائل الاعتقادية، فإنه قد طال كلام العلماء حول هذه المسألة، ولم أر أحداً حقق المسألة وحررها على الوجه المرضي، فنقول وبالله التوفيق:
قد شاع بين علماء الكلام أن خبر الواحد ليس بحجة في المسائل الاعتقادية، والجمهور الأعظم من العلماء على أنه حجة فيها.
وتحقيق المسألة يحتاج إلى تفصيل: وهو أن مسائل الاعتقاد منقسمة إلى خمسة أقسام:
1-ما يكون عدم العلم به موجبا للكفر مثل وجوده تعالى ووحدانيته وصفاته الذاتية.
2-ما يكون إنكاره موجبا للكفر وعدم العلم به موجبا للإثم، مثل قدم الباري تعالى وحدوث ما عداه من العالم، فإن الإنسان بعد اعتقاده بوجود الله تعالى ووحدانيته وصفاته الذاتية لو لقي الله تعالى خالي الذهن عن الحدوث والقدم في حقه تعالى وفي حق العالم، يكون مسلما، لكنه آثم بعدم العلم به، فيجب عليه أن يعتقد القدم في حقه تعالى والحدوث في العالم كي لا يعتقد العكس عند دخول المسألة تحت ملاحظته فيقع في الكفر.
ومن هذا القبيل معظم العقائد الثابتة بالدلائل القطعية الثبوت القطعية الدلالة من الكتاب والسنة المتواترة مما قد يخفى على بعض العوام. وهذا القسم من العقائد لا يصح الاستدلال عليه بخبر الواحد لأن المطلوب فيها اليقين وخبر الواحد مفيد للظن.
على أن هذا القسم من أجل ثبوته بالدلائل القطعية من الكتاب والسنة المتواترة لا حاجة في إثباته إلى أخبار الآحاد.
3- ما يكون إنكاره بدعة غليظة وجهله إثما وذلك ما هو ثابت بظواهر الكتاب والسنة المتواترة أو المستفيضة مما تلقته الأمة على ظاهره بالقبول، فهذا إنكاره بصرف النصوص عن ظواهرها وتأويلها على خلاف ما تلقاه السلف بالقبول بدعة غليظة، وربما يكون كفرا إذا كان ما تلقته الأمة بالقبول مجمعاً عليه معلوما من الدين بالضرورة.
4- ما يكون إنكاره إثماً وبدعة خفيفة وجهله معفواً عنه، وذلك ما ثبت بالآحاد الصحيحة غير المستفيضة مما يخفى على أكثر العوام وعلى بعض الخواص مما لم تتعارض فيه الدلائل المتكافئة من الكتاب والسنة.
5- ما تعارضت فيه الدلائل المتكافئة – بحسب الظاهرة – من الكتاب والسنة ومن أجل ذلك وقع فيها الاختلاف بين علماء الأمة.
فما كان من هذا القسم الأخير فأمره عفو بمعنى أنه لا يحكم فيه بحكم عام، بل هو من مسائل الاجتهاد والتقليد.
وهذا التفصيل لم نجده في كلام أحد من العلماء بهذا الوجه لكنه مقتضى الدلائل الشرعية ومأخوذ من تصريحات العلماء ونصوصهم.
وبهذا التفصيل نجمع بين الخلاف في خبر الواحد. هل هو حجة في مسائل الاعتقاد أم لا؟
فيحمل كلام من قال: إنه ليس بحجة على أن مخالفته وعدم اعتقاد مقتضاه ليس بكفر لأن ثبوته ليس بقطعي فلا تكون مخالفته رداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لعدم الوثوق بالرواة، إلا أن يكون رده بعد اعتقاد أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بدون تأويل له، فرده حينئذ كفر، ولا أعلم أنه يخالف ما قلناه أحد من العلماء، فإنا نرى المتكلمين الذين نسب إليهم عدم الاستدلال بخبر الآحاد في العقائد كثيراً ما يستدلون به فيها، ولا سيما في قسم السمعيات من العقائد، كما لا يخفى على من له إلمام بكلامهم.
قال عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى في «ظفر الأماني»([8]):
قد صرحوا بأن أخبار الآحاد وإن كانت صحيحة لا تكفي في باب العقائد، فما بالك بالضعيفة منها، والمراد بعدم كفايتها أنها لا تفيد القطع، فلا يعتبر بها مطلقا في العقائد التي كلف الناس بالاعتقاد الجازم فيها، لا أنها لا تفيد الظن أيضا، ولا أنها لا عبرة بها رأسا في العقائد مطلقا، كما توهمه كثير من أبناء عصرنا. ثم قال. قال التفتازاني في شرح. المقاصد في بحث عصمة الملائكة: وما يقال إنه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقاد فإن أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم، ولا يصح الحكم القطعي به فلا نزاع فيه، وإن أريد أنه لا يحصل الظن بذلك الحكم فظاهر البطلان، انتهى.
فهذا التفتازاني وهو من أئمة الكلام صرح بما قلته.
ويحمل كلام من قال إنه حجة على أنه – بعد ثبوت صحته بدون معارض ولا صارف له عن ظاهره – يجب اعتقاد مقتضاه على وجه الظن أو على وجه العلم إذا كان مقرونا بقرائن يفيد معها العلم.
وأن عدم اعتقاد مقتضاه بعد العلم به وبصحته وعدم اقترانه بقرائن يفيد معها العلم موجب للإثم والبدعة، وهذا أيضا مما لا أظن أن أحداً من العلماء يخالف فيه.
ثم إنه مما ينبغي التنبيه عليه أن أصول العقائد مثل التوحيد، وصفات الله. والرسالة، والبعث، وجزاء الأعمال، والجنة والنار، قد تكفل القرآن ببيانها، وركز على بيانها أكبر تركيز، وفصَّل القول فيها وكرره وأوردها مقرونة بدلائلها العقلية التي تضطر العقول إلى قبولها والجزم بها.
وما ورد من الأحاديث في بيانها فإنما هي مؤيدة للقرآن ومقررة له أو موضحة ومفصلة له أو من جزئيات ما ورد فيه.
فلم يبق من العقائد ما يكون العمدة في الاستدلال عليه أخبار الآحاد إلا العقائد التي ليست من الأصول، وهي التي لا يكون اعتقاد ما يخالفها موجباً للكفر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد اتضح بهذا التحقيق موقف الأشاعرة من الاستدلال بالسنة وبخبر الواحد منها، كما اتضح أن ما نسبه الدكتور إليهم من أن السنة لا يثبت بها عقيدة عندهم.. غير صحيح.
أما كلام الإمام الرازي في المسألة فقد قال في «أساس التقديس»[9] أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله فغير جائز، يدل عليه وجوه: الأول: أن أخبار الآحاد مظنونة فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته، وإنما قلنا: إنها مظنونة، وذلك لأنا أجمعنا على أن الرواة ليسوا بمعصومين … إلى آخر كلامه.
فالإمام قال: إن خبر الواحد لا يتمسك به في معرفة الله وصفاته، ولم يقل لا يتمسك به في العقيدة مطلقا. وذلك لأن من العقائد ما يطلب فيه القطع واليقين ولا يكتفي فيه بالظن، وهي أصول العقائد الإسلامية وفي مقدمتها معرفة الله تعالى وصفاته. وهذا القسم من العقيدة لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدلائل المفيدة للقطع واليقين، ولا يصح الاستدلال عليها بالدلائل المفيدة للظن. ومنها خبر الواحد إذا لم يقترن بقرائن يفيد معها العلم، وهذا القسم من العقائد هو الذي يكون جهله وعدم العلم به موجبا للكفر، أو لا يكون جهله موجبا للكفر لكن يكون اعتقاد ضده موجبا للكفر كما قدمناه آنفا.
والقسم الثاني من العقائد ما يكتفي فيه بالظن ولا يطلب فيه القطع واليقين، وهو ما ليس من الأصول في العقيدة، وهذا القسم لا يكون جهله أو اعتقاد ضده موجبا للكفر، بل يكون اعتقاد ضده موجبا للإثم والبدعة. وهذا القسم من العقائد يستدل عليه بالدلائل المفيدة للظن، ومنها خبر الواحد هذا هو معنى كلام الإمام الرازي: «أن أخبار الآحاد مظنونة فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته».
وأما قطع الإمام الرازي بأن رواية الصحابة كلهم مظنونة وأنها لا تفيد القطع واليقين فقد قصد بها الرواية التي وردت آحاداً ولم يقترن بها من القرائن ما تفيد معها العلم، يدل على هذا سياق كلامه، فإن كلامه في أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد من حيث هي أخبار آحاد مظنونة لا تفيد القطع واليقين. وهذا ما لا يخالف فيه أحد من أئمة المسلمين وعلمائهم إلا النزر القليل، وقد استدل الإمام على ذلك بطعن الصحابة بعضهم في بعض ورد بعضهم رواية البعض الآخر لأسباب اقتضت ذلك. وهو استدلال صحيح لا غبار عليه.
[1] وانظر نفائس الأصول في شرح المحصول 2/39-44 والأربعين 416-418.
[2] نفائس الأصول 2/51
[3] يسن 79
[4] إشارات المرام 46-47.
[5] صـ34-35.
[6] 1/333.
[7] المستصفى 1/337.
([8] ) (222-223)
[9] 168