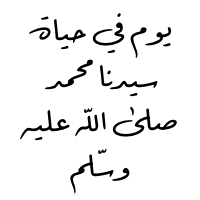التقسيم الثلاثي للتوحيد بين الأشاعرة وابن تيمية
37 – التقسيم الثلاثي للتوحيد بين الأشاعرة وابن تيمية
بسم الله الرحمن الرحيم
قسم الأشاعرة التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الذات، و توحيد الصفات، وتوحيد الأفعال.
وكذلك قسم ابن تيمية التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومقصدنا في هذا البحث أن نبين أن أيُّ التقسيمين أقرب إلى الصواب، وأولى بالقبول.
فننقل أولا كلام الأشاعرة في التوحيد وأقسامه، ثم ننقل كلامهم على الكفر وأسبابه وأقسامه، وبعد ذلك ننثنِّي على تقسيم ابن تيمية للتوحيد ونتكلم عليه، فنقول:
قد قسم الأشاعرة التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال. قال كمال الدين ابن أبي شريف في المسامرة شرح المسايرة: التوحيد هو اعتقاد الوحدانية في الذات والصفات والأفعال[1]. أي إنه ثلاثة أقسام: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال.
وقد يختصر الأشاعرة: فيقولون: التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الإ̃لهية وخواصها. قال سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد[2]:
حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الإلهية وخواصها، ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير العالم، وخلق الأجسام، واستحقاق العبادة، وقدم ما يقوم بنفسه، كلها من الخواص…
وبالجملة فنفي الشريك في الإلهية ثابت عقلاً وشرعا، وفي استحقاق العبادة شرعا (وما أمروا إلا ليعبدوا إ̃لها واحدا لا إ̃له إلا هو سبحانه عما يشركون)[3]
وقال ابن الهمام في المسايرة: «لما ثبت وحدانيته في الإ̃لهية ثبت استنادُ كل الحوادث إليه»
وقال ابن أبي شريف في شرحه: الإ̃لهية الاتصاف بالصفات التي لأجلها استحق أن يكون معبودا، وهي صفاته التي توحد بها سبحانه، فلا شريك له في شيء منها، وتسمى خواص الإ̃لهية، ومنها الإيجاد من العدم وتدبير العالم والغنى المطلق[4]
وقال أيضا: «واعلم أن الوحدة تطلق بمعنى انتفاء قبول الانقسام، وبمعنى انتفاء الشبيه، والباري تعالى واحد بكل من المعنيين أيضا. أما الأول: فلتعاليه عن الوصف بالكمية والتركيب من الأجزاء والحد والمقدار. وأما الثاني: فحاصله انتفاء المشابه له تعالى بوجه من الوجوه».[5]
وأما كلام الأشاعرة على الكفر وأسبابه وأقسامه فننقل فيه كلام ابن الهمام في المسايرة مع شرحه لابن أبي شريف وذلك لما اشتمل عليه كلامهما من بيانات تتعلق بموضوع التوحيد والشرك، ومن الاستدلال على وجود الله تعالى بالأدلة القرآنية وبشهادة الفطرة. وابن الهمام وإن كان حنفي المذهب لكنه جار على منهج الأشاعرة في العقيدة، وأما كمال الدين ابن أبي شريف فهو شافعي أشعري. وإليك كلامهما:
(الأصل الأول العلم بوجوده) تعالى، وأولى ما يستضاء به من الأنوار، ويسلك من طرق الاعتبار ما اشتمل عليه القرآن، فليس بعد بيان الله تعالى بيان ( وقد أرشد سبحانه إليه) أي إلى وجوده تعالى (بآيات نحو) قوله تعالى: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. و) نحو (قوله): ( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. و) قوله تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما) أي متحطما وهو المتكسر ليبسه (و) قوله تعالى (أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن) أي: السحاب (أم نحن المنزلون) لو نشاء جعلناه أجاجا. أي شديد الملوحة لا يمكن ذوقه (و) قوله تعالى: ( أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون)[6]
فمن أدار نظره في عجائب تلك المذكورات من الأرضين والسماوات وبدائع فطرة الحيوان والنبات، وسائر ما اشتملت عليه الآيات (اضطره) ذلك (إلى الحكم بأن هذه الأمور مع هذا الترتيب المحكم الغريب لا يستغنى كل) منها ( عن صانع أوجده) من العدم (وحكيم رتبه) على قانون وضع فيه فنونا من الحكم (وعلى هذا درجت كل العقلاء إلا من لا عبرة بمكابرتهم) وهم بعض الدهرية.
(وإنما كفروا بالإشراك) حيث دعوا مع الله إلها آخر. (ونسبة) أي بنسبة (بعض الحوادث إلى غيره تعالى وإنكار) أي وبإنكار (ما جعل الله تعالى إنكاره كفرا كالبعث وإحياء الموتى).
ومثل المصنف للذين أشركوا بقوله: (كالمجوس بالنسبة إلى النار) حيث عبدوها، فدعوها إلها آخر، تعالى الله عن ذلك (والوثنيين بالأصنام) أي بسببها فإنهم عبدوها. (والصابئة بالكواكب) أي بسبب الكواكب حيث عبدوها من دون الله تعالى.
وأما نسبة الحوادث إلى غيره تعالى فالمجوس ينسبون الشر إلى أَهْرَمَنْ، والوثنيون ينسبون بعض الآثار إلى الأصنام كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: (إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء)، والصابئون ينسبون بعض الآثار إلى الكواكب، تعالى الله عما يشركون.
(واعترف الكل بأن خلق السماوات والأرض والألوهية الأصلية لله تعالى. قال الله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله) (فهذا) أي الاعتراف بما ذكر (كان) ثابتا (في فطرهم) من مبدأ خلقهم، قد جبلت عليه عقولهم. قال الله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون)
(ولذا) أي لكون الاعتراف بما ذكر ثابتا في فطرهم (كان المسموع من الأنبياء)-المبعوثين عليهم أفضل الصلاة والسلام- (دعوة الخلق إلى التوحيد) والمراد به هنا اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها كتدبير العالم، واستحقاق العبادة، وخلق الأجسام، بدليل أنه بين التوحيد بقوله: (شهادة أن لا إله إلا الله، دون أن يشهدوا أن للخلق إلها) لما مر من أن ذلك كان ثابتا في فطرهم، ففي فطرة الإنسان وشهادة آيات القرآن ما يغنى عن إقامة البرهان. انتهى كلام المسايرة مع شرحها المسامرة.[7]
هذا هو كلام الأشاعرة في التوحيد وفي الشرك حيث فسروا التوحيد باعتقاد الوحدانية لله تعالى في الذات والصفات والأفعال، أَيُّ باعتقاد أنه لا يوجد ذات مثل ذاته، ولا يوجد لغيره صفات مثل صفاته، وأنه المتفرد بخلق الأشياء وإيجادها وليس لغيره أي دخل في خلق الأشياء وإيجادها.
وبعبارة أخرى: التوحيد: اعتقاد عدم الشريك في الإ̃لهية وخواصها. والإ̃لهية هي الاتصاف بالصفات التي لأجلها استحق المتصف بها أن يكون معبودا.
وهذه الصفات هي المسمات بخواص الإ̃لهية، وهي خلق العالم، وتدبيره واستحقاق العبادة، والتفرد بحق التشريع، والغنى المطلق عن غيره.
وقد يعبرون عن هذا التوحيد بنفي التشبيه أي: اعتقاد أنه لا مشابه له تعالى بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)
هذا هو معنى التوحيد، وهو الذي به بعثت الأنبياء، ويقابله الشرك، وهو اعتقاد الشريك لله تعالى في ذاته، أو في صفاته أو في أفعاله.
وبعبارة أخرى هو اعتقاد الشريك في الإ̃لهية وخواصها أو في شيء من خواصها.
وبعبارة أخرى هو اعتقاد المشابه لله تعالى في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله.
وقد يطلق التوحيد على نفي قبول الانقسام لتعاليه تعالى عن الوصف بالكمية والتركيب من الأجزاء والحد والمقدار.
هذا حاصل كلام الأشاعرة في التوحيد والشرك، وهو كلام دقيق محقق لا غبار عليه.
وأما التقسيم الثلاثي للتوحيد الذي قرره ابن تيمية فنتكلم عليه بشيء من التوسع ونبدأ أولا بالكلام على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
وقبل الخوض في ذلك نتكلم على كلمتي الربوبية والألوهية. فنقول وبالله التوفيق:
الربوبية: اسم موضوع للدلالة على الصفات التي يتصف بها الرب الخالق جل وعلا أي الصفات التي يقتضيها كونه تعالى ربا.
والرب: في الأصل مصدر رَبّ يَرُبُّ، يقال: رَبَّ فلانٌ الولدَ أو الصبيَ أو المهرَ يَرُبًُّهُ ربا، كما يقال: رباه يربيه تربية، والتربية –كما يقولون- تبليغ الشيء إلى الكمال شيئا فشيئا.
ثم نقلت كلمة الرب من معنى المصدر إلى معنى المربي، ثم توسع في معناها فأطلقت على السيد والأمير، ومالك الشيء، والمنعم إلى غير ذلك من المعاني القريبة لأصل معناه.
ولما كانت التربية الحقيقية لكل المخلوقات بخلقها ابتداء، وإمدادها بالبقاء ورعايتها وتنميتها، صفة من صفات الرب جل وعلا، كان سبحانه هو رب العالمين، ورب كل شيء، فالربوبية هي الوصف الجامع لكل صفات الله ذات العلاقة والأثر في مخلوقاته واسم الرب هو الاسم الدال على كل هذه الصفات.
وأما كلمة الألوهية فبمعنى العبادة، ويقال فيها: أُلْوُهَةً وإِ̃لهة، وقال أهل اللغة: التأَلُّه هو التعبد والتنسك، والتأليه هو التعبيد، وقالوا: إ̃له على وزن فِعال هو بمعنى مفعول، أي: مألوه بمعنى معبود، سواء كان معبوداً بحق أم بباطل، فالإ̃له هو المعبود.(انظر لسان العرب والقاموس المحيط)
فظهر من هذا أن الألوهية بمعنى العبادة، وليس بمعنى الكون إلها، وأن إطلاقه على هذا المعنى في كلام كثير من العلماء لحن، وإنما الذي يصح إطلاقه على هذا المعنى هو كلمة “الإ̃لهية” مصدر جعلي من كلمة الإ̃له، وهو الذي استعمله المحققون من العلماء، فمعنى لا إ̃له إلا الله لا معبود بحق إلا الله، بمعنى لا متصف بالصفات التي لأجلها استحق أن يكون معبودا إلا الله، وهذه الصفات هي المسماة بخواص الإ̃لهية، وهي خلق العالم وتدبيره وتربيته أي تبليغه إلى الكمال شيئا فشيئا، والغنى المطلق عن غيره، وافتقار ما سواه إليه وتفرده بحق التشريع، ويتفرع عن هذه الصفات وينبني عليها استحقاق العبادة.
فظهر من هذا أن توحيد الإلهية أي إفراد الله تعالى بالعبادة متفرع عن توحيد الربوبية ومنبنٍ عليه وملازم له، فالناس إنما يعبدون من يعتقدون فيه الربوبية سواء اعتقدوا فيه ربوبية كبيرة مطلقة، وهذا ما أثبته المتألِّهون لله تعالى، أم اعتقدوا فيه ربوبية محدودة صغيرة مستمدة من الرب الأكبر، وهذا ما كان يعتقده في معبوديهم معظم أصناف الذين كانوا يعبدون إ̃لها أو آلهة من دون الله، فإن معظمهم كانوا يعبدونهم بناء على اعتقادهم أن الله تعالى قد فوض إليهم التصرف في بعض الأمور، وتخلى لهم عنها، بمعنى أن الله تعالى قد خولهم ربوبية صغيرة محدودة فاستحقوا بذلك أن يُعْبَدُوا استعطافا لرحمتهم، وابتعادا عن غضبهم وسخطهم. فمن أجل أنهم اعتقدوا فيهم الربوبية اعتقدوا فيهم الإلهية.
والذين يعبدون من دون الله إ̃لها أو آلهة أصناف:
الصنف الأول: هم الذين تحدث الله عنهم بقوله: (ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار)[8]
فهذا الصنف من المشركين يؤمنون بالله تعالى، ولا يعتقدون فيما يعبدونه من دون الله مشاركة لله لا في الخلق ولا في التصرف في أحوال أهل الأرض من رزق وصحة وحمل وولادة وكون الجنين ذكرا أو سليما، ونحو ذلك.
وإنما يعتقدون فيهم أن الله تعالى قد جعلهم وسطاء بينه وبين عباده، وأنه لا يتم تقرب العبد إلى الله تعالى إلا بواسطتهم، وعن طريق تقريب هذا الوسيط لهم إلى الله تعالى
والصنف الثاني: هم الذين تحدث الله تعالى عنهم بقوله: (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعائنا عند الله قل أتنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون)[9]
فهذا الصنف من المشركين لم يكونوا يعبدون آلهتهم لأجل أن تنفعهم في أمور دنياهم ولا لأجل أن لا تضرهم فيها، بل كانوا يعبدونهم لأنهم كانوا يعتقدون في آلهتهم أنهم يملكون الشفاعة عند الله بدون إذن من الله، أو أن الله قد خولهم هذا التصرف الخاص وهو التصرف في الشفاعة، وأنهم يتصرفون في الشفاعة على حسب ما يشاءون لا على حسب ما يشاء الله تعالى.
وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله تعالى: (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون)[10] فرد الله تعالى عليهم بأمرين: الأول: أنهم لا يملكون شيئا لا الشفاعة ولا غيرها. وهذا رد على اعتقادهم أنهم يملكون الشفاعة عند الله بدون إذن من الله، فإن الملك يقتضى تصرف صاحبه فيما ملكه بدون إذن من أحد. والأمر الثاني: أن الشفاعة كلها لله فما من شافع يشفع إلا بإذنه، وليست الشفاعة وحدها لله، بل له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون، فيفصل بينكم ويجازيكم على عقائدكم، وأعمالكم.
فالمشركون من هذا الصنف كانوا يعتقدون في آلهتهم ملك الشفاعة والتصرف فيها حسب ما شاءوا لا حسب ما شاء الله، وكان المشركون يعبدونهم استعطافا لهم وجلبا لرحمتهم أن يشفعوا لهم عند الله.
والصنف الثالث من المشركين: كانوا يعتقدون في آلهتهم النفع والضر، وإنها تجلب لهم الخيرات وتدفع عنهم البلايا وتنصرهم على أعدائهم، ويعتقدون أن الله تعالى قد خولهم هذه الربوبية الصغيرة، كما يولي الملوك الولاة على المناطق الصغيرة، فكان هذا الصنف يعتقدون في آلهتهم هذه الربوبية الصغيرة ومن أجل ذلك كانوا يعبدونهم ويألِّهونهم.
وقد ذكر الله تعالى هذا الصنف بقوله: (واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون)[11] وقوله تعالى: (واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا)[12] أي واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها لتجازيهم على عبادتهم بأن تكون بتأثيراتها الغيبية سببا لعزهم وغلبتهم على أعدائهم.
وهذه الأنواع الثلاثة من الشرك هي التي كان عليها معظم المشركين من العرب في جاهليتهم. وربما كانوا يعتقدون في آلهتهم مجموع هذه المعاني الثلاثة أو اثنين منها.
والصنف الرابع من المشركين: كانوا يعطون حق التشريع الذي هو خاص بالله تعالى لغيره من الأحبار والرهبان، وقد ذكر الله تعالى هذا الصنف بقوله: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)[13] وأشار إليه بقوله: (ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله )[14] فأعطى هذا الصنفُ من المشركين الأحبارَ والرهبانَ حقَ التشريع وهو من صفات الربوبية وخواصها، فاتخذوهم بذلك أربابا، ثم أطاعوهم فيما شرعوا من الأحكام، وبذلك كانوا قد عبدوهم وألهوهم؛ فإن الإطاعة في التشريع نوع من العبادة.
والصنف الخامس: هم الذين يعتقدون فيمن يعبدونهم أنهم شركاء لله في تدبير العالم والتصرف فيه. وهؤلاء أصناف كثيرة، فمنهم أهل التثنية وأهل التثليث ومنهم من يعددون الآلهة فوق ذلك.
وأهل هذا الشرك لهم أرباب يجعلونها مشتركة فيما بينها في الربوبية وتصاريفها في الكون، وقد يجسدونها في أجسام مادية، أو يعتقدون أنها قد تحل في أجسام مادية، أو تظهر بصور بشرية.
وهذه الأصناف الخمسة من المشركين هم الذين كانوا يعبدون آلهة من دون الله عن اقتناع، وكانوا يألِّهونها بناء على اعتقادهم فيها الربوبية إما ربوبية صغيرة محدودة مستمدة من ربوبية الله تعالى كما هو حال الأصناف الأربعة الأول، وهو حال معظم مشركي العرب في جاهليته، أو ربوبية حقيقية كبيرة كما هو حال الصنف الخامس.
الصنف السادس من المشركين: ناس كانوا لا يعتقدون في معبوداتهم شيئا من معانى الربوبية، فلم يكونوا يعبدونها عن عقيدة واقتناع، بل كانوا يعبدونها ويألِّهونها بناء على مصلحة اجتماعية وهو الحفاظ على الوحدة القومية، وعدم تفريق الكلمة فيها، حيث كانت آلهتهم التي يعبدونها ويقدسونها بمثابة رموز رباط وحدة قومية، تجمع أفرادهم على مودة تسوقوهم على التعاون والتناصر وعلى كل ما تقتضيه الأخوة بين جماعة ذات كيان واحد.
وهذا ما كشفه إبراهيم عليه السلام لقومه. قال الله تعالى في معرض ذكر لقطات من قصة إبراهيم وقومه: (وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين) العنكبوت 25.
من هذا التصنيف للمشركين، ومما تقدم سرده من النصوص القرآنية، وهي غيض من فيض وقليل من كثير من النصوص المتعلقة بالموضوع، من هذا ظهر لنا أن الربوبية هي الأساس الذي تنبني عليه الإ̃لهية، فمن كانت له الربوبية فمن حقه على مربوبيه أن يؤلهوه، وظهر أن المشركين الذين كانوا يعبدون من دون الله آلهة عن عقيدة واقتناع إنما كانوا يعبدونهم ويألِّهونهم بناء على اعتقادهم فيهم الربوبية إما ربوبية صغيرة محدودة أو ربوبية أصلية مطلقة.
ومن هذا ظهر خطأ الذين يرون أن جميع العرب في جاهليتهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية لله عز وجل، إلا أنهم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى فيتخذونها شركاء لله في إ̃لهيته دون أن يجعلوها شركاء لله في ربوبيته.
وذلك لأن النصوص القرآنية ومنها ما أوردناه آنفا تبين أن أكثر العرب كانوا يجعلون مع الله شركاء في بعض صفات ربوبيته لا في كلها، ومن أجل ذلك كانوا يطلبون من شركائهم الرحمة والرزق والنصر، وكثيرا من مطالبهم الدنيوية، وكانوا يعبدون آلهتهم طمعا في أن يحققوا لهم ما يرجون بمعونات غيبية هي من خصائص الرب الخالق الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
ولما كانت الإ̃لهية هي اللازم العقلي المباشر للربوبية، وكانت الربوبية في الوجود كله لله وحده لا شريك له فيها وجب عقلا وجوبا حتميا أن تكون الإ̃لهية خاصة بالله وحده لا يشاركه فيها أحد.
ومن أجل هذه الحقيقة كان منهج القرآن الكريم للإقناع بتوحيد الإ̃لهية لله وحده لا شريك له، يعتمد على تذكير ذوى الفكر بتوحيد الربوبية لله عز وجل، وأنه لا شريك له في الربوبية، و على تنبيههم على هذه الحقيقة، ويعتمد في بعض النصوص على استئناف عرض أدلة تثبت أن الربوبية في الوجود كله لله وحده لا شريك له، ويراعي في هذا التنويع مقتضيات أحوال المخاطبين إبّان نزول النص.
من هذه النصوص القرآنية ما يلي: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم)[15] (وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون)[16] (رب السموات والأرض وما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا)[17] (واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا)[18] (يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون)[19] (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السموات والأرض)[20] (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس)[21] جاء البيان في هذه السورة مرتبا ترتيبا عقليا منطقيا، فإثبات ربوبية الله للناس يلزم منه لزوما عقليا منطقيا إثبات كونه مالكا لهم فهم عبيده وكونه ملكا عليهم، ويلزم منهما لزوما عقليا منطقيا إثبات إ̃لهيته لهم، وبما أنهم لا رب لهم غيره فلا إ̃له لهم غيره.
والحاصل أنه قد استقر في عقول بني آدم أن من ثبتت له الربوبية فمستحق للعبادة، ومن انتفت عنه الربوبية فهو غير مستحق للعبادة، فثبوت الربوبية واستحقاق العبادة متلازمان فيما شرع الله من شرائعه، وفي عقول الناس.
وعلى أساس اعتقاد الشركة في الربوبية بنى المشركون استحقاق العبادة لمن اعتقدوهم أربابا من دون الله تعالى، ومتى انهدم هذا الأساس من نفوسهم تبعه انهدام ما بني عليه من استحقاق غير الله للعبادة، ولا يسلم المشرك بإنفراد الله سبحانه باستحقاق العبادة حتى يسلم بإنفراده عز وجل بالربوبية، وما دام في نفسه اعتقاد الربوبية لغيره عز وجل استتبع ذلك الاعتقاد في هذا الغير الاستحقاق للعبادة.
ولذلك كان من الواضح عند أولى الألباب أن توحيد الربوبية وتوحيد الإ̃لهية متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لا في الاعتقاد ولا في الوجود، وكان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بناء على انفصال أحدهما عن الآخر وعدم التلازم بينهما من الخطأ الواضح، فإنه من اعترف أنه لا رب إلا الله كان معترفا بأنه لا يستحق العبادة غيره، ومن أقر بأنه لا يستحق العبادة غيره كان مذعنا بأنه لا رب سواه. وهذا معنى لا إله إلا الله في قلوب جميع المسلمين.
ولذلك نرى القرآن في كثير من المواضع يكتفي بأحدهما عن الآخر، ويرتب اللوازم المترتبة على انتفاء أحدهما على انتفاء الآخر ليستدل بذلك على ثبوته، فانظر إلى قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)[22] وقوله تعالى: (وما كان معه من إ̃له إذا لذهب كل إ̃له بما خلق ولعلا بعضهم على بعض)[23] حيث رتب على تعدد الإ̃له ما يترتب على تعدد الرب من فساد السموات والأرض ليثبت بذلك عدم تعدد الرب ووحدانيَتَهُ.
هذا وقد اشتمل تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإ̃لهية على أخطاء:
الأول: تخصيص الربوبية بالخالقية مع أنها تشمل كل خصائص الإ̃لهية وهي الصفات التي من أجلها استحق الرب أن يكون معبودا من خلق العالم وتدبيره وتصريفه وحق التشريع والغنى المطلق عن غيره.
الثاني: التعبير عن الكون إ̃لها بالألوهية فإن الألوهية هي العبادة والتعبير الصحيح عن الكون إ̃لها هو الإ̃لهية، وليس الألوهية.
الثالث: ادعاء أن توحيد الربوبية منفصل عن توحيد الإ̃لهية وغير ملازم له، يتحقق توحيد الربوبية مع الشرك في الإ̃لهية، وقد حققنا أنه ملازم له.
الرابع: ما بنى صاحب هذا التقسيم عليه من أن المشركين من العرب كانوا في جاهليتهم يوحدون الله تعالى توحيد الربوبية، ولكنهم لم يكونوا يوحدونه توحيد الإ̃لهية.
والخطأ الخامس: وهو الأدهى والأمر، وهو الذي كان يهدف إليه صاحب التقسيم، هو حكمه على كثير من المسلمين بمثل ما حكم به على المشركين من العرب في جاهليتهم الجهلاء. وبنائه هذا على التقسيم المذكور.
فظهر بهذا خطأ هذا التقسيم وخطأ ما بناه عليه صاحبه.
وأما التقسيم الصحيح للتوحيد فهو تقسيم الأشاعرة، وهو تقسيم التوحيد إلى توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما ثالث الأقسام من التقسيم الثلاثي وهو «توحيد الأسماء والصفات» فقد قصد به صاحب التقسيم أن يثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه بدون إهمال شيء مما أثبته لنفسه بأن ينفي عن الله تعالى بعض ما أثبته لنفسه، ولا أن يزاد عليها بأن يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات ما لم يثبت إطلاقه على الله تعالى في الكتاب والسنة الصحيحة. هذا هو الذي قرره صاحب التقسيم وسماه «توحيد الأسماء والصفات».
أما تقرير المسألة فهو تقرير غير محرر أدى عدم تحرير التقرير بصاحبه إلى أخطاء عقدية جسيمة.
والتحرير أن يقال: يجب أن يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات ما ورد إطلاقه على الله تعالى في الكتاب والسنة الصحيحة مما كان إطلاقه عليه تعالى على وجه الحقيقة دون المجاز والكناية، وتحرير المسألة بهذا الوجه ثم تطبيقها على نصوص الكتاب والسنة تطبيقا صحيحا هو الذي يقي الوالج في المسألة من الخطأ، ويجنبه الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، وأما عدم تحرير المسألة أو تحريرها ثم تطبيقها على النصوص تطبيقا غير صحيح فيورط صاحبه في الأخطاء العقدية الجسيمة، وفي الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. وهذا ما تورط فيه صاحب التقسيم الثلاثي.
وبعد هذه المقدمة نقول: قد تورط صاحب التقسيم الثلاثي بالنسبة إلى القسم الثالث في أخطاء.
الخطأ الأول: في العنوان حيث عنون المسألة بتوحيد الأسماء والصفات، وإنما المسألة مسألة إثبات الأسماء والصفات. وقد عبر بهذا التعبير في كتابه منهاج السنة.
الثاني: عدم تحرير تقرير المسألة.
الثالث: أن صاحب التقسيم لم يثبت لله تعالى كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة إطلاقه على الله تعالى مما هو داخل تحت القاعدة غير المحررة. وذلك مثل النسيان الوارد في قوله تعالى: (نسوا الله فنسيهم) وكذلك ورد في الأحاديث الصحيحة إثبات الهرولة والضحك والمرض والجوع لله تعالى، ولم يثبتها صاحب التقسيم لله تعالى، وذلك من أجل اعتقاده أن هذه الإطلاقات إنما وردت على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة بسبب اعتقاده استحالة ثبوت هذه الأمور لله تعالى على سبيل الحقيقة، وهو اعتقاد صحيح.
الرابع: إن صاحب التقسيم قد أثبت لله تعالى أمورا لم يرد بها الكتاب ولا السنة حيث أثبت لله تعالى ما يلي:
الحد. انظر (موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) [24]
الجلوس على العرش قال في مجموع الفتاوى: حدث العلماء المرضيون والأولياء المتقون أن محمداً رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجلسه ربه على العرش معه…[25] وقد أشار إليه ابن القيم في بدائع الفوائد.[26]
يقول بجواز إطلاق أن الله تعالى جسم قال في التأسيس في رد “أساس التقديس” (وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم وأن صفاته ليست أجساما ولا أعراضا)[27] وسيأتي عن الإمام أحمد نفي الجسمية عن الله تعالى.
ويقول في كتابه التأسيس: ولو شاء –الله – لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم. والاستقرار من لوازم الجسمية.
ويقول في كتابه “بيان تلبيس الجهمية”:[28] ما نصه: (فاسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة، ولا في كلام أحد من الصحابة والتابعين) ومعنى هذا أن التشبيه ليس به بأس.[29] هذا ما يراه ابن تيمية مخالفا لقوله تعالى: (ليس كمثله شيء) وقوله: (ولم يكن له كفوا أحد) ومخالفا الأمة وسيأتي قريبا نقل جملة من أقوالهم في ذلك.
والخامس: وهو بيت القصيد من ذكر توحيد الأسماء والصفات، أن صاحب التقسيم قد أثبت لله تعالى أمورا ورد في الكتاب والسنة إطلاقها على الله تعالى على سبيل المجاز أو الكناية، فأثبتها لله تعالى على سبيل الحقيقة، فأدى به ذلك إلى التشبيه الذي لا يرى به بأسا، ويكون بذلك مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله ولسلف الأمة.
وننقل هنا مجموعة من أقوال علماء الأمة وأئمتها من السلف والخلف في نفي التشبيه عن الله تعالى.
فنقول: نقل الذهبي في عن الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: (أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل ومقاتل مشبه)[30] وذكر ابن جرير الطبري في تفسير سورة الإخلاص عن أبي العالية وغيره من السلف: (أن الله تعالى ليس له شبيه ولا مثيل)
ونقل الإمام البيهقي في كتابه مناقب الإمام أحمد عن الإمام أحمد ما نصه:
(أنكر أحمد على من قال بالجسم، وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف. والله سبحانه خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجيء في الشريعة ذلك فبطل) انتهى.وهذا الكلام بنصه وارد في ذيل طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى منسوبا إلى الإمام أحمد.[31]
وورد في ذيل طبقات الحنابلة في ذكر عقيدة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: «كان الإمام أحمد – رحمه الله – يقول: إن لله تعالى يدين وهما صفة له في ذاته، ليستا بجارحتين، وليستا بمركبتين، ولا جسم ولا من جنس الأجسام، ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق، ولا عضد ، ولا فيما يقتضى ذلك من إطلاق قولهم “يد” إلا ما نطق القرآن الكريم به، أو صحَّت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السنة فيه».[32]
وفي ذيل الطبقات أيضا «أن الإمام أحمد كان يقول: والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش».[33]
وقال الإمام الطحاوي في عقيدته التي هي بيان أهل السنة والجماعة باتفاق أهل السنة «وتعالى –أي الله- عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات».
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: ما نصه: «وليس معنى قول المسلمين إن الله على العرش هو أنه تعالى مماس له، أو متمكن فيه، أو متحيز في جهة من جهاته، لكنه بائن من جميع خلقه، وإنما هو خبر جاء به التوقيف، فقلنا به ونفينا عنه التكييف إذ (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»[34]
وقال الإمام ابن الجوزي في مجالسه في المتشابهات[35] «وليس الخلاف في اليد، وإنما الخلاف في الجارحة، وليس الخلاف في الوجه، وإنما الخلاف في الصورة الجسمية، وليس الخلاف في العين، وإنما الخلاف في الحدقة».
وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام: «ليس – الله – بجسم مصور، ولا جوهر محدود مقدر، ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه الأرضون والسموات، كان قبل أن كون المكان ودبر الأزمان، وهو الآن على ما عليه كان»[36]
وقال الحافظ العسقلاني: «ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محالاً على الله أن لا يوصف بالعلو، لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس».[37]
وقال أيضا عند شرح حديث النزول: «استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور، لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز، تعالى الله عن ذلك»[38]
وقال أيضا: «فمعتقد سلف الأمة وعلماء السنة من الخلف أن الله تعالى منزه عن الحركة والتحول والحلول، ليس كمثله شيء».[39]
فظهر بهذا التحقيق أن التقسيم الثلاثي للتوحيد الذي اخترعه ابن تيمية تقسيم فاسد في التعبير، وفاسد في مضمونه، وفاسد فيما قصد منه.
والتقسيم الصحيح للتوحيد هو تقسيم الثلاثي الذي ذكره الأشاعرة، وهو توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال.
أما توحيد الذات فمأخوذ من قوله تعالى: (قل هو الله أحد) وغيرها من الآيات، وأما توحيد الصفات فمأخوذ من قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) وقوله تعالى: (ولم يكن له كفواً أحد) وأما توحيد الأفعال فمأخوذ من قوله تعالى: (الله خالق كل شيء) وقوله: (والله خلقكم وما تعملون) إلى غيرها من الآيات الكريمة. والله تعالى أعلم بالصواب.
[1] 43.
[2] 3/27.
[3] التوبة 31.
[4] المسامرة 58.
[5] المسامرة 43.
[6] الواقعة 58-72.
[7] 15-16-17.
[8] الزمر 3.
[9] يونس 17-18.
[10] الزمر43-44.
[11] يس74-75.
[12] مريم81-82.
[13] التوبة31.
[14] آل عمران64.
[15] البقرة21.
[16] يس 22-25.
[17] مريم65.
[18] الفرقان3.
[19] الفاطر3.
[20] النمل25.
[21] الناس1-3.
[22] الأنبياء22.
[23] المؤمنون91.
[24]2/ 29.
[25] 4/374.
[26] 4/39.
[27] 1/101.
[28] 1/109.
[29] 1/568.
[30] سير أعلام النبلا 7/202
[31] 2/298.
[32] 2/294.
[33] 2/297.
[34] أعلام الحديث شرح البخاري 2/147.
[35] ص 54.
[36] طبقات الشافعية الكبرى 8/219.
[37] فتح الباري 6/136.
[38] فتح الباري 3/30.
[39] 7/124.