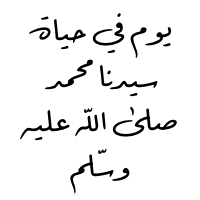بيان أن الله تعالى مخالف للحوادث، وأنه ليس جوهراً ولا عرضاً ولا جسماً ولا في جهةٍ ولا في مكان،الكلام على صفات الرضى والغضب والاستواء لله تعالى
33 – بيان أن الله تعالى مخالف للحوادث، وأنه ليس جوهراً ولا عرضاً ولا جسماً ولا في جهةٍ ولا في مكان
قال الدكتور: {وأخص صفات هذا القديم مخالفته للحوادث وعدم حلولها فيه، ومن مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس جوهرا ولا عرضا ولا جسما ولا في جهة ولا مكان…إلخ ثم أطالوا جدا في تقرير هذه القضايا. هذا.
وقد رتبوا عليها من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت العد مثل إنكارهم لكثير من الصفات كالرضي والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم، ونفي الجوهرية والعرضية والجهة والجسمية… إلى آخر المصطلحات البدعية}
يضيق الدكتور صدراً بقول الأشاعرة بمخالفته تعالى للحوادث وعدم حلولها فيه، وأن من مخالفته للحوادث أنه ليس جوهراً ولا عرضاً، ولا جسماً، ولا في جهة، ولا في مكان، ويعد الدكتور نفي هذه الأمور عن الله تعالى من المصطلحات البدعية!!.
أقول: من أجل تحقيق المسألة وبيان ما هو الحق فيها لا بد من بيان أمور، والتركيز عليها بقدر من التفصيل.
الأول: أن هذه الصفات يسميها الأشاعرة بالصفات السلبية، لأنها عبارة عن سلب أمورٍ لا تليق بالله تعالى عنه، فإن المخالفة للحوادث نفيٌ لمماثلته تعالى للحوادث، ثم إن المخالفة للحوادث عند الأشاعرة من صفات الله تعالى وليست أخص صفاته تعالى، عندهم، وأما أخص صفاته تعالى –إذا سلمنا أنه يصح التعبير بذلك- فهي الصفات الثبوتية التي يتوقف عليها أصل الإ̃لهية من الحياة والعلم والقدرة والإرادة، أو يتوقف عليها كمال الإ̃لهية من الحكمة والسمع والبصر إلى غير ذلك من الصفات الثبوتية.
الثاني: أن الصفات السلبية وفي مقدمتها مخالفته تعالى للحوادث، مدلولٌ عليها بالآيات الكثيرة: منها قوله تعالى: (ولم يكن له كفواً أحد) ومنها قوله: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: وهذه الآية ونحوها دليل لمذاهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات، وفيها رد على المشبهة في قوله: (ليس كمثله شيء) وعلى المعطلة في قوله: (وهو السميع البصير)
وقال القرطبي: في الكلام على هذه الآية: قال بعض المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مشبهةٍ للذوات ولا معطَّلةٍ عن الصفات. وزاد الوسطي رحمه الله تعالى فقال: ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ، وجَلَّتِ الذات القديمة أن يكون لها صفةٌ حديثة، كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفةٌ قديمة.
وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم.[1]
وقال الرازي: احتج علماء التوحيد قديماً وحديثاً بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسماً مركباً من الأعضاء والأجزاء، وحاصلاً في المكان والجهة، وقالوا: لو كان جسماً لكان مثلاً لسائر الأجسام، فيلزم حصول الأمثال والأشباه له، وذلك باطلٌ بصريح قوله تعالى: (ليس كمثله شيء)[2]
وقال ابن عاشور في تفسيره: الآية نفت أن يكون شيءٌ من الموجودات مماثلاً لله تعالى في صفات ذاته، لأن ذاته تعالى لا يماثلها ذوات المخلوقين، ويلزم ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقين في محسوس ذواتهم فهو منتفٍ عن الله تعالى. وبذلك كانت الآية أصلاً في تنـزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس والأعضاء عند أهل التأويل. والذين أثبتوا لله تعالى ما ورد في القرآن مما نسميه بالمتشابه فإنما أثبتوه مع التنـزيه عن ظاهره، إذ لا خلاف في إعمال قوله: (ليس كمثله شيء) وأنه لا شبيه له ولا نظير له…[3]
الثالث: أن أئمة أهل السنة قديماً وحديثاً قد قرروا ما قاله الأشاعرة مما نقله عنهم الدكتور هنا. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: «ومعنى الشيء إثباته – تعالى- بلا جسمٍ ولا جوهر، ولا عرض، ولا حدَّ له، ولا ضدَّ له، ولا ندَّ له، ولا مِثلَ له».
ونقتطف نبذاً من عقيدة الإمام أحمد المطبوعة في آخر المجلد الثاني من طبقات الحنابلة للقاضي أبى الحسين محمد بن أبي يعلى: «إن الله -عز وجل- واحدٌ لا من عدد، لا يجوز عليه التجزُّؤ ولا القسمة، وهو واحدٌ من كل وجه، وما سواه واحد من وجه دون وجه»[4]
«إن لله تعالى يَدَيْن، وهما صفة له في ذاته، ليستا بجارحتين، وليستا بمركبتين، ولا جسم، ولا من جنس الأجسام، ولا من جنس المحدود والتركيب، ولا الأعضاء والجوارح»[5] «ولا يجوز أن يقال: استوي بمماسة ولا بملاقاة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا، والله تعالى لم يلحقه تغييرٌ ولا تبديل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش، ولا بعد خلق العرش»[6] «وأنكر على من يقول بالجسم، وقال: إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك، وتركيب وصورة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل»[7]
«وكان يقول إن الله قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه. وقد سئل –الإمام أحمد- هل الموصوف القديم وصفته قديمان؟ فقال: هذا سؤال خطأ، لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته. ومعنى ما قاله من ذلك أن المحُدَث محدَثٌ بجميع صفاته على غير تفصيل، وكذلك القديم قديمٌ بجميع صفاته»[8]
وقال الطحاوي: (لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، خالقٌ بلا جارحة… ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه) وقال: (تعالى الله عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وهو مستغنى عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وبما فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه)
وقال شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى: (ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، ولا في مكان… والدلالة على أنه لا يجوز إطلاق القول عليه بأنه في مكان هو أن إضافته إلى المكان توجب قدم المكان بقدمه تعالى…)[9]
وبعد نقل ما نقلناه من كلام المفسرين وكلام أئمة أهل السنة المتعلق بالموضوع نقول: هذه الآية الكريمة (ليس كمثله شيء) وغيرها من آيات كريمات صريحة في أنه تعالى مخالف للحوادث ويلزم ذلك أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. وما نقلناه من كلام أئمة السنة صريح في سلب هذه الأمور عن الله تعالى، فهل بعد هذا يصح عَدُّ سلبِ هذه الأمور عن الله تعالى بدعة!!؟؟ ولا أدرى ماذا يقصده الدكتور بالبدعة!! وليت شعري ما الذي يعتقده الدكتور في الموضوع بعد إنكاره على الأشاعرة سلب هذه الأمور عن الله تعالى!!.
34- الكلام على صفات الرضى والغضب والاستواء لله تعالى
وأما قول الدكتور: {وقد رتبوا عليه من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت العد مثل إنكارهم لكثير من الصفات كالرضى والغضب، والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم ونفي الجوهرية والعرضية والجسمية…}
فلا بد أن نقف عنده وقفة، فنقول: لم ينكر الأشاعرة شيئا من الصفات الوارد في الكتاب والسنة الصحيحة ثبوتها لله تعالى على وجه الحقيقة، ولا أنكر ذلك واحد من الأشاعرة!
لكن الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة قديما وحديثا قامت عندهم الدلائل النقلية القطعية والعقلية اليقينية على أنه تعالى ليس كمثله شيء، وأنه تعالى مخالف للحوادث، وأنه تعالى قديم بصفاته الذاتية لا تحل فيه الحوادث، ولا يكون محلاً للتغير والانفعال، ثم إنهم وجدوا بعض الصفات الوارد في الكتاب والسنة الصحيحة ثبوتها لله تعالى لو حملت على معانيها الحقيقية لأفادت التشبيه ومماثلة الله تعالى للحوادث، وكونه محلاً للحوادث وللتغير والانفعال، وكون بعض الصفات القائمة بذاته حادثة.
فعند ذلك افترقوا فرقتين: الفرقة الأولى: نفت المعاني الحقيقية مما هو محال في حقه تعالى أن تكون مرادة من هذه النصوص، ولم تخض في تعيين المعاني المرادة من هذه النصوص، بل فوَّضَتها إلى الله تعالى، ويسمى هذا بالتأويل الإجمالي، وعلى هذا معظم السلف في معظم هذه النصوص.
والفرقة الثانية نفت أن تكون هذه المعاني مرادة من هذه النصوص، وحاولت مع ذلك بيان المعنى المراد على سبيل الاحتمال والظن لا على سبيل القطع والجزم. وعلى هذا معظم الخلف في معظم هذه النصوص، ويسمى هذا بمذهب التأويل، ويسمى المذهب الأول بمذهب التفويض. والتأويل لابد أن يكون بشروطه. وسيأتي بيان هذه الشروط مع تفصيل المسألة فيما بعد.
وبعد هذه المقدمة نقول: المتبادر من الغضب ما يعرض للإنسان من الحنق بعد ما لم يكن ويزول بعد ما كان، وكذلك الرضا المتبادر منه ما يحصل للإنسان من الانبساط بعد ما لم يكن، ثم يزول. ولا شك أن هذا تغير وانفعال وحدوث أمر لم يكن قبل. والله تعالى لا يكون محلاً للحوادث، ولا يجرى عليه التغير والانفعال، فلا يصح إثبات الغضب والرضا لله تعالى بهذين المعنيين، فإما أن ننفي هذين المعنيين عن الله تعالى مع إثبات الرضي والغضب بالمعنى الذي أراده بدون أن نبيِّنه، وإما أن نثبت الرضي والغضب لله تعالى ليس بهذين المعنيين، بل بمعنيين آخرين جائزين على الله تعالى، وإلى ما قلناه أشار الباقلاني في كتابه “الإنصاف” مع جريه على طريقة الخلف. قال: (وأنه سبحانه لم يزل مريداً وشائياً، ومحباً ومبغضاً، وراضياً وساخطاً، وموالياً ومعادياً، ورحيماً ورحماناً، ولأن جميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عباده ومشيئته، لا إلى غضبٍ يغيره، ورضى يسكِّنه طبعاً له، وحنقٍ وغيظٍ يلحقه، وحقدٍ يجده، إذ كان سبحانه متعالياً عن الميل والنفور)[10]
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر: (وأجمعوا على أنه عزَّ وجلَّ يرضى عن الطائعين وأن رضاه لهم إرادته لنعيمهم، وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضبه إرادته لعذابهم)[11]
وقال البيهقي في “الأسماء والصفات”: (الرضى والسخط عند بعض أصحابنا من صفات الفعل، وعند أبي الحسن الأشعري يرجعان إلى الإرادة، فالرضى إرادته إكرام المؤمنين وإثابتهم على التأبيد، والسخط إرادته تعذيب الكفار وعقوبتهم على التأبيد، وإرادته تعذيب فُسَّاقِ المؤمنين إلى ما شاء الله تعالى)[12]
وقال شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى في “المعتمد في الأصول الدين”: (ويجوز وصفه بالغضب والرضى… وهما إرادته لإثابة المرضي عنه وعقوبة المغضوب عليه)[13]
والحاصل أن الرضى والغضب الثابتين لله تعالى ليسا عبارتين عن الحنق والانبساط الذين يعرضان ويزولان، بل هما إما راجعان إلى صفة الذات التي هي إرادة الإثابة والتعذيب، وإما إلى صفة الفعل وهي الإثابة والتعذيب.
وأما الاستواء فلم ينكره أحد من الأشاعرة أيضا، وإنما أنكروا أن يكون بالمعنى المحال في حقه تعالى مما هو من صفات المحدثات والأجسام المقتضى لمشابهة الله تعالى بخلقه، فأنكروا أن يكون بمعنى الاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، وهم في ذلك موافقون للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ففي عقيدة الإمام أحمد المطبوعة في آخر مجلد الثاني من طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: «وكان يقول في معنى الاستواء: هو العلو والارتفاع، ولم يزل الله عالياً رفيعاً قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء، وإنما خص الله العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء، والعرش أفضل الأشياء وأرفعها، فامتدح الله تعالى نفسه بأنه على العرش استوى، أي عليه علا. ولا يجوز أن يقال: استوى بمماسة ولا بملاقاة. تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا، والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش».[14]
وقال الباقلاني في “الإنصاف”: «وإن الله -جَلَّ ثناه- مستوى على العرش، ومستولٍ على جميع خلقه كما قال تعالى: (الرحمن على العرش استوى) بغير مماسة وكيفية ولا مجاورة».[15]
وقال الغزالي في “قواعد العقائد”: «…وأنه مستوى على العرش على الوجه الذي قاله، وبالمعنى الذي أراده، استواءً منزَّهاً عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ثم قال: «تعالى الله عن أن يحويه مكان، كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل خلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان».[16]
وقال نحو هذا عز الدين بن عبد السلام في “العقائد” له.[17]
هذا كلام هؤلاء العلماء من الأشاعرة وهو موافق لما قاله الإمام أحمد.
نعم قد أوَّل بعض الأشاعرة الاستواء على العرش بتأويلات. والتأويل إذا كان بشروطه صحيح، وليس كل تأويل صحيحا.
وهذه التأويلات قد يناقش في بعضها هل هي صحيحة أم لا؟ وهل هي على شروط التأويل أم لا؟ وهذا النقاش إذا كان جارياً على حسب قواعد العلوم ومقرراتها أمر طيب جيد.
وأما نسبة إنكار الصفات الوارد نسبتها إلى الله تعالى في الكتاب والسنة الصحيحة إلى الأشاعرة فهذا أمر غير صحيح، وكذلك رد التأويل لهذه الصفات إجمالا وإنكار أصل التأويل غير صحيح، فإن أصل التأويل أمر ضروري لم ينج منه أحد من علماء الأمة لا قديما ولا حديثا، وإنما الكلام والخلاف في التوسع فيه. فهذا هو الذي أنكره من أنكره من علماء الأمة وأئمتها وسيأتي تفصيل المسألة إن شاء الله تعالى.
[1] الجامع لأحكام القرآن 16/10.
[2] مفاتيح الغيب 7/392.
[3] التحرير والتنوير 25/47.
[4] 293.
[5] 294.
[6] 297.
[7] 298.
[8] 298-299.
[9] المعتمد في أصول الدين56-57.
[10] الإنصاف 22.
[11] 73.
[12] الأسماء والصفات 641.
[13] 61.
[14] 196.
[15] الإنصاف 22.
[16] 6-7
[17] 7-8