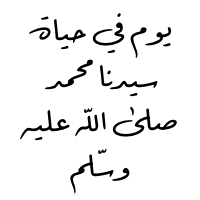حكم الدكتور على الأشاعرة بأنهم مرجئة جَهَمية، وتحقيق هذه المسألة،مسألة زيادة الإيمان ونقصه
40 – حكم الدكتور على الأشاعرة بأنهم مرجئة جَهَمية، وتحقيق هذه المسألة
قال الدكتور: {الرابع الإيمان: الأشاعرة في الإيمان مرجئة جهمية أجمعت كتبهم قاطبة على أن الإيمان هو التصديق القلبي، واختلفوا في النطق بالشهادتين أيكفي عنه تصديق القلب، أم لا بد منه….}
أقول: لا شبهة في أنَّ الإيمانَ وصفُ القلب وأنَّ الإيمانَ محلُّه القلبَ. وقد وردَ هذا في كثيرٍ من الآيات القرآنية، قال الله تعالى: (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) وقال: (ولما يدخل الإيمان في قلوبهم) وقال: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وجاء في الحديث: “الإيمانُ ما وَقَر في القلبِ وصدَّقه العملُ”. كذلك لا مرية أنه لابد في تحقق الإيمان من التصديقُ القلبيُّ؛ والتصديقُ عبارة عن نسبةِ الصدقِ بالاختيار إلى النبي. ويُسمى هذا بالإذعانِ والتسليم، وهذا هو المعتبرُ في الإيمان الشرعيِّ عند الأشاعرة وغيرهم من طوائف المسلمين ما عدى الجهمية.
وكما أن الإذعان والتسليم معتبر شرعا في تحقق الإيمان الشرعي الذي طلبه الله من المكلفين، كذلك هو معتبر في المعنى اللغوي للفظ الإيمان، فلا يقال في اللغة آمن به إلا إذا صدقه وأذعن له بقلبه، وأما مجرد وقوع نسبة الصدق في القلب فلا يسمى إيمانا لغة، وإنما يسمى علما ومعرفة كما قال الله تعالى عن الفريق الذين يعلمون صدق الرسول في دعوى الرسالة بدون أن يؤمنوا به: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون)، فلابد في تحقق كل من المعنى الشرعي واللغوي للإيمان من ضم فعل قلبي إلى المعرفة، وهو الإذعان لما عرفه والتسليم له، لكن الشرع قد نقل لفظ الإيمان إلى التصديق بأمور خاصة وهي ما جاء به الرسول وعلم مجيئه به بالضرورة، وجعل له نواقض اعتبر الشرع الإيمان ملغى معها كالعبادة لغير الله والتلفظ بكلمة الكفر في حال الاختيار.
وأما مجرد المعرفة ووقوع نسبةِ الصدقِ في القلب بدون التصديقِ والإذعان، فلا يكفي في الإيمان. والموجود عندَ أبي طالبٍ وغيرِه من كثيرٍ من المشركين هو المعرفةُ فقط بدون تصديقٍ وإذعانٍ.
والذي قالت الجهمية بكفايته في حصول الإيمان هو المعرفة. وكم من فرق بين المذهبين!! قال أبو منصور البغدادي: (وزعمت الجهمية أن الإيمان هو المعرفة وحدها)[1] ونقل الشهرستاني عن جهم أنه قال: (من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن)[2] وهذا المذهب مردود بقوله تعالى عن بعض الكفار: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) وقوله: (يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهو يعلمون)
ثم اختلف الأشاعرة في أنه هل يكفي في حصول أصل الإيمان وفي الخروج من الكفر هذا التصديق والتسليم والإذعان القلبي أم لابد في تحققه من ضم التلفظ بالشهادتين إليه إن كان المكلف قادرا على ذلك بأن لم يكن أخرس؟ والذين قالوا بكفاية التصديق بالقلب في ذلك قالوا: لابد أن يكون هذا المصدق بحيث إذا طولب بالتلفظ بالشهادتين تلفظ بهما ولم يمتنع عن ذلك، فإذا امتنع عن التلفظ بهما بعد المطالبة به فهو غير مسلم بامتناعه هذا، ثم إنهم أرادوا بكفاية التصديق كفايته فيما بين العبد وبين الله تعالى وكفايته في النجاة من الخلود في النار، أما إجراء أحكام المسلم الدنيوية على المكلف فلا خلاف في أنه لابد فيه من النطق بالشهادتين فيمن أسلم بعد كفر، وأما ولد المسلم إذا بلغ فنجرى عليه أحكام المسلمين وإن لم يتلفظ بالشهادتين طول عمره ما لم يثبت عليه ما يقتضي الحكم عليه بالكفر.
ثم إن من مذهب الأشاعرة أنهم يرجئون أمر العصاة إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. هذا هو مذهبهم في الإرجاء وهو الإرجاء السني الذي لا يخالف فيه أحد من أهل السنة، وأما الإرجاء البدعي وهو اعتقاد أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم من أبعد الناس عنه كما أنهم من أبعد الناس عن رأي جهم، وقد عدوا في كتبهم هذين المذهبين من مذاهب المبتدعة. هذا هو خلاصة مذهب الأشاعرة في القضية، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة، ونورد هنا جملة قليلة من الآيات والأحاديث التي هي صريحة في مذهبهم.
أما مذهبهم في الإيمان فمن الدلائل عليه ما يلي: قال الله تعالى: (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فعطف الله تعالى عمل الصالحات على الإيمان والعطف يقتضى المغايرة، وقال الله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) فعد الله تعالى الطائفتين المقتتلين مؤمنتين مع أن إحداهما باغية والأخرى مبغي عليها، وقد تكون كلتاهما باغيتين، فلم ينف الله تعالى عنهما الإيمان وعدهما مؤمنتين، وقال تعالى: (فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) فجعل الله تعالى الإيمان شرطا لقيام الأعمال الصالحة ولو كان الإيمان اسماً لكل عبادة لكان شرط الشيء نفسه قاله أبو المعين النسفي.[3]
وأما السنة فنكتفي منها بحديث جبريل، فقد فسر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيه الإيمان بقوله: (أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى) فقد فسر الأشاعرة الإيمان بما فسره به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم فسر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإسلام (بالتلفظ بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج)، فجعل التلفظ بالشهادتين من الإسلام لا من الإيمان، وأدخله في نوع العمل كا الصلاة والزكاة، دون نوع الاعتقاد، وهذا دليل لمن يقول من الأشاعرة وغيرهم إن التلفظ بالشهادة ليس بشرط في حصول أصل الإيمان.
وأما مذهب الأشاعرة في الإرجاء فدليله ما لا يحصى من الآيات والأحاديث ونقتصر منها على قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء) وعلى ما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: (من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) رواه مسلم.
فهل بعد هذا يصح أن يقال: إن الأشاعرة في الإيمان مرجئة جهمية؟!
نعم يُثير غضبَ الدكتور أن الأشاعرة لم يقولوا: (الإيمان اعتقاد وقول وعمل) مثل من قال ذلك من الأئمة، ولكن الأشاعرة لم يخالفوا في هذا القول بمعناه الذي قصده القائلون به. وكيف يجوز لهم أن يخالفوا فيه وقد قال الله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) فقد عبر عن الصلاة بالإيمان، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إ̃له إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) وقال: (الطهور شطر الإيمان)
وبيان ذلك أن الإيمان شبيه بالشجرة فاسم الشجرة يطلق على مجموع الساق والأغصان والورق والثمر وإذا قطف الثمر فلا يزال اسم الشجرة يطلق على الباقي، وكذلك إذا قطعت الورق والأغصان، وأما إذا قطع الساق فقد عدمت الشجرة، ولم يبق هناك ما يطلق عليه اسم الشجرة.
كذلك اسم الإيمان قد أطلق في كثير من نصوص الكتاب والسنة على معنى عام يشتمل أصل الإيمان وما يترتب عليه من الأعمال والثمرات، وبانعدام الأعمال والثمرات لا ينعدم أصل الإيمان، وأما بانعدام التصديق القلبي فينعدم أصل الإيمان، فتعريف الأشاعرة للإيمان بأنه التصديق القلبي وحده أو مع التلفظ بالشهادتين على الخلاف في الشهادتين عندهم، تعريف لأصل الإيمان التي بدونه يعد الإنسان كافرا مخلدا في النار، وأما من قال: (الإيمان اعتقاد وقول وعمل) فقد عرف الإيمان بالمعنى العام الذي جاء به كثير من نصوص الكتاب والسنة، فلا خلاف بين الفريقين لأن كل واحد منهما عرف معنى للإيمان مغايراً للمعنى الذي عرفه الآخر. والله تعالى أعلم.
41-مسألة زيادة الإيمان ونقصه
قال الدكتور: {هذا وقد أوَّلوا كُلَّ آيةٍ أو حديثٍ وردَ في زيادة الإيمانِ ونُقْصانه أو وصفِ بعض شُعبه بأنَّها إيمانٌ أو من الإيمان}
أقول: مذهبُ الأشاعرة أنَّ الإيمانِ يزيدُ وينقصُ، وعمدتُهم في الاستدلال على ذلك ما وردَ من نصوص الكتابِ والسنةِ في الزيادة، والذين يقولون بنفي الزيادةَ والنقصَ في الإيمان هم جمهورُ الحنفية، ولهم أيضاً دلائلهم على ذلك.
وأما ما جاء في كثير من نصوص الكتاب والسنة من التعبير عن بعض الأعمال المطلوبة بالإيمان كما قال الله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أي صلاتكم أو التعبير بأنها من الإيمان، فصحيح أن الأشاعرة قد أولوها، وذلك لأنهم يرون أن الإيمان موضوع لغة وشرعا للتصديق القلبي لكن الشرع نقله إلى التصديق بأمور خاصة. وهذه الأعمال ليست نفس التصديق، بل هي آثاره وثمراته، فيكون إطلاق الإيمان عليها مجازا لا حقيقة.
وأنا أسأل الدكتور هل إذا عمل أحد الكفار شيئا من هذه الأعمال المطلوبة شرعا يطلق على ما عمله أنه إيمان،؟ فإن كان إطلاق الإيمان على هذا الأعمال على وجه الحقيقة فلا بد أن يصح أن يطلق على ما عمله الكافر من ذلك أنه إيمان. ولا أعتقد أن الدكتور يجيب بنعم، فإذا لم يصح إطلاق الإيمان عليها في هذه الصورة، يكون إطلاقه عليها مشروطا باتصاف صاحبها بالإيمان، ومعنى هذا أن إطلاق الإيمان عليها باعتبار أنها ثمراته وآثاره، وهذا هو تأويل الأشاعرة الذي أنكره الدكتور عليهم!.
[1] أصول الدين 249.
[2] الملل والنحل 1/111.
[3] التمهيد 101-102.