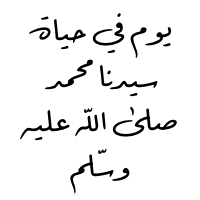“متشابه الصفات بين التأويل والإثبات”
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فنريد أن نحقق في هذا البحث مسألة صفات الله المتشابهة الواردة في الكتاب والسنة، وقبل الدخول في المسألة لابد أن نقرر أمورا:
الأول: أنَّ النصوص الشرعية إذا كان ظاهرها مخالفا لصرائح العقول ومقرراتها وجب أن يحكم أن ظاهرها غير مراد.
الثاني: أن النصوص الشرعية منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه كما قال الله تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) والنصوص المحكمات هي الأصول الثوابت للإسلام، وأما المتشابهات فترد إلى المحكمات ويحكم بأن ظاهرها غير مراد.
الثالث: أن الكتاب والسنة قد وردا على أساليب اللغة العربية، واللغة العربية كسائر اللغات قد وردت على ثلاثة أنواع من الأساليب: أسلوب الحقيقة، وأسلوب المجاز، وأسلوب الكناية، وذلك لأن كل كلمة من كلمات اللغة العربية قد وضعت لمعنى معين، وكذلك كل مركب منها، وهذه الكلمات والمركبات قد تستعمل في المعنى الذي وضعت له، وقد لا تستعمل فيه، بل تستعمل في معنى يناسب المعنى الذي وضعت له بإحدى المناسبات، وذلك كالأسد قد يستعمل في المعني الذي وضع له وهو الحيوان المفترس المعروف، وقد يستعمل في الرجل الشجاع لمناسبته للحيوان المفترس في الشجاعة، ولمشابهته له فيها. وهذا ما لا ينبغي أن يختلف فيه أحد من العقلاء. فإذا استعمل اللفظ في المعني الذي وضع له سمى في اصطلاح علماء البلاغة بالحقيقة، وإذا استعمل في غير ما وضع له لإحدى المناسبات مع قرينة تدل علي هذا الاستعمال سمي مجازا أو كناية.
الرابع: الكلام على التأويل وبيان معناه، وننقل هنا كلاما لابن القيم وتعليق تقي الدين السبكي عليه. قال ابن القيم في النونية: التأويل الصحيح هو تفسيره وظهور معناه كقول عائشة: يتأول القران. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلي الحقيقة. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا. تأويله عندهم تأويله بالظاهر. ما قال منهم شخص واحد: تأويله صرفه عن الرجحان.
قال تقي الدين السبكي تعليقا علي هذا الكلام: قال الله تعالي في المتشابه: (وما يعلم تأويله الا الله) فكيف يكون تأويله بالظاهر، والمتشابه لا ظاهر له. وقوله: (ما قال منهم أحد إن التأويل صرف عن الرجحان) كذب، بل خَلْقٌ قالوا به. ويطلق التأويل أيضا علي تدبر القرآن وتفهم معناه.[1]
يقصد الإمام تقي الدين السبكي أن حمل التأويل على معنى التفسير بالظاهر في باب المتشابهات غير صحيح، وذلك لأن المتشابه مدلوله خفي غير واضح، وإلا لما كان متشابها، والظاهر في اللغة يقابل الخفي، فلا يجوز أن يقال في المتشابه الذي هو غاية في الخفاء: إن تأويله تفسيره بالظاهر، فإنه كلام متناقض ينقض نفسه. وأما الظاهر في أصول الفقه فبمعني الراجح من الاحتمالين بالوضع أو بالدليل، وهو من أقسام الواضح المقابل للخفي الذي من أقسامه المتشابه. ويقابل الظاهر المؤول، فلا يتصور اجتماعهما في لفظ أيضا.
وإذا تقرر هذا فنقول: إنه من الأمور المجمع عليها بين علماء المسلمين أن من نصوص الكتاب والسنة ما إذا قطع عن سياقه وسباقه، ولوحظ بالمعنى الذي وضع له في اللغة وهو المعنى الحقيقي كان إما مخالفا لصرائح العقول، أو مخالفا للمحكمات من نصوص الكتاب والسنة، أو مخالفا للقواعد الإسلامية المقررة المأخوذة من الكتاب والسنة. وهذه النصوص هي النصوص المتشابهات المذكورة في الآية الكريمة.
وهذه النصوص المتشابهات قد أجمعت الأمة على سبيل الإجمال على أن معناها الموضوع له ليس بمراد منها. هذا إجماع على سبيل الإجمال، وأما إذا أتينا إلى التفاصيل وإلى جزئيات هذه النصوص فقد يجري فيها الخلاف.
ثم اختلفت الأمة فذهب معظم السلف في معظم هذه النصوص إلى التوقف عند هذا الحد، وهو أن المعنى الموضوع له لهذه النصوص غير مراد، بدون أن يتجاوزوا هذا الحد إلى تعيين المعنى المجازي، أو الكنائي لها، وذلك تورعا منهم، ومخافة أن يفسروا كلام الله تعالى وكلام رسوله على خلاف مرادهما. وهذا يسمى بالتأويل الإجمالي.
وذهب معظم الخلف إلى جواز تأويلها وصرفها إلى معان تناسب المعني الحقيقي لهذه النصوص، وذلك بمعونة القرائن والسياق والسباق والألفاظ المقرونة بها، لكن بدون قطع بالمعنى المؤول به، بل يكون الصرف على سبيل الاحتمال والرجحان. وذلك بشروط.
الأول: أن يكون المعنى الذي حمل عليه النص ثابتا لله تعالى.
الثاني: أن لا يكون حمل النص على المعنى الذي صرف إليه مخالفا لأساليب اللغة العربية.
الثالث: أن لا يكون مخالفا لسياق النص بل يكون مناسبا له.
الرابع: أن لا يكون المعنى الذي صرف إليه النص مشعرا بالنقص بالنسبة إلى الله تعالى.
الخامس: أن يكون مشعراً بالعظمة.
وههنا نكتة نبه عليها الإمام الغزالي في كتاب (قانون التأويل)-وهو كتاب جدير بالعناية بقراءته- وهي أنه لا يجوز بالنسبة إلى هذه النصوص تفريق مجتمع ولا جمع متفرق، وذلك لأن كل واحد من هذه النصوص في سياقه وسباقه ما يدل علي المعنى المجازي أو الكنائي الذي استعمل فيه، فإذا قطع من سياقه وأفرد عن سابقه ولاحقه فاتت هذه الدلالة، وكذالك إذا جمعت هذه النصوص على صعيد واحد عضدت الظواهر بعضها البعض، فيترجح بقاؤها على ظواهرها المفيد للتشبيه. وذلك كما ألف بعضهم مؤلفات فذكر فيها باب ما ورد في العين، وباب ما ورد في اليد، وباب ما ورد في الوجه إلي غير ذلك
وقد قرر قريبا من هذا الكلام الإمام تقي السبكي: حيث قال:
وانظر إلى هذه الصفات التي يثبتها هذا المبتدع لم تجيء قط في الغالب مقصودة، وإنما في ضمن كلام يقصد منه أمر آخر، وجاءت لتقرير ذلك الأمر، وقد فهمها الصحابة، ولذلك لم يسألوا عنها النبي صلي الله تعالي عليه وآله وسلم لأنها كانت معقولة عندهم بوضع اللسان وقرائن الأحوال، وسياق الكلام، وسبب النزول.
ومضت الأعصار الثلاثة التي هي خيار القرون على ذلك، حتى حدثت البدع والأهواء، فيجيء مثل هذا المتخلف بجمع كلمات وقعت في أثناء آيات أو أخبار فهم الموفقون معناها بانضمامها مع الكلام المقصود، فجعلها هذا المتخلف في أمثاله مقصودة، وبالغ فيها، فأورث الريب في قلوب المهتدين.
وانظر إلى أكثرها لا تجده مقصودا بالكلام، بل المقصود غيره إما بسياق قبله، أو بسباق بعده، أو يكون المحدث عنه معنى آخر… ويكون ذلك مذكورا على جهة الوصف المقوِّي لمعنى ما سيق الكلام لأجله. انتهى كلام السبكي.[2]
وتوسط الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد بين مذهب السلف والخلف، فقال: نقول في الصفات المشكلة: إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله تعالى. ومن تأولها نظرنا فإن كان تأويله قريبا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه، ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه.
وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب حملناه عليه كقوله تعالى: (يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) فإن المراد به في استعمالهم الشائع حق الله، فلا يتوقف في حمله عليه، وكذلك قوله صلي الله عليه وآله وسلم: (إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن) فإن المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه، وكذلك قوله تعالى: (فأتى الله بنيانهم من القواعد) معناه خرب الله بنيانه، وقوله: (إنما نطعمكم لوجه الله) معناه لأجل الله، وقس على ذلك. وهو تفصيل بالغ قل من تيقظ له. انتهى.
ولله در ابن دقيق العيد ما أدق نظره وأسده، فإنه إذا كان المعنى المجازي للنص مفهوما من تخاطب العرب بحيث لا يفهم العربي من ذلك النص إلا المعنى المجازي، كان ذلك النص من قبيل المجاز المشهور والحقيقة المهجورة، فيكون صرفه عن ذلك المعنى المجازي إلحادا في آيات الله وتحريفا للكلم عن مواضعه. كيف وكثير من تلك النصوص لو ترجمت ترجمة حرفية إلى لغة أخري لما فهم منها أهل تلك اللغة إلا المعني المجازي، فكيف يجوز إذًا صرفها عن تلك المعاني، وهل نزل القرآن إلا على أساليب اللغة العربية. وذلك كقوله تعالى (تبارك الذي بيده الملك) فإنه لا أحد يفهم منه إلا إثبات الملك لله تعالى، لا إثبات اليد لله، كيف والملك بالضم هو السلطنة، وهو أمر معنوي لا يكون في اليد ولا ملتصقا بها، وكقوله صلى الله تعلى عليه وآله وسلم: ( إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن) لا يفهم منه أحد إلا أن قلوب بني آدم طوع إرادته وقدرته تعالى لا إثبات الإصبعين لله تعالى، كيف ولا يوجد في داخل أحد إصبعان مكتنفان بقلبه وهذا أمر معلوم لكل عاقل.
ومن ذلك قوله تعالى: (نسوا الله فنسيهم)[3] والنسيان بالمعنى الحقيقي محال على الله تعالى قال الله تعالى: (وما كان ربك نسيا)[4] وقال: (قل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى)[5] فتعين حمل النسيان في الآية الأولى على المعنى المجازي، وهو الترك وعدم المبالاة بهم، وإيكالهم إلى أنفسهم.
ومنه قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى)[6] والأسرى ليست في أيديهم حقيقة، وإنما هم تحت سيطرتهم، وهو المعنى المجازي.
ومنه قول الله تعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (عبدي مرضت فلم تعُدني) والمرض على الله تعالى محال، وإنما المراد مرض عبدي كما جاء تفسيره في آخر الحديث وهو المعنى المجازي.
ومنه قول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (اللهم… واغسلني بالماء والثلج والبرد) رواه مسلم، وليس المراد حقيقية الغسل، بل المراد تنقيته من ذنوبه كما ينقى من الدنس الثوب الذي يغسل بالماء والثلج والبرد.
ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ) رواه أحمد في المسند، والمراد بالعض على السنة بالنواجذ التزامها وشدة التمسك بها. ولا يتصور المعنى الحقيقي للعض بالنسبة إلى السنة.
إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من نصوص الكتاب والسنة وكلام العرب. فحمل الكلام على المعنى المجازي لقرينة تدل على ذلك هو الذي يسميه الأشاعرة تأويلا، وهو أمر لا مناص منه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العرب، ولا في لغة من لغات العالم.
وقد نقل بعضهم كلام ابن دقيق بوجه وجيز محرر، فقال: قال الإمام المجتهد ابن دقيق العيد: إن كان التأويل من المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير توقف، أو من المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه، وإن استوى الأمران فالاختلاف في جوازه وعدم جوازه مسألة فقهية اجتهادية، والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة إلى الفريقين. انتهى.
وهو كلام نفيس ينبئ عن علم جم، وصراحة في بيان الحق، وتوسط حكيم.
وههنا نريد أن نركز على تحقيق أمرين:
الأول: تحقيق أن السلف قد توقفوا عند حد أن المعنى الموضوع له لهذه النصوص غير مراد بدون أن يتجاوزوا هذا الحد إلى تعيين المعنى المجازي أو الكنائي لها. وهذا ما سماه العلماء بالتفويض، وتحقيق هذا إنما يكون بنقل كلام السلف المتعلق بذلك.
فنقول: قال الإمام الحافظ البيهقي: أخبرنا عبد الله بن محمد الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن احمد بن بالويه، ثنا محمد بن بشير بن مطر، ثنا الهيثم بن خارجه،ثنا الوليد بن مسلم، قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية.
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الإصبهاني ثنا إسحق بن أحمد الفارسي ثنا حفص بن عمر المهرقاني ثنا أبو داود وهو الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث، ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر.»[7]
وقال الحافظ: وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر.[8]
وقال الإمام الترمذي في سننه: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث – حديث الصدقة – وما يشبه هذا من الروايات في الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا، ويؤمن بها، ولا يتوهم، ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة.[9]
وقال الذهبي: والمحفوظ عن مالك رحمه الله رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات فقال: أمروها كما جاءت بلا تفسير.[10]
وقال الحافظ: وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.[11]
وقال الترمذي عند الكلام على حديث (يمين الرحمن ملأى سخاء): وهذا حديث قد روته الأئمة، نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم، هكذا قال غير واحد من الأئمة. منهم الثوري، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وابن المبارك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال: كيف. انتهى.
ونقل ابن أبي يعلى في “طبقات الحنابلة” عن أبي محمد البربهاري شيخ الحنابلة في بغداد تـ329 وكان معاصرا للإمام أبي الحسن الأشعري. أنه قال: وكل ما سمعت من الآثار شيئا لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلي الله تعالى عليه وآله وسلم: (قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن) وقوله:( إن الله ينزل الي سماء الدنيا. وينزل يوم عرفة. وينزل يوم القيامة) و(إن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناءه) وقول الله تعالي للعبد (إن مشيتَ إليَّ هَرْوَلْتُ إليك) وقوله: (خلق الله آدم علي صورته) وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (رأيت ربي في أحسن صورة) وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضاء ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بها واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. انتهي.[12]
وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزني يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعالى: (وجاء ربك والملك صفا صفا) والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال، بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه جل الله تعالى عما تقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوا كبيرا. قلت -القائل البيهقي – : وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى يقول: إنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من النزول الذي هو تدل من أعلى إلى أسفل، وانتقال من فوق إلى تحت، وهذه صفة الأجسام والأشباح.
فأما نزول من لا تستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة، وإنما هو خبر عن قدرته تعالى ورأفته بعباده، وعطفه عليهم، واستجابته دعائهم، ومغفرته لهم. يفعل ما يشاء. لا يتوجه على صفاته كيفية، ولا على أفعاله كمية. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام البيهقي.[13]
هذه النصوص الواردة عن سلف الأمة -وهي غيض من فيض وقليل من كثير- بعضها ظاهر، وبعضها الآخر صريح في أن السلف كان مذهبهم التفويض. وهو الصرف عن المعنى الحقيقي بدون تعيين للمعنى المجازي أو المعنى الكنائي، فإن ما نقله الذهبي عن الإمام المالك من أنه قال: ( أمروها كما جاءت بلا تفسير) صريح في ذلك. وكذلك ما نقله الحافظ العسقلاني عن سفيان بن عيينة أنه قال: (كل ما وصف به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته، والسكوت عنه)، ومثله كلام البربهاري، وذلك لأنه حكم أولا بأن هذه النصوص لا تبلغها العقول، ثم حكم بوجوب التصديق والتفويض لها، وعدم تفسيرها. وكذلك ما نقله البيهقي عن أحمد بن عبد الله المزني، وذلك حيث نفى المعنى الحقيقي للنزول والمجيء بقوله: «والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال»، ثم فوض المعني المراد إلي الله تعالى بقوله: «بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه».
وتعبير البربهاري عن كل من المجيء والنزول بالصفة جار على طريقة فريق من السلف منهم الإمام أبو حنيفة في “ الفقه الأكبر “ والإمام أبو الحسن الأشعري في “ الإبانة “ يعبرون عن مثلها بالصفات، فيقولون: يد الله صفة له وعينه صفة له، وهكذا كل ما ورد في الكتاب والسنة مما يكون حمله على حقيقته مفضيا إلى التشبيه المنفي بقوله تعالى (ليس كمثله شيء)، فمن قال من السلف إن العين صفة تبرأ بهذا القول عن القول بالجارحة، بل يكون قائلا بأن المراد معنى قائم بالله، وكذلك اليد، لكن يقول لا أعين ذلك المعنى المراد، بأن أقول: إنه الحفظ أو القدرة أو النعمة، أو العناية الخاصة، لكون تعيين المراد من بين المحتملات الموافقة للتنزيه تحكم على مراد الله تعالى.
وتسميته لهما صفتين يدل على أنه جازم بأنهما ليسا من قبيل أجزاء الذات تعالى الله عن ذلك.
وأما من قال: له يد يبطش بها، وعين يرى بها فقد جعلهما من قبيل الجوارح، وخالف السلف الصالح.
نعم قد يقع في كلام من يميل إلى التشبيه ذكر الوجه والعين واليد وغيرها بأنها صفات، لكن السياق والسباق في كلامه يناديان أنهم أرادوا بها أجزاء الذات لا المعاني القائمة بالله تعالى كما يقول السلف. يقول ابن تيمية في “الأجوبة المصرية”: إن الله يقبض السموات والأرض باليدين اللتين هما اليدان. فما يجدي بعد هذا التصريح أن يسمى اليد صفة، وذلك أنه حمل القبض على القبض الحسي، وذلك من لوازم الجارحة والتجسيم.
وأما ما نقله البيهقي عن الخطابي فجار على طريقة التأويل حيث عين المعنى المجازي بقوله: «وإنما هو خبر عن قدرته تعالى ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابته دعائهم». وهذا ما ذهب إليه فريق من المحققين كتاج الدين السبكي وسعد الدين التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني من أن هذه النصوص من قبيل الاستعارة المركبة ويسمونها بالاستعارة التمثيلية، وبالتمثيل، ويدل عليه كلام الإمام تقي الدين السبكي الذي أوردناه آنفا.
وأما ما ذهب إليه بعض من يميل إلى التشبيه من أن مذهب السلف في هذه النصوص هو بقاؤها على معانيها الحقيقية مع نفي الكيفية عنها. فهذا القول مخالف لصريح كلام السلف. ثم إنه كلام فاسد في نفسه ومتناقض.
وذلك لأن المعاني الحقيقية لهذه النصوص هي المعاني المعروفة المكيفة. فالقول ببقائها على معانيها الحقيقية مع نفي الكيفية عنها كلام متناقض ينقض نفسه بنفسه.
قال الإمام تقي الدين السبكي في معرض الرد على من قال إن هذه النصوص مع بقائها على معانيها الحقيقية هي أوصاف وليست عبارة عن الأجزاء والجوارح : قال: وهذه الأشياء التي ذكرناها «من الوجه، واليد، والساق، والقدم، والجنب، والعين» هي عند أهل اللغة أجزاء لا أوصاف، فهي صريحة في التركيب للأجسام، فذكر لفظ الأوصاف تلبيس، وكل أهل اللغة لا يفهمون من الوجه، والعين، والقدم إلا الأجزاء، ولا يفهم من الاستواء بمعنى القعود إلا أنه هيئة المتمكن، ولا من المجيء والإتيان والنزول إلا الحركة الخاصة بالجسم.
وأما المشيئة والعلم والقدرة ونحوها فهي صفات ذات، وهي فينا ذات أمرين: أحدهما عرض قائم بالجسم، والله تعالى منزه عنه والثاني: المعاني المتعلقة بالمراد والمعلوم والمقدور، وهي الموصوف بها الرب سبحانه وتعالى، وليست مختصة بالأجسام. فظهر الفرق. انتهى.[14]
فالقول بأن هذه النصوص باقية على معانيها الحقيقية يلزمه التجسيم لزوما بينا، ولا ينجي صاحبه من التجسيم القول بنفي الكيفية، ولا القول بأنها صفات وليست عبارة عن الجوارح والأبعاض، لأنه بعد القول ببقائها على معانيها الحقيقية لم يبق معنى للقول بنفي الكيفية ولا للقول بأنها صفات. وحينئذ ينطبق على هذا القول ما قاله الإمام فخر الدين الرازي حيث قال: من قال: إنه مركب من الأعضاء والأجزاء فإما أن يثبت الأعضاء التي ورد ذكرها في القرآن، ولا يزيد عليها أولا، فإن كان الأول لزم إثبات صورة لا يمكن أن يزاد عليها في القبح، لأنه إثبات وجه بحيث لا يوجد منه إلا رقعة الوجه لقوله تعالى ( كل شيء هالك إلا وجهه)[15] ويلزمه أن يثبت في تلك الرقعة عيونا كثيرة لقوله تعالى: (تجري بأعيننا)[16] وأن يثبت له جنبا واحدا لقوله تعالى: (يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله)[17] وأن يثبت على ذلك الجنب أيدي كثيرة لقوله تعالى: (مما عملت أيدينا أنعاما)[18] وبتقدير أن يكون له يدان فإنه يجب أن يكون كلاهما على جانب واحد لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (وكلتا يديه يمين) وأن يثبت له ساقا واحدا لقوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق)[19] فيكون الحاصل من هذه الصورة مجرد رقعة الوجه، ويكون عليها عيون كثيرة وجنب واحد ويكون عليها أيدي كثيرة وساق واحد.
ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور، ولو كان هذا عبدا لم يرغب أحد في شرائه. فكيف يقول عاقل: إن رب العلمين موصوف بهذه الصورة؟
وإن كان الثاني وهو أن لا تقتصر على الأعضاء المذكورة في القرآن بل يزيد وينقص على وفق التأويلات، فحينئذ يبطل مذهبه في الحمل على مجرد الظواهر، ولا بد له من قبول دلائل العقل. انتهى.[20]
فالحق هو التوسط بين الظاهرية والغلو في التأويل . قال الإمام ابن عقيل الحنبلي: هلك الإسلام بين طائفتين: الباطنية والظاهرية، والحق بين المنزلتين. وهو أن نأخذ بالظاهر ما لم يصرف عنه دليل، ونرفض كل باطن لا يشهد به دليل من أدلة الشرع.
الأمر الثاني: بيان أن التأويل ليس خاصا بمذهب الخلف، وبيان أن فريقا من سلف الأمة قد أول مجموعة من النصوص إما لمخالفته لصرائح العقول، أو لمخالفته للنصوص المحكمات.
وذلك لأن أصل التأويل أمر ضروري لا بد منه، فإن من النصوص ما لا يمكن حمله على المعنى الذي وضع اللفظ له إما لمخالفتها لصرائح العقول، أو لمخالفتها للنصوص المحكمات، وقد اقترن به قرينة تعين المعنى المستعمل فيه المناسب للمعنى الموضوع له، فمثل هذه النصوص لا وجه للتوقف فيها، ويتعين حملها على المعاني التي تعينها القرائن، وهذا هو معنى قول الإمام ابن دقيق العيد السابق: «وما كان منها –أي من النصوص – معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب حملناه عليه، كقوله تعالى : (على ما فرطت في جنب الله) فإن معناه في استعمالهم الشائع: حق الله، فلا يتوقف في حمله عليه» إلى آخر كلامه.
فالتأويل قد يكون متعينا، كما قد يكون جائزا، وقد يكون ممتنعا، وقد ذكرنا شرائطه آنفا.
وقد غلا في باب التأويل فريقان: فريق غلق باب التأويل وسد الطريق على العقل، وهم المشبهة ظاهرية العقيدة، وفريق آخر غلا في التأويل، وقلد المعتزلة في تأويلاتهم التي بدَّعهم السلف من أهل السنة من أجلها، وهم كثير من متأخري الأشاعرة، وخير الأمور أوسطها وهو ما ذهب إليه الإمام ابن دقيق العيد.
ومن أجل أن أصل التأويل أمر ضروري لابد منه أول فريق من سلف الأمة بما فيهم بعض الصحابة والتابعين مجموعة من نصوص الكتاب والسنة وإليك مجموعة من هذه التأويلات.
تأويل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما:
أول ابن عباس قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق)[21] فقال: يكشف عن شدة، فأول الكشف عن الساق بكشف الشدة، نقل ذلك عنه بسند صحيح الحافظ العسقلاني.[22] والإمام الطبري في تفسيره.[23] وقال في صدر كلامه على هذه الآية: قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. فنسب التأويل إلى جماعة من الصحابة والتابعين.
وأوَّل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأيدي في قوله تعالى (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون)[24] بالقوة نقله الطبري في التفسير[25] ونقل هذا التأويل عن جماعة من أئمة السلف منهم مجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان، فاليد مفردا كان أو مثنى كما في قوله تعالى: (لما خلقت بيدي) أو جمعا كما هنا يفسر بالقوة والقدرة مفردا. ولا يفسر المثنى بالقدرتين ولا الجمع بالقدرات كما قيل، فقد ورد في حديث يأجوج ومأجوج: (لا يدان لأحد بهم) ومعناه لا قوة لأحد بقتالهم ومقاومتهم.
وأول ابن عباس رضي الله عنهما النسيان الوارد في قوله تعالى (فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا )[26] بالترك في العذاب. نقله الطبري في تفسيره[27] وروى هذا التأويل بأسانيده عن مجاهد وغيره.
تأويل الإمام احمد:
روي الأمام البيهقي في كتابه مناقب الإمام أحمد وهو كتاب مخطوط وعنه نقل الحافظ ابن الكثير في البداية والنهاية: فقال: روي البيهقي عن الحاكم عن أبي عمر بن السماك عن حنبل ان أحمد بن حنبل تأول قوله تعالي: ( وجاء ربك) أنه جاء ثوابه، ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه.[28]
وقال ابن كثير: ومن طريق أبي الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل أنه أجاب الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالى: (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون) قال: يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه هو المحدث.[29]
تأويل الإمام النضر بن شميل:
وهو الإمام الحافظ اللغوي من رجال الستة. ولد 122هـ ذكر الحافظ الذهبي في الأسماء والصفات أن النضر بن شميل قال: إن معنى حديث: (حتى يضع الجبار قدمه فيها) من سبق في علمه أنه من أهل النار.[30]
تأويل الإمام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه.
ذكر الذهبي أن معدان سأل الإمام الثوري عن قوله تعالى: (وهو معكم أينما كنتم) فقال: علمه، وسئل سفيان عن أحاديث الصفات، فقال: أمروها كما جاءت.[31]
تأويل الإمام عبد الله ابن مبارك.
روى البخاري عن صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما أنا أمشى معه إذ جاء رجل فقال: يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه…ثم قال البخاري: قال ابن المبارك كنفه يعنى ستره. رواه البخاري في خلق أفعال العباد[32] ونقله الحافظ في “فتح الباري”.[33]
تأويل الإمام الترمذي:
روى الترمذي في جامعه الحديث المشهور: (أنا عند ظن عبدي بي…. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث (من تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا) يعنى بالمغفرة والرحمة، وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا: إنما معناه: يقول: إذا تقرب إلي العبد بطاعتى وبما أمرت، تسارع إليه مغفرتي ورحمتي.[34]
هذه نماذج من تأويل السلف للنصوص، واستقصائه يتعسر أو يتعذر من كثرته.
وما ذكرناه هنا هو حاصل مذاهب علماء الأمة وأئمتها من السلف والخلف في باب الصفات وباب التأويل محققا محررا.
والله تعالى يتولى هدانا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
[1] السيف الصقيل 158.
[2] السيف الصقيل169.
[3] التوبة 67.
[4] مريم 64.
[5] طه 52.
[6] الأنفال 70.
[7] السنن الكبرى 3/2.
[8] فتح الباري 13/342.
[9] 598.
[10] سير أعلام النبلاء 8/105.
[11] فتح الباري 13/343.
[12] طبقات الحنابلة 2/23.
[13]السنن الكبرى 3/3
[14] السيف الصقيل 167.
[15] القصص 88.
[16] القمر 14.
[17] الزمر 56.
[18] يس 71.
[19] القلم 42.
[20] مفاتيح الغيب 7/148.
[21] القلم 42.
[22] فتح الباري 13/428.
[23] 29/38.
[24] الذاريات 47.
[25] 27/7.
[26] الأعراف 15.
[27] 8/201.
[28] البداية والنهاية 10/327.
[29] البداية والنهاية 10/327.
[30] 444.
[31] سير أعلام النبلاء 7/274.
[32] 78.
[33] 13/477.
[34] تحفة الأحوذي 10/64.