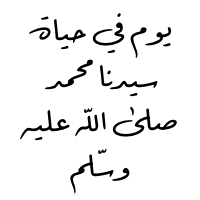مسألة جواز أن يخلد الله المؤمن في النار والكافر في الجنة،مسألة جواز تكليف ما لا يطاق
54 – مسألة جواز أن يخلد الله المؤمن في النار والكافر في الجنة:
التاسع: قوله: “ورتَّبوا على ذلك أصولاً فاسدة كقولهم: بجواز أن يخلِّد الله في النار أخلص أوليائه، ويخلِّد في الجنة أفجر الكفار”.
أقول: هذا الأصل من الأصول الصحيحة التي أخذها الأشاعرة من الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: “يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء”.
قال ابن كثير: وقوله تعالى: “يعذب من يشاء ويرحم من يشاء” أي: هوا لحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يُسْأَل عما يفعل وهم يُسْأَلون، فله الخلق والأمر، مهما فعل فعدل لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: “إن الله لو عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم”. انتهى.[1]
وأما السنة فقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: “لن ينجي أحداً منكم عمله” قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: “ولا أنا إ لا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا”.
وكذلك الحديث الذي أورده ابن كثير.
قال الحافظ تعليقاً على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: “لن ينجي أحداً منكم عمله” قال المازري: ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منه، وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منه، ولا يثبت واحد منها إلا بالسمع، وله سبحانه أن يعذب الطائع، وينعم العاصي، ولكنه أخبر أنه لا يفعل ذلك، وخبره صدق لا خلف فيه.
وهذا الحديث يقوي مقالتهم، ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمال، ولهم في ذلك خبط كثير وتفصيل طويل.[2]
وقال الحافظ في “الكلام” على قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة) والمراد بالوجوب الثبوت، إذ هو في صحة الثبوت كالشيء الواجب.
والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله. لا يُسأل عما يفعل.[3]
فهذه شواهد الكتاب والسنة وأقوال الأئمة شاهدة لما قاله الأشاعرة وليست المسألة مرتبة على ما قاله الدكتور، ولا أدري هل الدكتور بعد وقوفه عليها يصر على استنكاره أم يتوب عنه؟!
55-مسألة جواز تكليف ما لا يطاق:
العاشر: قوله: “وجواز التكليف بما لا يطاق”.
أقول: لا بد أولاً أن نحرِّر مسألة التكليف بما لا يطاق ونبين مذهب الأشاعرة فيها.
فنقول: ما لا يطاق ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: ما امتنع لذاته كجمع النقيضين، وكجعل القديم محدثاً، المرتبة الثانية: ما أمكن في نفسه، ولم يقع متعلقاً لقدرة العبد أصلاً كخلق الأجسام، أو عادة كالصعود إلى السماء وحَمْلِ الجبال. المَرتَبة الثالثة: وهو أدنى المراتب: ما يمتنع بسبب علم الله تعالى بعدم وقوعه، أو لإرادته ذلك، أو لإخباره بذلك.
وهذا القسم الأخير لا خلاف في وقوع التكليف به فضلاً عن الجواز، فإن من علم الله تعالى بموته على الكفر ومن أخبر الله بعدم إيمانه مكلفان عاصيان إجماعاً.
والمرتبة الوسطى هو الذي وقع النزاع في جواز التكليف به، بمعنى طلب تحقيق الفعل والإتيان به، واستحقاق العقاب على تركه، فجوَّزه الأشاعرة، ومنعه المعتزلة.
وتجويز الأشاعرة مبني على مذهب أهل السنة من أنه لا يجب على الله تعالى شيء ولا يقبح منه شيء، فقالوا بناء على هذا الأصل: إنه تعالى لا يجب عليه عدم تكليف الناس بما لا يطيقون، بل يجوز عليه ذلك، ولو فرض وقوع هذا التكليف منه تعالى لم يكن قبيحاً منه تعالى، لأنه تعالى لا يقبح منه شيء.
ثم هذا الخلاف إنما هو في جواز الوقوع لا في الوقوع، قال التفتازاني: وأما الوقوع فمنفي بحكم الاستقراء، وبشهادة مثل قوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)[4]
وقال الغزالي: ومن جوَّز تكليف ما لا يطاق عقلاً فإنه يمنعه شرعاً.[5]
هذا هو مذهب الأشاعرة في المسألة، وهو مبني على أنه لا يجب على الله شيء وقد قدمنا آنفاً أن هذا الأصل مؤيد بدلائل الكتاب والسنة. وليس مذهبهم مرتباً على ما قاله الدكتور سفر. فهل بعد وقوف الدكتور على حقيقة القضية لا يزال يصر على استنكاره لها؟!
الحادي عشر: دعوى الدكتور أن المسألتين الآنفتين مرتبتان على ما قاله باطلاً: «من أن الأشاعرة جعلوا أفعاله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة، ولا تعلق لصفة أخرى – كالحكمة – بها» فإن نسبة هذا الجعل إلى الأشاعرة خطأ كما تقدم، فكيف يبنون عليه أمراً آخر، وقد ذكرنا مبنى هاتين المسألتين عند الأشاعرة.
الثاني عشر: قوله: “وسبب هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم ألا تعارض بين المشيئة والحكمة، أو المشيئة والرحمة” أقول: أولاً: إن هذا التأصيل هو تأصيل الدكتور سفر وليس بتأصيل الأشاعرة كما حققنا. وأقول ثانياً: إن الأشاعرة قد فهموا جيداً أنه لا تعارض بين صفاته تعالى، وأصَّلوا على كل منها ما يبني عليها من المسائل العقدية، ولكن الدكتور سفر لم يفهم لا الأصل ولا المؤصل ولا التأصيل.
الثالث عشر: قوله: “ولهذا لم يثبت الأشاعرة الحكمة مع الصفات السبع، واكتفوا بإثبات الإرادة” أقول: أما أن الأشاعرة لم يثبتوا الحكمة مع الصفات السبع فصحيح، وأما أن عدم إثباتهم لها معها مبني على عدم الفهم الذي ادعاه الدكتور سفر فواضح أنه باطل، لأن ما ادَّعاه من عدم فهمهم أن لا تعارض بين المشيئة والحكمة باطل ليس له أصل من الصحة، فكيف يبنون عليه غيره؟! نعم السبب في عدم ذكرهم للحكمة مع الصفات السبع أن الحكمة راجعة إلى صفات الأفعال، والصفات السبع صفات الذات، أو أنها راجعة إلى العلم. الذي هو من صفات الذات.
قال ابن الأثير في “النهاية” في أسماء الله تعالى الحَكَم والحكيم، هما بمعنى الحاكم، وهو القاضي والحكيم فعيل بمعنى فاعل، أو هو الذي يُحْكِم الأشياءَ ويُتْقِنُها، فهو فعيل بمعنى مفعل، وقيل: الحكيم ذو الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم ، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم.
فالحكمة إما بمعنى القضاء، أو بمعنى إحكام الأشياء، وإتقانها. وهما صفتا فعل، أو بمعنى معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. وهي صفة ذات.
[1] التفسير لابن كثير 3/419.
[2] فتح الباري 11/397.
[3] فتح الباري 3/339.
[4] شرح المقاصد 3/155.
[5] المستصفى 1/73.