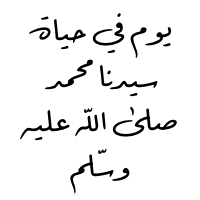نسبة الغزالي إلى الإمام أحمد أنه أوَّل ثلاثة أحاديث،تقسيم الأشاعرة لأصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة أقسام وبيان ذلك بوجه مفصل،أخطء الدكتور
64 – نسبة الغزالي إلى الإمام أحمد أنه أوَّل ثلاثة أحاديث:
الخطأ العاشر والحادي عشر: قوله: (أما دعوى أن الإمام أحمد استثنى ثلاثة أحاديث، وقال: لابد من تأويلها، فهي فرية عليه افتراها الغزالي في “الإحياء” وفيصل التفرقة، ونفاها شيخ الإسلام سنداً ومتنا) هكذا قال الدكتور، وأنا أنقل كلام الغزالي بنصه كي يعلم القارئ الحقيقة، هل حقيقةً افترى الغزالي على الإمام أحمد، أم أن هذا الكلام افتراءٌ على الغزالي؟! وأنقل كلام ابن تيمية المتعلق به ليعلم هل نفى ابن تيمية هذه الدعوى سنداً ومتنا، أم انتقدها سنداً فقط.
قال الغزالي في “إحياء علوم الدين”: (وغلا الآخرون في حسم الباب -أي باب التأويل- منهم أحمد بن حنبل، حتى منع تأويل قوله تعالى: (كن فيكون) وزعموا (أي أتباعه) أن ذلك خطابٌ بحرف وصوت يوجد من الله في كل لحظة عند كون كل مكون. حتى سمعت بعض أصحابه يقول: حَسَمَ بابَ التأويل إلا لثلاثة ألفاظ: قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (الحجر الأسود يمين الله في أرضه) قال العراقي أخرجه الحاكم وصححه.
وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن) أخرجه مسلم.
وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن) أخرجه أحمد ورجاله ثقات. قاله العراقي.
هذا كلام الغزالي بنصه ما عدا التخريج، وقد علمت أن الغزالي لم ينسب هذا القول إلى الإمام أحمد مباشرة، ولا بصيغة التضعيف، كأن يقول: قال أحمد، أو روي عن أحمد أنه قال، وإنما نسبه إليه عن طريق سماعه عن بعض أصحابه. ويقصد ببعض أصحابه بعض علماء مذهبه كما هو اصطلاح الفقهاء وغيرهم، ولم يقصد بعض الذين صحبوه، لوضوح أن الغزالي لم يدرك أصحاب أحمد، ولا أصحاب أصحابه. والغزالي ثقة ثبت فوقع الحمل في هذه الرواية على بعض أصحاب أحمد، فهل يصح بعد هذا أن يقال: إن الغزالي افترى هذه الدعوى على أحمد؟!
وابن تيمية لم ينسب الكذب في هذه الدعوى إلى الغزالي، بل جعل الحمل فيها على بعض الأصحاب الذي نقل الغزالي التأويل عنه، قال: (فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف لا علمه بما قال، ولا صدقه فيما قال)[1] هذا كلام ابن تيمية، ولم ينتقد هذه الرواية متناً وإنما انتقدها سنداً فقط.
بل قد أوَّل ابن تيمية الحديث الأول والثالث في “مجموع الفتاوى” فراجعها،[2] ولكن الدكتور لا يُجوِّز تأويل هذه الأحاديث، فأقول للدكتور: هل تعتقد أن الحجر الأسود يمين الله حقيقة أي يده اليمنى، وأن يمين الله الوارد في بعض الأحاديث عبارة عن الحجر الأسود، وأن الله خلق آدم بيديه اللتين إحداهما الحجر الأسود، حيث قال تعالى: (يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) أو كلتاهما الحجر الأسود كما ورد في الحديث الصحيح «وكلتا يديه يمين» وهل تعتقد أن لله تعالى مليارات الأصابع، وأن بداخل كل مؤمن إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا مجازا مكتنفتين بقلبه؟ وإذا كنت تعتقد ذلك فهل تحس بأن بداخلك إصبعين محيطتين بقلبك؟!
وهل تعتقد أنه حينما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن)، كان الله تعالى في جانب اليمن، فوجد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نفسه حقيقة لا مجازاً من جانب اليمن؟! لا شبهة عندي في أن الدكتور لا يعتقد شيئا من ذلك، فالدكتور إذاً يحمل هذه الأحاديث على معانيها غير الحقيقة. وهذا هو تأويل الذي أنكره على الأشاعرة.
ثم إنه قد جاء التأويل عن الإمام أحمد في غير هذه الأحاديث، وقد نقلنا اثنين منها فيما تقدم، ونعززهما هنا بثالث:
روى الذهبي عن صالح ابن الإمام أحمد -رحمه الله- عن أبيه أن المعتزلة احتجوا عليه وقت المحنة بحديث ابن مسعود: (ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي) قال: فقلت: إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض، ولم يقع على القرآن.[3]
الخطأ الثاني عشر: تسوية الدكتور بين الأشاعرة والباطنية في التأويل، وقوله أخيرا: (ولماذا يكفر الأشاعرة الباطنية ثم يشاركونهم في أصل عظيم من أصولهم؟)
أقول للدكتور أولا: اتق الله، وتذكَّر قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا يهوى بها في النار سبعين خريفا) أو كما قال.
ثم أقول له: تذكَّر ما نقلناه عن تاج الدين السبكي وهو من الأشاعرة قال في “جمع الجوامع” (الظاهر ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حُمل لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل) وتأويل الأشاعرة وغيرهم من المسلمين من التأويل لدليل، وأما تأويلات الباطنية فمن اللعب بنصوص الشارع، فهل يصح لمؤمن يرجو الله واليوم الآخرة أن يقول: إن الأشاعرة قد شاركوا الباطنية في أصل من أعظم أصولهم؟؟!!
فإن التأويل الذي قال به الأشاعرة لم يتخلص ولن يتخلص منهم أحدٌ من المسلمين بما فيهم الدكتور سفر.
65- تقسيم الأشاعرة لأصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة أقسام وبيان ذلك بوجه مفصل:
قال الدكتور: {الثاني عشر: السمعيات: يُقسِّمُ الأشاعرةُ أصولَ العقيدةِ بحسبِ مصدر التلقي إلى ثلاثة أقسام:
1- قسم مصدره العقلُ وحدَه وهو معظمُ الأبواب ومنهُ بابُ الصفات، ولهذا يسمُّونَ الصفاتِ السبعَ “عقلية”. وهذا القسمُ “هو ما يحكُمُ العقلُ بوجوبه” دونَ توقفٍ على الوحيِ عندَهُمْ.
2- قسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية –على خلاف بينهم فيها- وهذا القسم هو ما يحكم العقل بجوازه استقلالا أو بمعاضدة الوحي.
3- قسمٍ مصدره النقلُ وحدَهُ، وهو السمعيات أي: المغيبات من أمور الآخرة كعذاب القبر والصراطِ والميزانِ، وهو عندَهُم ما لا يَحْكُمُ العقلُ باستحالته، لكنْ لو لم يرد به الوحيُ لم يستطعِ العقلُ إدراكَهُ منفرداً، ويُدْخلونَ فيه التحسينَ والتقبيحَ والتحليلَ والتحريم.
والحاصل أنهم في صفات الله جعلوا العقل حاكما، وفي إثبات الآخرة جعلوا العقل عاطلا، وفي الرؤية جعلوه مساويا. فهذه الأمور الغيبية نتفق معهم على إثباتها، لكننا نخالفهم في المأخذ والمصدر. فهم يقولون عند ذكر أي أمر منها: نؤمن به لأن العقل لا يحكم باستحالته ولأن الشرع جاء به. ويكررون ذلك دائما.
أما في مذهبِ أهلِ السنةِ والجماعة فلا منافاةَ بين العقل والنقل أصلاً، ولا تضخيمَ للعقلِ في جانبٍ. وإهدارَ في جانبٍ؛ وليسَ هناك أصلٌ من أصولِ العقيدةِ يستقلُّ العقلُ بإثباته أبداً؛ كما أنه ليس هناك أصلٌ منها لا يستطيعُ العقلُ إثباتَهُ أبداً.
فالإيمانُ بالآخرة وهو أصلُ كلِّ السمعياتِ ليس هو في مذهب أهل السنة والجماعة سمعياً فقط، بل إن الأدلة عليه من القرآن هي في نفسها عقلية كما أنَّ الفطرَ السليمةَ تشهدُ به، فهو حقيقةٌ مركوزة في أذهانِ البشر ما لم يُحَرِّفْهُم عنها حارف.
لكن لو أنَّ العقلَ حكمَ باستحالة شيءٍ من تفصيلاته – فرضاً وجدلاً – فحكمُهُ مردودٌ؛ وليس إيمانُنا به متوقفاً على حكمِ العقل. وغايةُ الأمر أنَّ العقلَ قد يعجزُ عن تصوره، أمّا أن يحكمَ باستحالته فغيرُ واردٍ، وللهِ الحمدُ}
أقول: هذا التقسيم الثلاثي لأصول العقيدة الذي ذكره الدكتور ناسباً له إلى الأشاعرة هو من المقررات عند الأشاعرة، وقد ذكره إمام الحرمين في “الإرشاد”، وبينه بياناً وافياً لا يصح لمن يفهم كلامه أن يرتاب في صحة هذا التقسيم فضلاً عن أن ينتقده أو ينكره!
والدكتور قد اطلع على بيان إمام الحرمين، فإن “الإرشاد” أول مراجعه التي أوردها في التعليق، لكن الدكتور لم يفهم هذا البيان، ولا أدري هل لم يستطع فهمه لأنه لم يتمرن على فهم كلام الأشاعرة لدقته وعلوه عن فهمه، أم أنه لم يتجشم فهمه على وجهه كي يتسنى له النقد والإنكار الذي هو مغرم به؟؟!!
وأنقل كلام إمام الحرمين بنصه، ثم أعقبه بتوضيح له، ثم أعود إلى كلام الدكتور، وإلى بيان ما حواه من أخطاء.
قال إمام الحرمين: (إعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلاً ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. وإلى ما يدرك سمعاً ولا يتقدر إدراكه عقلا. وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا. فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صادقا، إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى؛ وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبا فيستحيل أن يكون مدركه السمع.
وأما ما لا يدرك إلا سمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه، ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع، ويتصل بهذا القسم عندنا جملة أحكام التكليف وقضاياها من التحسين والتقبيح والإيجاب والحظر والندب والإباحة.
وأما ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول، ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه. فهذا القسم يتوصل إلى دركه بالسمع والعقل. ونظير هذا القسم إثبات جواز الرؤية، واثبات استبداد الباري تعالى بالخلق والاختراع، وما ضاهاهما مما يندرج تحت الضبط الذي ذكرناه. فأما كون الرؤية ووقوعها فطريق ثبوتها الوعد الصدق والقول الحق) هذا كلام إمام الحرمين.[4]
وإيضاحاً له أقول: السمع هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن لا يثبت كونه كلام الله تعالى إلا بعد ثبوت وجود الله تعالى وثبوت اتصافه بالحياة والعلم والإرادة والقدرة، وكذلك بعد ثبوت صدق الرسول المخبر بأن القرآن كلام الله تعالى في دعواه النبوة بالدلائل الدالة على صدقه في دعواه هذه، والسنة لا يثبت كونها حجة على الناس فيما احتوت عليه من الأحكام إلا بعد ثبوت صدق الرسول في دعواه النبوة، فكون القرآن كلام الله تعالى وكونه حجة على الناس، وكون سنة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حجة على الناس كل منهما متوقف على ما ذكرناه، فلو حاولنا الاستدلال على شيء مما يتوقف عليه حجية الكتاب والسنة بالكتاب والسنة يلزم الدور. وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء، المستلزم لتقدم الشيء على نفسه. وهل يقدم عاقل على الاستدلال على وجود الله واتصافه بتلك الصفات، وعلى صدق الرسول في دعواه الرسالة على من لا يعترف بذلك، بالكتاب والسنة، وإذا حاول بعض الناس الاستدلال بهذا الطريق على الخصم المذكور فماذا عسى أن يكون موقف هذا الخصم من هذا المستدل؟ ألا يحكم عليه بالجهل بطرق الاستدلال؟
فمعنى أن مدرك هذه العقائد هو العقل فقط أنه لا يصح الاستدلال على ثبوتها على من لا يعترف بها، إلا بالعقل، وليس معناه أن الشرع لا يدل على ثبوتها، وأما المؤمن فلا يكون مؤمنا إلا باعتقادها، فلا يتصور بالنسبة إليه الاستدلال عليه بالسمع.نعم يكون توارد الأدلة السمعية على ما اعتقده مقويا لاعتقاده
نعم وجوب اعتقاد هذه العقائد إنما يثبت عند الأشاعرة بالسمع لا بالعقل، لأنه لا حكم عندهم للعقل بشيء من الأحكام الشرعية -ومنه وجوب اعتقاد هذه العقائد- قبل ورود الشرع، فوجوب اعتقاد هذه الأمور أمر، وإدراكها أي معرفتها أمر آخر. فالأول لا يدرك إلا بالشرع، والثاني لا يدرك إلا بالعقل. فإذا ورد الشرع وبلغت الدعوة إلى المكلف فقد استقرت عليه كل الواجبات وثبتت التكاليف، ومنها هذه العقائد، فقد وجب عليه شرعا أن يدرك هذه العقائد بالعقل ويعتقدها، فوجوب اعتقاد هذه العقائد شرعي، وأما إدراكها ومعرفتها فطريقه العقل، لأن الشرع وإن كان قد ثبت عليه ببلوغ الدعوة، لكنه لم يثبت عنده بعد، فلا يصح له أن يستدل لنفسه، ولا أن يستدل غيره عليه لإثبات هذه العقائد بالشرع، لأن الدليل لابد أن يكون من المسلمات عند الخصم، والشرع لم يثبت عنده بعد. وإن كان قد ثبت عليه.
فالواجب على المكلف عند بلوغ الدعوة إليه أن يستدل على هذه العقائد بالعقل، إما بأن يستدل على كل واحد منها بدليل عقلي يثبتها، أو يكتفي بالدليل العقلي الدال على صدق الرسول في دعواه الرسالة، فإنه بهذا الدليل يثبت صدقه، ويثبت صحة كل ما أخبره عن الله تعالى، ومنها هذه العقائد، فالدليل على ثبوت هذه العقائد في هذه الصورة يكون أيضا عقليا، وهو دليل صدق الرسول في دعواه.
ومن أجل ذلك كان طريقة القرآن عند ما يخبر عن هذه العقائد أن يستدل عليها بالدلائل العقلية، فالإخبار بها يؤخذ منه حكم شرعي بوجوب اعتقادها، وأما إدراكها ومعرفتها، وإذعان العقل لها فيكون عن طريق هذه الدلائل العقلية التي أوردها القرآن استدلالاً على ثبوتها.
وأما عند المعتزلة وجمهور الماتريدية: فوجوب اعتقاد هذه العقائد ثابت بالعقل قبل ورود الشرع بها، وقبل بلوغ الدعوة إلى المكلف. والخلاف هنا مبني على الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين، فالمعتزلة ذهبوا إلى أن أفعال المكلف مشتملة على صفة من الحسن والقبح توجب ورود الحكم الشرعي على حسبها في الأصول والفروع قبل مجئ الشرع، والعقل قد يدرك صفة الحسن والقبح من الفعل فيدرك عندها الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة من الوجوب والندب والحظر والإباحة؛ وقد لا يدرك العقل ذلك فيتوقف عن الحكم حتى يرد الشرع به. فالشرع عندهم مؤيد فيما أدركه العقل من الأحكام، ومبين فيما لا يدركه منها.
والأشاعرة: نفوا صفة الحسن والقبح عن الفعل قبل ورود الشرع رأسا، وقالوا: لا حَسَنَ إلا ما ورد الشرع بحسنه، ولا قبيح إلا ما ورد الشرع بقبحه، ومن أجل ذلك نفوا أن يكون لله تعالى حكم في فعل من أفعال المكلف قبل ورود الشرع لا في الأصول ولا في الفروع.
وأما الماتريدية فتوسطوا بين المذهبين، فأثبتوا للفعل أصل صفة الحسن والقبح، المقتضيين لورود الشرع بحسبهما عند وروده، وأما قبل ورود الشرع فلم يثبتوا الحكم الشرعي في الفروع، واختلفوا في ثبوته في الأصول التي مدركها العقل دون الشرع، فأثبته معظمهم فيها، ولم يثبته الآخرون.
وأما العقائد التي لا يتوقف ثبوت السمع من الكتاب والسنة على ثبوتها مما يجوز للعقل أن يدركها ورد الشرع بها أم لم يرد. وذلك كجواز رؤية الله تعالى، واستبداد الله تعالى بالخلق والاختراع، فيصح الاستدلال عليها بالعقل والشرع، فتستدل عليها بالعقل فقط على غير المؤمن بالشرع ، وبالشرع والعقل معا على المؤمن بالشرع، وأما نفس رؤية الله فلا تثبت إلا بالشرع.
وأما الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية فلا سبيل إلى إدراكها عند الأشاعرة إلا الشرع، ولا يستقل العقل بإدراك شيء منها قبل ورود الشرع. وقالت المعتزلة: قد يستقل العقل بإدراكها في الأصول والفروع، وقال جمهور الماتريدية: يستقل العقل بإدراكها في الأصول دون الفروع.
هذا توضيح كلام إمام الحرمين، وأرى أن المسألة قد وضحت وضوحاً تاما. وبعد هذا الإيضاح نعود إلى كلام الدكتور، فنقول وبالله التوفيق:
66- ما حواه كلام الدكتور من الأخطاء:
قد احتوى كلام الدكتور في هذه المسألة -كما هو الحال في سائر المسائل- على أخطاء كثيرة جسيمة:
الخطأ الأول: قوله: («1» قسم مصدره العقل وحده، وهو معظم الأبواب، ومنه باب الصفات)
أقول: قد علمت أن هذا القسم مقصورٌ على العقائد التي يتوقف ثبوت السمع على ثبوتها، وليس بجارٍ في معظم الصفات، فضلاً عن جريانه في معظم الأبواب. قال البيهقي في “الإعتقاد”: (فصفات ذاته ما يستحقه فيما لم يزل ولا يزال، وهي على قسمين: أحدهما عقلي، والآخر سمعي. فالعقلي ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به… وأما السمعي فهو ما كان طريق ثبوته الكتاب والسنة فقط)[5]
الخطأ الثاني: قوله: (وهذا القسم هو ما يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحي عندهم)
أقول: بل هذا القسم هو ما يحكم العقل بوجوده وثبوته، ولا يصح الاستدلال على ثبوته بالشرع، مع أن الشرع قد ورد به، وذلك لما ذكرناه من لزوم الدور، وأما وجوب اعتقاد هذه العقائد فمأخوذ من الشرع فقط عند الأشاعرة كما قدمناه، ولا أدري ماذا أقول لهذا الدكتور الذي يخلط بين الوجود والوجوب، ولا يفرق بينهما!!! فإن الوجود أمر واقعي، والوجوب حكم شرعي.
الخطأ الثالث والرابع والخامس والسادس: قوله: («2» قسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية – على خلاف بينهم فيها- وهذا القسم هو: “ما يحكم العقل بجوازه استقلالا أو بمعاضدة الوحي”)
فالخطأ الثالث تمثيله لهذا القسم بالرؤية مع أن المثال الصحيح هو جواز الرؤية. وأما الرؤية نفسها فمدركها الشرع فقط كما تقدم، فالدكتور لا يفرق بين الرؤية نفسها وبين جوازها، فمن أجل ذلك وقع في هذا الخطأ والخطأ الرابع: وهو قوله: (على خلاف بينهم فيها) لما رأى إمام الحرمين جعل جواز الرؤية من القسم الثاني، وجعل الرؤية نفسها من القسم الثالث، ظن أن هذين قولان في الرؤية نفسها. والخطأ الخامس: قوله: (وهذا القسم هو: ما يحكم العقل بجوازه استقلالا أو بمعاضدة الوحي) فقوله: (أو بمعاضدة الوحي) خطأ، فإن هذا القسم يحكم العقل بجوازه استقلالا، ويحكم الشرع أيضا بجوازه استقلالا، وكلام الدكتور يفيد أن العقل قد لا يستقل بالحكم بجوازه، بل إنما يحكم بذلك بمعاضدة من الشرع.
وقد ترتب على عدم التفرقة بين الرؤية وجوازها خطأ سادس، حيث عبر بقوله: (وهذا القسم هو ما يحكم العقل بجوازه) وقد علمت أن مثال هذا القسم هو جواز الرؤية لا الرؤية، فكان الصواب أن يقول: (وهذا القسم هو ما يحكم العقل به…) ولكن الدكتور حيث أخطأ في التمثيل اضطر إلى أن يخطأ في التعبير أيضا ويقول: (هو ما يحكم العقل بجوازه)
الخطأ السابع والثامن: قوله: (والحاصل أنهم في الصفات جعلوا العقل حاكما، وفي إثبات الآخرة جعلوا العقل عاطلا) فالأشاعرة لم يجعلوا العقل حاكما في الصفات كلها، بل في بعضها، وهو ما توقف ورود الشرع على ثبوته، دون غيرها، ولم يعطلوا العقل في إثبات الآخرة، بل جعلوا تجويز العقل لها إحدى مقدمات دليل إثباتها، حيث يقولون: هذا أمر قد جوزه العقل وورد به السمع، فلابد من اعتقاد ثبوته.
الخطأ التاسع: قوله على وجه الإنكار على الأشاعرة: (فهم يقولون عند ذكر أي أمر منها: نؤمن به لأن العقل لا يحكم باستحالته ولأن الشرع جاء به، ويكررون ذلك دائما) أقول: يقصد الأشاعرة بهذا الكلام أنه لو كان العقل حكم باستحالة هذا الأمر حكماً قاطعا، وفرض أن ظاهر الشرع قد جاء به، لم نحكم بثبوت هذا الأمر، لأن الشرع لا يرد بما يخالف صرائح العقول، بل الواجب حينئذ تأويل ظاهر الشرع، وصرفه إلى معنى صحيح لا يحيله العقل، وما الذي يستنكر من هذا الكلام؟؟!!
وابن تيمية نفسه قد استعمل في الاستدلال هذا المعنى فقال في “التدمرية” مناقشاً للمعتزلة في بعض المسائل: (وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم)[6]
فلماذا تستنكر أيها الدكتور قول الأشاعرة المذكور، ولم تنتقد قول ابن تيمية هذا، والمعنى واحد؟؟!!
الخطأ العاشر: قوله: (وأما في مذهب أهل السنة فلا منافاة بين العقل والنقل أصلا، ولا تضخيم للعقل في جانب وإهدار في جانب)
أقول: هذا الكلام إذا قطع عن سياقه كلام قويم، والخطأ فيه أن الدكتور قصد به أن الأشاعرة قد حكموا بتقسيمهم الثلاثي المتقدم بالمنافاة بين العقل والنقل، وأنهم قد ضخموا العقل في هذا التقسيم في جانب يجب عدم تضخيمهم له فيه، وأهدروه في جانب يجب استعمالهم له فيه.
مع أنه ليس في هذا التقسيم أي حكم بالمنافاة بين العقل والنقل، بل ما فعلوه في هذا التقسيم إنما هو استعمال لكل من العقل والنقل في مجاله الذي يجب أن يستعمل فيه، وإهمال لكل منهما في المجال الذي لا مجال له فيه. وهذه هي الحكمة التي أوتيها الأشاعرة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
الخطأ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: قوله: (ليس هناك أصول من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبدا، كما أنه ليس هناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبدا)
الخطأ الأول في هذا الكلام نسبة الأمرين المذكورين إلى مذهب أهل السنة، وليت شعري من هم أهل السنة القائلون بهذين الخطأين العظيمين؟! نعم من عادة الدكتور أن يجعل كل ما يهويه مذهبا لأهل السنة!!!
الخطأ الثاني: قوله: (وليس هناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبدا)
وقد علمت أن العقل يستقل بإثبات ما يتوقف صحة النقل عليه من العقائد، ومعظم الفلاسفة قد آمنوا بذلك عن طريق العقل المجرد، وإن كان مراد الدكتور أنه ليس هناك أصل من أصول العقيدة يثبته العقل ولا يثبته السمع، فالمعنى صحيح لكن اللفظ لا يفيد ذلك.
الخطأ الثالث: قوله: (كما أنه ليس هناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبدا)
وقد علمت أن وجوب الواجبات مما لا يستقل العقل بإثباته أبدا. وكذلك السمعيات كلها لا يستقل العقل بإثباتها، والعقل يجوزها فقط، وإما ثبوتها وتحققها فلم يدل عليه إلا السمع، ثم إن هذين الحكمين من الدكتور مع كونهما خطأين هما حكمان متناقضان، أثبت الدكتور في كل منهما ما نفاه في الآخر!!!
الخطأ الرابع عشر والخامس عشر: قوله: ( فالإيمان بالآخرة – وهو أصل كل السمعيات- ليس في مذهب أهل السنة والجماعة سمعيا فقط، بل الأدلة عليه من القرآن كلها عقلية)
الخطأ الأول أيضا في نسبة هذا القول إلى أهل السنة والجماعة على عادته في نسبة ما يهواه إليهم!
الخطأ الثاني: حكمه بأن الأدلة على الإيمان بالآخرة من القرآن كلها عقلية، وذلك أن كل ما ورد في القرآن من الأدلة العقلية المتعلقة بالحشر إنما تدل على إمكانه، وترد استبعاد الكافرين لوقوعه، وأقرأ الآيات الأخيرة من سورة يس، وهي أوضح ما ورد في القرآن من الدلائل المتعلقة بالحشر،هل ترى فيها غير إثبات الإمكان، وتزييف استبعاد وقوعه من الكافرين المنكرين لوقوعه.
وأما إثبات وقوع الحشر فلا يتم إلا بضم الدليل السمعي – وهو إخبار لله تعالى بوقوعه- إلى تلك الأدلة العقلية.
ولكن الدكتور لا يفرق بين جواز الوقوع، ونفس الوقوع فمن أجل ذلك تورط في هذا الخطأ!
الخطأ السادس عشر: قوله: (لكن لو أن العقل حكم باستحالة شيء من تفصيلاته –فرضا وجدلا- فحكمه مردود)
أقول: كيف يكون حكم العقل بالاستحالة مردودا؟ هذا كلام من لا يعرف أن استحالة العقل ما هي. نعم قد يكون العقل واهماً في الحكم بالاستحالة مع أنه لا استحالة في الواقع، وهذا الحكم الوهمي هو الذي يجوز أن يُرَدَّ ببيان وهم العقل في هذا الحكم، وأما استحالة العقل فلا يرفضها إلا رافض لعقله.
وقد قال إمام الحرمين: إن العقل عبارة عن معرفة وجوب الواجبات، وجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات. وهل يجوز أن يرد الشرع بما تحيله العقول؟! وقد ناقض الدكتور نفسه بقوله عقب هذا الكلام –وهو كلام حق-: (وغاية الأمر أن العقل قد يعجز عن تصوره، وأما أن يحكم باستحالته فغير وارد. ولله الحمد)
الخطأ السابع عشر: قوله: (وليس إيماننا به متوقفا على حكم العقل)
أقول: إيماننا بكل ما نؤمن به متوقف على حكم العقل بعدم استحالته، ثم ورود الشرع به. ولو حكم العقل حكماً صحيحاً قاطعاً باستحالة أمر، وفرض أن ظاهر الشرع ورد به، فلا نؤمن بما يدل عليه هذا الظاهر، ونؤل هذا الظاهر، ونصرفه إلى معنى صحيح يقبله العقل ولا يحيله، فإن الشرع لا يرد بما تحيله العقول.
[1] مجموع الفتاوى 5/398.
[2] 6/397-398.
[3] سير أعلام النبلا 11/246 10/578.
[4] الإرشاد 301-302.
[5] 31.
[6] التدمرية 23.