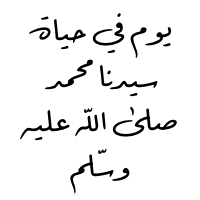الاستدلال بخبر الواحد في العقيدة
الاستدلال بخبر الواحد في العقيدة
قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية
20/10/2008
الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد الذي أُرْسِل رحمة للعالمين، والذي بَلَّغ رسالةَ ربِّه كما أُمِر، وأيَّده اللهُ بالمعجزات الباهرة الناطقة بصدقه، وعَصَمَه اللهُ مِن كلِّ زلل ومعصية، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإنه قد قرَّر علماء التوحيد أن من شروط الإيمان والاعتقاد الصحيح أن يكون قائما على اليقين، لا على الشوائب من الظن والتقليد.
فالاعتقاد الصحيح يجب أن يُسلَك فيه مسالك اليقين، والظن والتقليد يخالفانه.
وعلى ذلك فالعقيدة لا تُؤْخَذ إلا من دليل قطعي، ولا يجوز أن تُؤْخَذ من دليل ظني، فغير الدليل القطعي لا يصح بناء العقيدة عليه، بل يستحيل عقلا؛ لأن الاعتقاد جَزْم لا يقبل التردد، فإذا بُنِي على ما يحتمل الخطأ مهما قلّ الاحتمال لم يكن اعتقاداً أصلا، فبين الأمرين تناقض تام؛ قال الله تعالى: {إِنَّمَا الـمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [الحجرات: 15].
يقول السفاريني الحنبلي: “واعتبر في أدلتها اليقين؛ لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات، بل في العمليات”([1]).
فلا توجد قضايا عقدية أساسية انفرد الدليل الظني – كخبر الآحاد – بإثباتها وليس لها أصلٌ في القرآن الكريم أو السنة المتواترة، سواء أكان تواترًا لفظيًّا أم معنويًّا، فإذا ثبت أصلُ القضية العقدية بالقرآن الكريم أو السنة المتواترة فتقبل أخبار الآحاد الصحيحة في تفاصيلها وفروعها.
وهذا القول يُثَبِّت العقيدة ويُنقيِّها من كل شائبة، ويجعلها في أمن من التناقض والعبث، فهو ليس قولاً يُشكِّك في العقيدة أو يَحُطُّ من قيمتها بل يرفعها.
تمهيد
– الاعتقاد: هو التصديق الجازم، فإذا ما جزم المدرِك بأن ما أدركه هو مطابقٌ للواقع قطعًا، ولم يقترن جزمه هذا بالدليل القاطع على أنه مطابقٌ للواقع كان هذا هو ما يسمى بـ”الاعتقاد الجازم” أو “الإيمان”، فإن اقترن جزمه بالدليل القاطع فهو اليقين، ومرادنا بـ”الاعتقاد الصحيح”: العلم اليقيني الجازم الثابت([2]) الذي لا يقبل التشكيك.
وقد لا يكون هذا الاعتقاد في حقيقة الأمر – أي: في نفس الأمر – مطابقاً للواقع فيكون حينئذٍ اعْتِقَادًا فاسدًا.
العِلْم
يُطلَق العلم على عدة أمور:
أولا: يُطلَق حقيقة على ما لا يحتمل النقيض, وحَدُّهُ: “صفةٌ تُوجِب تمييزًا لا يَحْتَمِل النقيض”.
فالعِلْم صفة، أي: أمْرٌ قائم بالنفس، يُوجِب للنفس – إيجابًا عاديًّا – صورةً أو إثباتًا أو نفيًا([3]) به تُميز النفسُ الشيءَ عمَّا عداه تمييزًا لا يحتمل ذلك الشيء – الذي تعلَّق به التمييز – نقيض الصورة أو الإثبات أو النفي([4]).
فالعِلْم ليس نفس الصورة أو النفي أو الإثبات، بل هو صفة حقيقة ذات إضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال الحواس أو العقل أو الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلَّقت بها.
وقيد “لا يَحْتَمل النقيض” أخرج الظن([5]) والشك والوهم؛ لأنهم يحتملون النقيض في الحال، وأخرج الجهل المركب والتقليد؛ لأنهما يحتملانه في المآل.
ثانيا: أنه يُطلق ويُراد به مجرَّد الإدراك، يعني سواء أكان الإدراك جازما, أم مع احتمال راجح, أم مرجوح, أم مساو على سبيل المجاز.
فشمل الأربعة قوله تعالى {مَا عَلِمْنَا عَلَيهِ مِنْ سُوءٍ} [يوسف: 51]؛ إذ المراد نفي كل إدراك.
ثالثها: أنه يُطلَق ويُراد به التصديق، سواء أكان التصديق قطعيًّا أم ظنيًّا.
أما التصديق القطعي فإطلاقه عليه حقيقة، وأمثلته كثيرة، وأما التصديق الظني فإطلاقه عليه على سبيل المجاز، ومن أمثلته قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: 10]؛ لأن العِلْم القطعي في ذلك لا سبيل إليه.
رابعها: أنه يُطلَق ويُراد به معنَى المعرفة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {لا تَعْلَمُهْم نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} [التوبة: 101]، وكذلك تُطلَق المعرفة ويُراد بها العلم، ومنه قوله تعالى: {مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ} [المائدة: 83]، أي: عَلِموا، والظنُّ يُطلَق ويُراد به العلم أيضا، ومنه قوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ} [البقرة: 46]، أي: يعلمون.
والمعرفة من حيث إنها عِلْم مستحدث, أو انكشاف بعد لبس أخصُّ من العِلم؛ لأن العلم يشمل غير المستحدث وهو علم الله تعالى، ويشمل المستحدث وهو علم العباد، ومن حيث إن المعرفة يقين وظن أعمُّ من العلم؛ لاختصاص العلم حقيقة باليقيني.
وتُطلَق المعرفة على مجرَّد التصور الذي لا حكمَ معه، فتقابل العلم، وقد تقدَّم أن العِلم يُطلَق على مجرَّد التصديق الشامل لليقيني والظني، وإذا أطلقت المعرفة على التصور المجرَّد عن التصديق كانت قسيما للعلم.
وعلم الله سبحانه وتعالى قديم؛ لأنه صفة من صفاته وصفاته قديمة، وعلمه ليس ضروريًّا ولا نظريًّا بلا نزاع بين الأئمَّة, أحاط بكل موجود ومعدوم على ما هو عليه، ولا يوصف سبحانه وتعالى بأنه عارف.
وعلم المخلوق الحادث قسمان([6]):
قسم ضروري: هو الذي لا يقع عن نظر واستدلال، وسمي بذلك؛ لأنه يُضْطَرُّ إليه بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه بشكٍّ ولا شبهة، كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس الظاهرة.
قال البهوتي الحنبلي: “وحدُّ العِلْم الضروري في اللغة: الحَمْل على الشيء, والإلجاء إليه، وحده في الشرع: مَا لَزِم نفس المكلَّف لزومًا لا يمكنه الخروج عنه”([7]).
وقسم نظري أو مكتسب: هو الموقوف على النظر والاستدلال، فهو ليس ظاهرًا لكل أحد، كالعِلم بحدوث العالم.
– أضداد العلم:
– الظن: ترجيح شخص لأحد الأمرين – هما طرفا الممكن، كوجود زيد وعدم وجوده – بأن يكون أحدهما أظهر من الآخر عنده، سواء أوافق الواقع أم لا، ويُسمَّى الراجح.
أما الظن الغالب فهو في أصله ظنٌّ، لكنه بعد النظر تقوَّى حتى وصل إلى طَرْح الطرف المرجوح والأخذ بالراجح فقط([8]).
– الوهم: إدراك الطرف المرجوح المقابل للظن.
– الشك: التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
– السهو: الذهول عن المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه.
– النسيان: زوال المعلوم بالكلية فيستأنف تحصيله.
– الجهل بنوعيه: المركب: وهو تصور الشيء على غير هيئته، والبسيط: وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية([9]).
أسباب العلم
– قد بيَّن العلماء أسباب العلم اليقيني القطعي الثابتة للخلق، وهي ثلاثة: الحواس السليمة([10])، والعقل، والخبر الصادق.
والمراد أن هذه الثلاثة هي السبب المؤدِّي إلى العِلم والموصِّل إليه في الجملة بأن يخلق اللهُ فينا العِلمَ معه بطريق جري العادة، وسببُ الحصر أن العلماء لـمَّا وجدوا بعضَ الإدراكات حاصلة عقب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شكَّ فيها جعلوا الحواسَ أحدَ الأسباب، وكذلك العقل فقد جعلوه سببًا ثانيًا يُفضي إلى العلم بمجرَّد التفاتٍ أو انضمامِ حدسٍ أو تَجْرِبةٍ أو ترتيبِ مقدِّماتٍ، وكذلك لـمَّا كان أكثر المعلومات الدينية مستفادًا من الخبر الصادق جعلوه سببًا آخر، وتفصيل الأسباب كما يلي:
– السبب الأول: وهو الإدراك الحسي القاطع عن طريق الحواس الخمس الظاهرة، ويأتي منه العلم اليقيني.
مثال ذلك: اعتقادنا بوجود أنفسنا، وبوجود الأرض مِن تحتنا، وبوجود السماء مِن فوقنا، وكذلك مثل اعتقادنا بأن النار محرقة، والشمس مضيئة، والماء له صفة السيلان ينحدر من أعلى إلى أدنى، إلى غير ذلك.
فالشيء الذي له صورة تُدْرَك بالحسِّ الظاهر، العلم بها – أي: الإدراك بها – يكون بانطباع هذه الصورة في نفس المدرِك.
ولقد حثَّ القرآنُ الإنسانَ على استخدام هذا المسلك في آيات كثيرة تدعو الإنسان إلى النظر في السماوات والأرض، وإلى النظر في تكوين نفسه، كقوله تعالى: {وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ للمُوقِنِينَ* وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ} [الذاريات: 20-21]، وكقوله تعالى: {أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ* وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ* وَإِلَى الجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ* وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} [الغاشية: 17-20].
– السبب الثاني: وهو العقل، وذلك عن طريق الاستنتاج العقلي، فالعلم اليقيني.
فكثير من علومنا ومعارفنا التي نعتقد بها اعتقادًا جازمًا، هي من العلوم التي توصَّلْنَا إليها عن طريق الاستنتاج بمسلك منطقي سليم.
كاستنتاجنا مثلاً بأن عدد الألف أكثر من عدد المائة، وأن الكل أكبر من الجزء، فهذا يفيدنا العلم اليقيني قطعًا.
وفي القرآن الآيات الكثيرة التي تحثُّ على التعقل والتفكر وتمجّدهما، كقوله تعالى: {أَفَلا تَعْقِلُونَ}، وقوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}، وقوله تعالى: {لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}.
فوظيفة العقل هي معرفة ماهية وصفة الواقع، ومعرفة الأمر في نفسه على حسب قدرة البشر، من دون ترتيب حكم تكليفي عليها، فنحن نستخدم العقل عن طريق النظر في العالم الخارجي، للتعرُّف على وجود الله، أي على أنَّ الله موجود، ولكنَّ وجوب الإيمان باللـه تعالى بحيث يعاقب مَن لا يؤمن ويثاب مَن يؤمن إنما يُعْرَف من الشَّرع لا من العقل.
فأهل السنة لم يختلفوا في الإقرار بأن العقل يمكنه معرفة بعض الأحكام العقائدية، ولكنهم اتفقوا على أن التكليف بالاعتقاد لا يمكن أن يثبت إلا بالنقل، والدليل الشرعي؛ ولهذا فأهل السنة يستدلون على العقائد بالدليل العقلي، ومرادهم بذلك إثبات حقيقتها ومطابقتها للواقع، لا إثبات التكليف بها بالعقل، فإثبات التكليف بها يكون بالشرع([11]).
– وهذان المسلكان هما الوسيلتان الواضحتان لاكتسابنا المعارف والعلوم المقترنة ببراهينها، وبهما تتحوَّل العلوم اليقينية إلى اعتقادات راسخة([12]).
– والسبب الثالث: وهو طريق الخبر الصادق([13])، فقد يقومُ برهانُ العقل على أن مُخْبِرًا ما – فردًا كان أو جماعة – صادقٌ قطعًا فيما يُخْبِر به.
فالأول منه: الخبر المتواتر الثابت على ألْسنةٍ قومٍ لا يُتصوَّر تواطؤهم على الكذب([14])، فالعقل لا يُجوِّز أن تتفق على الكذب هذه الكثرةُ الكاثرة من المخبرين الذين اختلفت أحوالهم، وتباينت أغراضهم، وهم في حالة لا يجمعهم معها على الكذب جامعٌ، فنحن نجد أنفسنا مضطرين عقلاً أن نَقْبَل خبرَهم، ونعتقد به حقيقة واقعة غير قابلة للشك، وإلا حُرِمْنا أكثر العلوم والمعارف، وحُرِمْنا إدراك أية حقيقة من حقائق التاريخ، فهو يفيدنا العلم
اليقيني الذي يضطر الإنسان إلي التصديق به تصديقا جازما، كمَن يشاهد الأمر بنفسه، فلا يتردد في تصديقه، فالمتواتر كله مقبول ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.
والثاني: خبر الرسول فيما يُخْبِر به عن الله تعالى من أحكام ومن أمور الغيب، فإنه ثبت لدينا عقلا صدقُ خبرِ الرسول، فخبره يفيدنا العلم اليقيني قطعًا، لأن الرسول مَشْهُود له بالصدق من قِبَل الله تعالى:
– بلسان حال المعجزة الباهرة([15]) التي يجريها الله على يديه أنه صادق فيما يُخْبِر به عن ربه، والتي لا يأتي بها أو بمثلها إلا رسولٌ مؤيَّدٌ من عند الله.
– وبما صانهم الله به من العصمة عن الكذب وسائر المعاصي.
وأكثر عقائدنا التي نعتقد بها في ديننا قد جاءتنا عن طريق الوحي، ونَطَقَ بها الرسولُ الصادق المؤيَّد من الله بالمعجزة، فيَجبُ عقلا تصديقُ الرسول في كل ما يُخْبِر به من الشريعة، سواء أخبر به في نص آية من كتاب الله، أم بكلام من عنده، لا فرْق في ذلك مطلقًا.
ولكن حيث لم نسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل سمعنا مِمَّن رَوَوْا عنه – والذي رَوَوْا عنه ليسوا بمعصومين -؛ وجدنا أنفسنا بحاجة إلى أن نفرِّق بين ما نُقِل إلينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق متواتر يفيد العلم اليقيني؛ وبين ما نُقِل إلينا عنه بطريق الآحاد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر، ولا يفيد العلم اليقيني([16]).
– فكتاب الله تعالى بكلِّ ما فيه منقول إلينا بطريق التواتر الذي يُفيد صِدْق النقل عن الرسول قطعًا؛ وذلك يفيدنا العلم اليقيني بأنه كلام الله، ومِن ثَمَّ فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني، فالاعتقاد الراسخ.
وأما الأحاديث فبعضها القليل منقول عن الرسول بطريق التواتر، فهو يفيدنا صدق النقل عن الرسول كالقرآن، ومِن ثَمَّ فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني به، فالاعتقاد الراسخ.
– والعلم الذي يثبت بالمتواتر من القرآن والسنة يَجِب قبولُه والاعتقادُ به، ويكفر جاحده، لأنه لفرط ظهور قطعيته صار من المسلَّمات المقطوع بها، وصارت الوسائط كأن لم تكن، وصار المطَّلع عليه كالسامع من النبي نفسه سواء بسواء، فيكون مُنْكِرُه مكذِّبًا بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
فإنكار النص اليقيني القطعي يعني التكذيب بالشارع لا محالة، أما إنكارالخبر الآحادي ففيه شبهة احتمال الإنكار على الرواة، وشبهة خطئهم، فإنرواة الخبر الواحد الصحيح غير معصومين من الخطأ والكذب، وإن كان ذلك مستبعدا.
– ويجب التنبُّه إلى أنه قد يكون الخبر قطعيًّا كالقرآن أو الأحاديث المتواترة، ولكن دلالة النص القرآني أو النص الحديثي المتواتر دلالة غير قطعية؛ لأنه يحتمل التأويل إلى عدَّة معان مثلا، ولم نتمكن مِن ترجيح بعضها على بعض بدليل قاطع، وإنما رجَّحْنا بعضَها على بعض بالظنِّ الغالب، فلا يفيد حينئذ مضمونُ هذا النصِّ العلمَ اليقينيَّ الجازمَ، ومَن ثَمَّ يصعبُ أن يتحوَّل إلى عقيدة راسخة، ومن ثَمَّ فلا يصح لنا أن نُلزِم بالاعتقاد به إلزامًا قطعيًّا أو نُكفِّر مَن لا يعتقد به([17]).
أنواع الحديث المتواتر
الحديث المتواتر نوعان: اللفظي والمعنوي، ولكن إذا ذُكِر المتواتر مطلقا انصرف إلى المتواتر اللفظي، وكلاهما يفيد العلم اليقيني الضروري([18]):
النوع الأول: المتواتر اللفظي: وهو الذي تتفق ألفاظ الرواة فيه، ومن أمثلته: “مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبوأ مَقْعده من النار”([19]).
قال الإمام النووي: “وأما متن الحديث فهو حديث عظيم في نهايةٍ من الصحة وقيل: إنه متواتر ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي عليه السلام نحو من أربعين نفسا من الصحابة رضي الله عنهم،وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي رحمهما الله أنه روي عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعا، وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد مَن رواه فبلغ بهم سبعة وثمانين…، وذكر بعض الحفَّاظ أنه رُوي عن اثنين وستين صحابيا، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة، قال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذا، ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا، وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة”([20]).
النوع الثاني: المتواتر المعنوي: وهو الذي تختلف فيه ألفاظ الرواة، وذلك كان يروي واحد منهم واقعة، وغيره واقعة أخرى وهلم جرا، غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة على قدر مشترك تتفق عليه جميع الروايات، فهذا القدر المشترك يسمى “المتواتر المعنوي”، أو “المتواتر من جهة المعنى”، وذلك مثل أن يروي واحدٌ أن حاتما وَهَبَ مائة دينار، وآخرُ أنه وَهَبَ مائة من الإبل وهلم جرا، فهذه الأخبار تشترك في شيء واحد، وهو هبة حاتم شيئا من ماله، وهو دليل على سخائه، وهو ثابت بطريق التواتر المعنوي([21]).
ومن المتواتر المعنوي في السنة أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث في رفع يديه صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، غير أنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع.
والمراد بالقطع في روايات المتواتر هو عدم احتمال الخطأ عادة([22])، أي: هو مستحيل الحصول في الواقع المعتاد من طبيعة الحياة الإنسانية، كاستحالة طيران الإنسان، وليس معناه أنه يستحيل في العقل أن يُتَصوَّر خلافُه وهو المحال العقلي، وليس معناه أنه ثابت ثبوتًا قويًّا حتى لا يخطر في بال صاحبه خلافه، بل لابد أن يكون احتمال الخطأ محالا عادة فقط، سواء أكان عمدًا وهو الكذب أم سهْوًا وهو الغلط، ومعرفة هذه الفوارق ضرورية في إدراك مذاهب العلماء([23]).
خبر الواحد
وهو الذي لم يجمع شروط التواتر، بمعنى أنه فَقَد شروط التواتر كلها أو بعضها، وهذا عند الأصوليين، وأما الجمهور من المحدثين فيقسمونه إلى: مشهور وعزيز وغريب.
والحنفية قسموا الخبر إلى متواتر ومشهور وآحاد، فالحديث المشهور قِسْم وسط بين الآحاد والمتواتر، فالمشهور عندهم: الذي كان آحاد الأصل، متواترًا في القرن الثاني والثالث ومَن بعدهم مع قبول الأمة([24]).
ما يفيده خبر الواحد
والكلام في خبر الواحد الصحيح([25]) على قسمين:
الأول: خبر الواحد الصحيح المجرد.
الثاني: خبر الواحد الصحيح الذي احتف بقرائن تُقويِّه.
القسم الأول
خبر الواحد الصحيح المجرد
وهو الحديث المجرد الذي لم تحتف به قرائن تقويِّه، وهو يفيد الظن مطلقا سواء أقترنت به قرينة أم لا، وهو قول الجمهور من العلماء([26]).
– وحكى ابن حزم عن أبي سليمان داود الظاهري، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي أنه يفيد العلم([27])، وحكى ابن خُويز مِنْدَاد([28]) عن الإمام مالك أنه يفيد العلم.
ولم يُسلِّم الزركشيُّ ما نقله ابن حزم عن الحارث المحاسبي فقال: “وفيما حكاه عن الحارث نظرٌ، فإني رأيت كلامه في كتاب فهم السنن، نقل عن أكثر أهل الحديث، وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد العلم، ثم قال: وقال أقلهم: يفيد العلم، ولم يختر شيئًا، واحتج بإمكان السهو والغلط من ناقله كالشاهدين يجب العمل بقولهما لا العلم”([29]).
وأما ما نسبه ابن خويز منداد لمالك- فإن الإمام المازري لم يُسلِّم له ذلك، بل قال: “لم يُعْثَر لمالك على نصٍّ فيه، ولعلَّه رأى مقالةً تُشير إليه، ولكنها متأوَّلَة”([30]).
– وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، والراجح عنه أنه لا يفيد العلم، بل يفيد الظن.
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: “وقد رأيت في كتاب (معاني الحديث) جمع أبي بكر الأثرم، بخط أبي حفص العُكْبَري، رواية أبي حفص عمر بن بدر قال: (الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله: أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئ منها، وبرئت منه.
وقال: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض، عملت بالحكم والفرض، وأدنت الله تعالى به، ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك). فقد صرح القول بأنه لا يقطع به”([31]).
وقال الإمام ابن قدامة: “اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنه لا يحصل به، وهو قول الأكثرين، والمتأخرين من أصحابنا”([32]).
ومن العلماء مَن اعترض على هذه الرواية فقال: إن الرواية انفرد بها الأثرم، وليست في مسائل الإمام ولا في كتاب السنة([33]).
ويجاب عليهم: بأن انفراد الثقة لا يضر، فهذا تشكيك لا يقبل، وكذلك لا يضر عدم وجود عبارة الإمام في مسائله أو في كتاب السنة؛ فإن وجودها في كتاب (معاني الحديث) وحده يكفي، ولم يقل أحد العلماء: إن العالم إذا وردت عنه عبارة لم تقبل حتى توجد في كل كتبه أو في عدد منها، ولا يشترط في قبول رواية الإمام أن يرويها كل تلاميذه، وإنما الذي يضر هو أن يروي أحد تلاميذ الإمام نقيضها، وهم أكثر وأوثق منه، ولم يحصل ذلك.
ثم قالوا: والأثرم لم يذكر أنه سَمِع ذلك منه، بل لعله بَلَغَه عنه مِن وَهْمِ واهم عليه في لفظه.
ويجاب عليهم: بأنه يشترط التصريح بالسماع إذا كان مدلسًا، وقول الأثرم “قال” يحمل منه على الاتصال، فإنه لم يصرح أحد العلماء بأن الأثرم مدلس.
ثم قالوا: إن المروي عن الإمام أنه جَزَمَ على الشهادة للعشرة بالجنة، والخبر في ذلك خبر واحد.
ويجاب عليهم: بأن خبر الواحد المروي في كون العشرة في الجنة محفوف بقرائن تشهد له:
– آيات منها قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضَي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ} [التوبة: 100]، والعشرة من أسبق السابقين.
– وكذلك تشهد له أحاديث مشهورة مما تلقته الأمة بالقبول ، وقد خصَّهم المحب الطبري بكتاب “الرياض النضرة في مناقب العشرة” وذكر أحاديث في كل واحد منهم، أو في عدة منهم، أو في جمع يشملهم، وكثير منها روي في الصحيحين، وذلك يؤكِّد ثبوت تلقي الأمة للخبر بالقبول([34]).
فالإمام أحمد لا يرى إفادة خبر الواحد العلم مطلقًا، وإنما يرى ذلك في أخبار مخصوصة احتفت بها قرائن جعلتها بحيث يحصل العلم بها، وذلك مثل أخبار الرؤية، فإن ظواهر الآيات القرآنية المثبتة للرؤية جعلتها مفيدة للعلم.
قال ابن قدامة : “وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: يقطع على العلم بها، وهذا يحتمل أن يكون مختصا في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته، وتلقته الأمة بالقبول، ودلت القرائن على صدق ناقله، فيكون إذن من المتواتر([35])؛ إذ ليس للمتواتر
عدد محصور، ويحتمل خبر الواحد عنده مفيدًا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث، وأهل الظاهر.
قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم، وثقتهم، وإتقانهم، ونقل من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول، ولم ينكره منهم منكر فإن الصديق، والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيئا سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك، ولا ريب مع ما تقرر في نفسه لهما، وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما”([36]).
– وقال ابن بدران الدمشقي في تعليقه على قول ابن قدامة “اختلفت الرواية عن إمامنا…إلخ”: “حاصله أن للإمام روايتين:
أحدهما: إن العلم لا يحصل بخبر الواحد.
وثانيهما: إنه يحصل به العلم، وهو قول جماعة من المحدثين، قال الآمدي: وهو قول بعض أهل الظاهر، وقال الواسطي: وهو رأي خويز ابن منداد وعزاه إلى الإمام مالك.
والذي يظهر من كلام المصنف أن هذه الرواية مخرجة على كلام الإمام أحمد في أحاديث الرؤية؛ لأنها صريح كلامه، لأنه نُقِل عنه أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها، والذي أراه أنه لا يفهم من كلام الإمام إلا التخصيص بأخبار الرؤية، فكأنه يقول: إن أخبارها وإن لن تبلغ حد التواتر لكنها احتفت بقرائن جعلتها بحيث يحصل العلم بها، وتلك القرائن هي ظواهر الآيات القرائن المثبتة لها، وكذلك ما نَسَبَ إليه ابنُ الحاجب والواسطيُّ وغيرُهما من أنه قال: يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وإن لم يكن ثم قرينة، فإنه غير صحيح أصلا.
وكيف يليق بمثل إمام السنة أن يدعي هذه الدعوى، وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة، ورواياته رضي الله عنه كلها مدونة معروفة عند الجهابذة من أصحابنا، والمصنف رحمه الله من أولئك القوم، ومع هذا أشار إلى أنها رواية مخرجة على كلامه، ثم إنه تصرف بها كما ذكره هنا”([37]).
– وقد أوَّلَ الأصوليون ما نُسِب إلى الأئمَّة من قولهم بإفادة خبر الواحد للعلم، فقال الإمامُ الغزاليُّ: “خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نُصدِّق بكل مانسمع، ولو صدقنا وقدَّرنا تعارضَ خبرين، فكيف نُصدِّق بالضدين، وما حُكِي عن المحدثين من أن ذلك يُوجِب العِلم، فلعلَّهم أرادوا أنه يفيد العِلْم بوجوب العمل؛ إذ يُسمَّى الظنُّ عِلمًا, ولهذا قال بعضهم: يُورث العلم الظاهر، والعِلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظنُّ”([38]).
– وقال الزركشي: “ولعل مراد أحمد إنْ صحَّ عنه إفادة الخبر للعلم بمجرده ما إذا تعددت طرقُه، وسَلِمت عن الطعن فإن مجموعها يفيد ذلك؛ ولهذا قال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا ما عقلناه”([39]).
– وليس مراد الجمهور من قولهم: “يفيد الظن ولا يفيد العلم” أنه لا يلزم تصديقه كما قد يتوهَّم، بل مرادهم أنه ليس بمنزلة المتواتر؛ لأن المتواتر يفيد علمًا قاطعًا يقينيًّا لا يخطر في البال وجودُ أيِّ احتمال للخطأ فيه عادة.
أما خبر الواحد الصحيح فيفيد الصدق والقبول، لكن يقع في ذهن العالم أنه قد يحتمل وقوع الخطأ أو الكذب فيه، فإن الراوي الثقة ليس معصوما من الذنب([40])، وليس وصفه بالضبط يعني أنه لا يخطئ، ولا يتطرق إلى خبره شك، بل يعتبر ثقة إذا كانت أوهامه نادرة.
فالاحتمال موجود في تصور العقل، لكنه بعيد لغلبة صدق الراوي وأمانته وضبطه للحديث، فكان من منهج العلماء العلمي الدقيق التنبيهُ على مثل هذا الفرق، لوضع كل شيء في موضعه الذي هو عليه، وإن كان مثل هذا قد يخفى على كثير من الناس – ولاسيما العوام -، بل إن عامة الناس، بل بعض أهل العلم الذين لم يمهروا في تطبيق علم الحديث قد يكتفي بتديُّن الشخص عن اتصافه بالضبط، يقول أحدهم: “حدثني فلان وهو رجل صدوق لو قطعت عنقه لم يكذب”، أما المحدث فلا يكتفي بذلك لقبول خبره حتى يتثبَّت من ضبطه([41]).
وعدم الأخذ بخبر الواحد في إثبات العقيدة لا يعني إنكاره، أو عدم العمل به، أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب الصحابة- وإنما يعني عدم القطع في إثبات المسائل التي استدل بخبر الواحد عليها كمسائل عقائدية, بل يجري ترجيح تصديقها, ولا يجري القطع بها بحيث يكفر المخالف فيها
وذلك مثل: لو جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وشهد بالزنا على رجلٍ أو امرأةٍ- فلا يثبت الزنا، ولا يقام الحد على الزاني بشهادته وحده مع تأكُّدنا من صدقه وعدالته, وكذلك لو جاء معه مَن يؤيده على شهادته أمثال عمر وعثمان رضي الله عنهم مع الطمأنينة بصدقهم جميعًا([42]).
– ومن الأدلة على مذهب الجمهور([43]):
1- حديث ذي اليدين، الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: “صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِحْدَى صَلاتِي العَشِيِّ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ المسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيها وَفِيهِم أبُو بَكْرٍ وَعَمَرُ رضي الله عنهما، فهَابَا أنْ يُكَلِّماهُ، وخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فقالوا: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ ورَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذُو اليَدَيْنِ([44]) فَقَال: أَنِسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ، فقال: “لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ”، قال: بلَى قَدْ نَسِيتَ، فَصلَّى رَكْعَتَينِ ثُمَّ سَلَّم ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ”([45]).
وجه الدلالة في الحديث هو أن خبر الواحد الثقة لو كان يفيد القطعَ – أي: عدم احتمال الخطأ – لما نفَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم كلامَ ذي اليدين بقوله: “لم أنس ولم تقصر”، ولَـمَا تَثَبَّت من الصحابة حين أَصَرَّ ذو اليدين على قوله وأخبروه بمثل خبره- قَبِلَهُ وعَمِلَ به؛ إذ هو قرينةٌ قاطعةٌ بسبب الكثرة فقدَّمها النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ما ظنَّه مِن نفسه مع أنه كان في أول الأمْر رافضًا للخبر – تعليما للأمة – ولم يكن واهمًا إطلاقًا.
فإنه مما لا شك فيه أن احتمال وقوع الغلط أو الكذب على العدد الأكثر أبعدُ من احتمال وقوعه في العدد الأقل؛ ولأن خبر كل واحد من الجماعة يفيد الظن، ومن المعلوم أن الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على الظن حتى ينتهي إلى القطع([46]).
2- روي عن عروة بن الزبير بن العوام أنه قال: ذُكِر عِنْدَ عائشةَ رضي الله عنها أن ابنَ عُمَرَ رَفَعَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ الميِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ”، فقالت: وَهلَ([47])، إنما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: “إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ”، قالت: وَذاكَ مِثْلُ قَولِه: إِِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ علَى القَلِيبِ وفيهِ قَتْلَى بَدْرٍ من المشرِكِينَ فَقَالَ لهم ما قال: “إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ” إنَّما قال: “إِنَّهُمْ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ”، ثُمَّ قَرَأتْ: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الموْتَى} [النمل: 80]، {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِن فِي القُبُورِ} [فاطر: 22]، يَقولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ([48]).
فلو كانت روايةُ الواحدِ العَدْلِ قاطعةً مفيدةً للعلم ما أقدمتْ عائشةُ رضي الله عنها على تَوْهِيمِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، وكلاهما خبرُ آحاد، وإنْ فُضِّل أحدُهما على الآخر في قوة الحفظ فإنه لا يَفْضُلُه إلى درجة القطع؛ لأن القطعَ معناه عدمُ احتمالِ الخطأ عادة.
ولا يقال: إن عائشةَ وَهَّمْـتُـهُ؛ لأنها قاطعةٌ بما عندها من العِلْم المعارض لروايته؛ وذلك لأمرين:
أولهما: أنه يَحِقُّ له أن يُوَهِّمَها لما عنده من العِلْم المعارض لروايتها، وأحدهما مخطئ حتما؛ لأن المعلومات القاطعة لا تتعارض في الواقع، بل بحسب علم صاحبها.
ثانيهما: أن القاطع يستحيل خطؤه عادة، كاستحالة الطيران من الإنسان، فهو لا يحتمل الخطأ فضلا عن أن يترجَّح خطؤه في ميزان البحث العلمي، كحال رواية عائشة، فإن العلماء قدَّموا فيما بعد رواية ابن عمر على روايتها؛ لأن روايته جاءت عن ثقات آخرين كعمر وأبي طلحة وابن مسعود([49])؛ لأنهم حضروا الحادثة وكانوا أكثر عددًا، وليست عائشةُ رضي الله عنها من الذين يفرقون بين القطع والرجحان حتى تَقْطَع في أمْرٍ غيرِ قاطعٍ.
والظنُّ لم يأت من ثبوت المعارض، بل مِنِ احْتِمال وجوده عند عدم العِلْم به، وهذا الاحتمال قائمٌ بدليل أن بعضَ العلماء يُصحِّح الحديثَ ويعمل به، ومعنَى ذلك أنه ثابتٌ عنده، ثم يبلغه معارضٌ أقوى فيَتْرُك الأوَّلَ([50])، فلم يبق إلا أنه كان ظنيًّا عنده حتى عند تصحيحه والعمل به.
وإن ثبوت المعارض الأقوى دليل على أن الآخر مرجوح لا راجح، وهذا معنى الوهم لا معنى الظن([51]).
– ويظهر من هذا الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاملون مع أخبار الآحاد على أنها ظنية غير قاطعة، فإنهم كانوا في بعض الأحيان يتشككون في رواية بعضٍ منهم ويقولون: إنها خطأ.
3- لو كان خبر الواحد يفيد العلم لجاز لخبر الواحد أن ينسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة؛ لأنه يكون حينئذٍ في قوتهما فيَقْوَى على نسخهما، ولكن لما لم يجز نسخ خبر الواحد للقرآن والسُّنَّة المتواترة([52])- دلَّ على أن مرتبتَه أضعفُ من مرتبتهما، فدلَّ على أنه لا يفيد العلم مثلهما، بل يفيد الظن.
4- من المقرر عند العلماء أن التصحيح والتحسين والتضعيف من الأمور الاجتهادية، التي يُتَّفق في بعضها و يختلف في كثير منها.
فعلماء الحديث يختلفون في التصحيح و التضعيف بناء على اختلافهم في تطبيق شروط الصحة، أو زيادة بعضهم لشرط ليس عند الآخر، أو لاختلافهم في الحكم على رجال الحديث، فقد كذَّب بعضهم رجالا عدَّلهم غيرهم، وحكموا بضعف الحفظ على رجال وثَّقهم غيرهم، وكذلك فإنه قد يختلف علماء الحديث في الحكم باتصال السند، وفي الحكم بالشذوذ أو النكارة على بعض نصوص الحديث، بل يختلف حكم العالم الواحد فيُجِّرح مَن سبق منه تعديله أو يعكس، وعلى ذلك فإننا نرى العلماء كثيرا ما يحكمون على بعض الأحاديث بالصحة لتوافر شروط الصحة فيها عندهم، ثم يجدون بعض العلل التي تقدح في صحة ذلك الحديث فيحكمون عليه بما تقتضيه تلك العلة القادحة، وقد يُضعفَّون بعض الأحاديث لعدم توافر شروط الصحة فيها، ثم يجدون ما يقويها، فيحكمون بصحتها وهكذا.
وإذا كان الحكم بتصحيح أي حديث من الآحاد أمرا اجتهاديا، ويحتمل أن يكون بخلاف ذلك، فلا يجوز القطع بدلالة ما دل عليه – وذلك إذا كان مجردا مع عدم وجود قرائن قد تجعل دلالته قطعية-، وهذا أمْر ظاهر بيِّن، وإلا لوجب على الإنسان أن يقطع اليوم بكذا ويقطع غدا بضده.
– قال إمام الحرمين: “ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفَى مدركه على ذي لب.
فنقول لهؤلاء: أتجوزون أن يزلَّ العدل الذي وصفتموه ويخطيء؟
فإن قالوا: لا؛ كان بهتاً وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة، ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه.
والقول القريب فيه أنه قد زلَّ من الرواة والأثبات جمعٌ لا يعدون كثرة، ولو لم يكن الغلط متصوَّرًا لما رجع راوٍ عن روايته، والأمر بخلاف ما تخيَّلوه، فإذا تبيَّن إمكان الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محال، ثم هذا في العدل في علم الله تعالى، ونحن لا نقطع بعدالة واحد، بل يجوز أن يُضْمِر خلاف ما يظهر، ولا متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد يوجب العمل، وقد تكلمنا عليه بما فيه مقنع”([53]).
– قال الإمام النووي: “فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل
بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل”.
ثم قال:”وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وقال بعضهم: يوجب العلم الظاهر دون الباطن، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد، وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول، وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة”.
ثم قال: “وأما مَن قال يوجب العلم، فهو مكابر للحس، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟ والله أعلم”([54]).
5- لو كان خبر الواحد يفيد العلم لكان العلم حاصلا بخبر الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم من غير حاجة إلى إظهار المعجزات والأدلة على صدقهم، فلما أخبروا عن نبوتهم وأظهروا المعجزات الدالة على ذلك- ثبت أن خبر الواحد بمجرده لا يفيد العلم.
6- لو أفاد خبر الواحد العلم لما تعارض خبران، لأن ما يفيد العلم لا يتعارض، كما لا تتعارض أخبار التواتر، لكنا رأينا التعارض كثيرا في أخبار الآحاد، وذلك يدل على أنها لا تفيد العلم.
7- لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم لوجب على القاضي أن يصدِّق المدعي على غيره من غير بينة؛ لأن العلم يحصل بقوله، فلما ثبت أنه لا يُصدَّق إلا ببينة ثبت أن خبر الواحد بمجرده لا يفيد العلم.
8- لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما احتيج إلى عدد من الشهود، ولجاز الحكم بشاهد واحد، ولم نحتج معه إلى شاهد آخر، وإلى يمين عند عدمه، ولا احتجنا كذلك الزيادة في الشهادة في الزنا واللواط؛ لأن العلم بشهادة الواحد حاصل، وليس بعد حصول العلم مطلوب، لكن الحكم بشهادة واحد بمجرده لا يجوز، وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم.
9- إن الإجماع منعقد على عدم تكفير مخالف خبر الواحد وتفسيقه، وما ذاك إلا لأنه لا يفيد العلم، فليس كالمتواتر الذي يكفر ويبدع مَن رده بدون تأويل.
وعلى ذلك: أحاديث الآحاد يجب العمل بها في الأحكام الشرعية العملية، باعتبارها فروعا، فإنه يُكتفى بالظن الغالب في إثبات فروع الأحكام الشرعية العملية، التي تعتمد على اجتهادات المجتهدين واستنباطاتهم.
فيجب العمل بهذه الأحكام وإن اختلف المجتهدون في النتائج التي توصلوا إليها، لأن الغرض منها تحقيق معنى عبادة الله بالصورة التي يرضاها الله منا، وقد رَضِي منا حتمًا أن نعبده تعالى بالصورة التي يصل إلى تحديدها اجتهادُ المجتهدين منا، وهم الذين توفرت لديهم أهلية الاجتهاد والبحث في مصادر الشريعة.
وتفريعا على ذلك لو وقع خلاف في مسألة فرعية دليلها خبر آحاد وأنكر أحدُ الناس حجيَّةَ هذا الخبر لا يكون بذلك كافرًا أو فاسقًا- وإلا لحكم بذلك على أئمة الفقه المختلفين في بعض المسائل.
فإذا تأيَّد هذا الخبر وما يدل عليه من حكمٍ بالإجماع عليه صار قويًّا، ومَن جحده كان مخطئا، وإن كان لا يحكم عليه بالكفر.
– واستدل أصحاب القول الثاني (إفادة خبر الواحد العلم مطلقا) بأدلة نذكر منها([55]):
1- إن المسلمين لما أخبرهم الواحدُ وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حُوِّلت إلى الكعبة قَبِلُوا خبرَه، واستداروا إلى الكعبة، ولم ينكر عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم بخبر لا يفيد العلم.
ويجاب عليهم: بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبِر فلم يتركوا المقطوع به عندهم الذي يفيد العلم إلا بما يفيد العلم([56]).
قال الكاندهلوي: “والأوجه أن الخبر كان محتفًّا بقرائن أفادت القطع عندهم، وهي انتظاره صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك، فقد ورد أنه كان يدعو وينظر إلى السماء”([57]). فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يُصلِّي إلى الكعبة.
وقيل: قد يكون من القرائن أيضا قربهم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماعهم ضجة الخلق.
2- إن الله تعالى قال في القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: 6] وفي قراءة حمزة والكسائي (فتثبتوا) من التثبت([58]).
وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد العدل وأنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت منه حتى يحصل العلم.
ويجاب عليهم: بأن هذه الآية جاءت في معرض ما استدل به الجمهور على جواز العمل بخبر الواحد شرعا، وهذا مما لا خلاف فيه، والكلام في إفادة خبر الواحد للعلم أو الظن.
ولا دلالة في الآية على التلازم مع الجزم بين التثبت لقبول الخبر وإفادته للعلم دون الظن، فقبول خبر العدل الواحد يكفي الظن فيه للعمل به.
3- قال تعالى: {وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كافة فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: ] والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار هو الإعلام بما يفيد العلم.
ويجاب عليهم: بعدم تسليم كون الإنذار هو الإعلام بما يفيد العلم([59])، بل الإنذار هو الإخبار؛ لأنه عبارة عن الخبر المخوِّف، والخبر داخل في الخبر المخوِّف، والله تعالى قد أوجب الحذر – وهو التوقي من المضرة – عند إخبار الطائفة.
والطائفة – هاهنا – اسم لعدد لا يفيد قولهُم العلمَ؛ لأن كل ثلاثة فرقة، والله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة، والطائفة من الثلاثة واحد أو اثنان، وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم([60]).
4- قال تعالى: {وَمَا علَى الرَّسُولِ إِلا البَلاغُ المُبِينُ} [العنكبوت: 18]، وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: “بَلِّغوا عَنِّي وَلَوْ آيََةً”([61]).
ومعلوم أن البلاغَ: هو الذي تقوم به الحجةُ على المبلَّغ، ويحصلُ به العِلْمُ، فلو كان خبر الواحد لا يحصلُ به العِلمُ لم يقع به التبليغُ الذي تقوم به حجةُ الله على عبدِه، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العِلمُ.
– وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرسِل الواحدَ من أصحابه يُبلِّغ عنه، فتقوم الحجةُ على مَن بَلَّغَهُ، وكذلك قامت حجتُه علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله، وأفعاله، وسنته، ولو لم يُفِد العلم لم تقم علينا بذلك حجةٌ، ولا على مَن بلَّغَهُ واحدٌ أو اثنان أو ثلاثةٌ أو أربعةٌ أو دون عدد التواتر، وهذا باطل.
– وكذلك فإنه تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعثه الدعاة إلى أطراف البلاد، وعهده إليهم تبليغ جميع الدين أصولا وفروعًا، مع البدء بالتوحيد كما في حديث معاذ، لما بعثه إلى اليمن قال له: “إِنَّكَ سَتَأتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ”([62])، وفي رواية: “فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ…” الحديث([63]).
ويجاب عليهم: أولا: بأن البلاغ هو ذكر المسائل، والإبانة المقصودة في قوله {البَلاغُ المبينُ} هي إقامة البرهان على البلاغ، فبذلك تكون إقامة الحجة في البلاغ أتت تبعا لا أصالة، فامتثال المبلَّغ يكون بعد وضوح البلاغ وكفايته مع كونه مُؤيَّدًا بالحجَّة الساطعة([64]).
ومِن ثَم فإن المراد بالبلاغ مجرَّد الإعلام أو المعرفة، وهو من أحد إطلاقات العلم، والمقصود بالعلم في قولنا (خبر الواحد لا يفيد العلم) أي: اليقين، ففارق ببن المعنيين.
ثم ثانيا: بأن بَعَثَ أولئك الرسل لم يكن لتعليم الأصول، وإنما هو لإخبارهم بالأدلة العقلية، والآيات الكونية التي يعرفونها بفطرهم، فحديث معاذ مضمونه قطعي أُثبت بأدلة غير أنه خبر آحاد؛ وذلك من خلال البرهان العقلي أو المعجرة التي أيدت النبي صلى الله عليه وسلم.
– قال القرافي: إنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقتصر في بعثه الرسل إلى القبائل على عدد لم يبلغوا حد التواتر للضرورة؛ لأنه لو بعث لكل طائفة مَن يحصل بخبرهم العلمُ لم يجده، ولم يبق عنده أحدٌ؛ ولذلك كانت رسله صلى الله عليه وسلم تبلغهم العقائدَ التي يُشترَط فيه العلمُ في زماننا، فعلمنا أنَّ تلك الحالة مستثناةٌ للضرورة بخلاف زماننا هذا([65]).
5- ثبت عند الجميع بالأدلة العمل بأحاديث الآحاد، فلا وجه لتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد.
وحاصله: إلزام القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد وبأنه حجة، بأنه لو كان حجة في
العمليات لكان حجة أيضا في الاعتقاديات.
ويجاب عليهم: بأننا نمنع العلة التي اقتضت وجوب العمل بخبر الواحد في العمليات موجودة في الاعتقاديات؛ لأن المطلوب في العمليات هو العمل، ويكفي في ذلك الظن، والمقصود في الاعتقاديات الاعتقاد المطابق للواقع من دليل قاطع، فلا يكفي في ذلك الظن.
فإن قالوا: إن العلة في وجوب العمل هي دفع الضرر مطلقا مظنونا أو مقطوعا به، وهذا القدر المشترك موجود في العمليات والاعتقاديات.
قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن الضرر الذي عن الخطأ في النبوات والاعتقاد هو الكفر بخلاف العمليات التي هي الفروع، فإن المجتهد إذا أخطأ فيها لا إثم عليه، بل هو مأجور مرة.
فضلا عن أن القطع في كل مسالة فرعية متعذِّر، فكان من الضروري أن يعمل فيها بالظن حتى لا تتعطَّل أحكام الوقائع المتجددة على الدوام بخلاف الاعتقاد؛ لأن أدلتها نصبت في الأرض والسموات والأنفس والآفاق؛ قال تعالى: {وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلمُوقِنِينَ* وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفْلا تُبْصِرُونَ} [الذاريات: 20-21]، وقال تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ الليْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ} [آل عمران: 190] إلى غير ذلك من الآيات الخاصة على الاستدلال بالأدلة البرهانية التي مقدماتها ضرورية، أو ترجع إلى ذلك مما يعرفه الخاصُّ والعامُّ([66]).
يقول العلامة القرافي: “الفرق أن الظانَّ في الفروع على تقدير خطئه، فهو ينسب إلى الله تعالى ما هو جائز عليه، فإن جميع الأحكام الشرعية ونقائضها وأضدادها جائزة على الله تعالى.
ولو وُجِد([67]) الظنُّ في أصول الديانات فعلى تقدير خطئه يكون الظانُّ نَسَبَ إلى الله تعالى ما هو كفر، وما هو مستحيل عليه سبحانه وتعالى؛ فلذلك لم نجزِ الظن في العقائد، بل ولا التقليد أيضا لهذا السرِّ، وهذا فرْقٌ عظيم بين البابين سمعته من الشيخ عز الدين بن عبد السلام”.
6- إن خبر الواحد لو لم يُفد العلم لم يثبت به الصحابةُ التحليلَ، والتحريمَ، والإباحةَ، والفروضَ، ويُجعل ذلك دينًا يُدانُ به في الأرض إلى آخر الدهر.
فالصديق رضي الله عنه أعطَى للجدة السُّدُس، وجعله شريعةً مستمرةً إلى يوم القيامة بخبر المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما.
وأثبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية الجنين بخبر حمل بن مالكوغير ذلك كثير، وهو يدل على إفادة الخبر العلم.
ويجاب عليهم: بأن هذا الدليل لا دلالة فيه على دعواهم، فإن أبا بكر ردَّ خبر المغيرة أوَّلا لعدم تثبته من خبر الواحد منفردًا، فلو أفاد خبر الواحد الثقة العلمَ لما احتاج إلى التثبت من غيره، ولكنه لم يقبله إلا عندما انضم إليه خبر محمد بن مسلمة.
ثُم إنَّ ما صدر من الصحابة رضي الله عنهم من قبولهم لخبر الآحاد في مسائل الأحكام
الشرعية العملية لا خلاف فيه، فإن خبر الواحد يُعتد به في نطاق الأحكام العملية؛ للدليل القاطع على أن المسلم مكلَّف – بالنسبة للسلوك العملي – بالاعتماد على الظني من الخبر الصحيح؛ ولذلك صح أن تستند الأحكام الشرعية إلى الأحاديث الصحيحة وإن كانت آحادا، وذلك حيطة في الأمر وأخْذًا بالحزم.
أما الذي يُعْتَد به في بناء العقيدة هو الخبر المتواتر المفيد لليقين، بمعنى أن الإنسان لا يجبر على الاعتقاد بشيء خبري إلا إذا كان قائما على برهان التواتر([68]).
7- إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد، ويقطعونه بمضمونه.
وقَبِله موسى عليه السلام من الرجل الذي جاء مِن أقصَى المدينة يسعى قائلا له: {إِنَّ الملأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ} [القصص: 20] فجَزَمَ بخبره، وخَرَجَ هاربًا من المدينة.
كما قَبِل أيضًا خبرَ بنتِ صاحب مدين حين قالت له: {إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيتَ لَنَا} [القصص: 25].
وقَبِل يوسفُ عليه السلام خبرَ الرسولِ الذي جاء مِن عند الملك يطلبُ منه الذهابَ إليه، ولكنه رفض وقال: {ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّلاتِي قَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ} [يوسف: 50].
وقَبِل النبيُّ صلى الله عليه وسلم خبرَ الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهود المعاهدين له، وغَزَاهم صلى الله عليه وسلم بخبرهم، واستباح دماءهم وأموالهم، وسبى ذراريهم.
ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يُرَتِّبوا على تلك الأخبار أحكامها، وهم يُجوِّزُونَ أن تكون كذبًا وغلطًا، وهذا يدل على أنها تفيد العِلمَ في نظرهم.
ويجاب عليهم: بأن هذه الأخبار قد انضم إليها من القرائن ما جعلها قد تفيد العلم، والكلام في الخبر المجرد عن القرائن.
فإن خبر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ناصحًا موسى عليه السلام بالخروج انضمت إليه قرينة جعلته يفيد العلم؛ لأنه قبل ذلك قَتَلَ رجلا عدوًّا له، فهذا القتل اعتبر قرينة جعلت خبر مَن جاء يسعى مفيدًا للعلم، قال تعالى: {وَدَخَلَ المَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَينِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَه الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيهِ} [القصص: 15].
كما اعتبر سقيه الغنم لابنتي الرجل الصالح بدون أجر قرينة جعلت خبر البنت التي جاءت تدعوه مفيدًا للعلم.
كما اعتبر كذلك تفسير يوسف عليه السلام رؤيا الملك في السجن قرينة جعلت خبر مَنْ أرسله الملك مفيدًا للعلم([69]).
وكذلك قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خبر الواحد في شأن اليهود؛ لأنه كان معروفا عنهم كثرة نقوضهم للعهود، وقد ذكر الله ذلك عنهم أكثر من مرة في كتابه الكريم،
فهم قوم بهت قتلوا رسلهم، أفلا يصدق نقضهم للعهود؟!
8- قال تعالى:{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] فقد نهى سبحانه عن اتباعِ غير العِلم، وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع، ولزوم العمل به، فلو لم يكن خبر الواحد مفيدًا للعلم لكان الإجماع منعقدًا على مخالفة النص، وهو ممتنع.
ويجاب عليهم: بأن وجوب العمل بخبر الواحد لا يدل على أنه يفيد العلم، فالعمل بخبر الواحد لا يقف على كونه مفيدًا للعلم، وإن خبر الواحد قد يوجب نوع علم، وهو علم غلبة الظن الذي سماه الله تعالى علمًا في قوله سبحانه: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: 10]؛ فوجب العمل بغلبة الظن، كما وجب العمل بالقياس، وكما وجب العمل بقول الشاهدين، وكما وجب العمل بقول المفتي([70]).
9- قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] فأمَرَ سبحانه مَن لم يعلم أن يسأل أهلَ الذكر، وهم أولوا الكتاب والعِلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال مَن يفيد خبره علمًا، وهو سبحانه لم يقل سلُّوا عدد التواتر، بل أمَرَ بسؤال أهل الذكرِ مطلقًا، فلو كان المسئول واحدًا لكان سؤاله وجوابه كافيًا مما يدل على أن خبره يفيد العِلم.
ويجاب عليهم: بأن المراد بعدم العلم في قوله {إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} مجرد الجهل، الذي يرتفع بمجرد الإعلام، وقد يفيد هذا الإعلام – من العالم للمقلد – العلم بمعنى اليقين أو الظن.
وعليه : فإن اتباع المقلد للعالم ليس لأن خبره يفيد العلم بمعنى اليقين، بل أقوال العلماء المجتهدين تفيد العلم بمعنى الظن وقد تفيد العلم بقرائن، فالغالب في الأدلة التي ثبتت بها الأحكام العملية أنها ظنية، والمكلفون – من العلماء والمقلدين – مأمورون باتباع الظن في الأحكام الشرعية العملية كما سبق تقرير ذلك، وإنما أُمِر المقلِّدون بالعمل بأقوال أهل الذكر، أي: المجتهدين والمفتين؛ لأن أقوال المجتهدين في حق المقلدين القاصرين كالأدلة الشرعية في حق المجتهدين.
10- إن خبر الواحد العدل في الشرعيات صار قطعيًّا بعصمة الله تعالى وحفظه لدينه، والدليل على ذلك بأننا لو قلنا بأن أحاديث الآحاد ظنية – وأكثر الشرع معتمد عليها، والظن يخطئ ويصيب – كان معنى ذلك التسليم بأنه يمكن أن يدخل في دين الله ما ليس منه أو يضيع ما هو منه وهذا نقيض العصمة.
ويجاب عليهم: بأن حفظ الله للدين وعصمته يعني أن الأمَّة لا تجتمع على تصحيحِ ما لم يقلْهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو تَرْكِ حديثٍ قاله، فالمراد من العصمة نفي الخطأ عن الأمة كلِّها لا عن أفرادها، ولو كان الحفظ لكل حديث صحيح السند لما اختلف علماء الحديث في تصحيح الأحاديث، فعلماء الحديث الذين يحكمون بصحة الحديث أو ضعفه قد وجد الخلاف بينهم، فلم يمنعهم تبحرهم في الحديث من الوقوع في بعض الأخطاء، وإلا
فكيف اختلفوا نفيا وإثباتا مع أنهم أعلم الناس بالحديث وشروطه ولابد أن يكون أحدهما مخطئا؟!
– أما قولهم بكون الحديث وحيا وحقا ونورا لا يلتبس بالباطل كما لا يلتبس النور والظلام، فهذا إنما يعرف بعد ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أما قبل ذلك فليس كل حديث تُعْرَف صحته بهذا، وإلا لما اختلف كبار الأئمة في إثبات بعض الأحاديث ونفيها كما هو مشهور عن البخاري ومسلم والإمام أحمد والإمام مالك، بل وقع الخلاف بين الصحابة أيضًا.
فكيف التبس عليهم إذا كان الفرق بين صحيح الحديث وغيره، كالفرق بين النور والظلام؟! إلا إذا كان في القرآن الكريم ما يدل عليه([71]).
القسم الثاني
خبر الواحد الصحيح الذي احتف بقرائن تقويِّه
– يفيد خبرُ الواحد العلمَ النظريَّ إذا انضمت إليه قرينة؛ وهو قول إمام الحرمين، والرازي، والآمدي، والقرافي، وابن الحاجب، وابن السبكي وغيرهم([72]).
قال إمام الحرمين: “لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود، وعدد محدود، ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به”([73]).
وقال أبو حامد الغزالي: “فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد؟
قلنا: حكي عن الكعبي جوازه؛ ولا يُظَنُّ بمعتوهٍ تجويزُه مع انتفاء القرائن، أما إذا اجتمعت قرائنُ فلا يبعد أن تبلغ القرائنُ مبلغًا لا يبقَى بينها وبين إثارةِ العلمِ إلا قرينةٌ واحدةٌ، ويقوم إخبارُ الواحد مقامَ تلك القرينة؛ فهذا مما لا يُعرَف استحالتُه، ولا يُقطع بوقوعه، فإن وقوعه إنما يُعلم بالتجرِبة، ونحن لم نجربه، ولكن قد جربنا كثيرًا مما اعتقدناه جزمًا بقول الواحد مع قرائن أحواله ثم انكشف أنه كان تلبيسًا”([74]) أي: خلطا.
وقال الزركشي: “خبر الواحد المحفوف بالقرائن, ذهب النظَّامُ، وإمامُ الحرمين، والغزاليُّ إلى أنه يفيد العلمَ القطعيَّ, واختاره الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، والهندي، وغيرهم, وهو المختار. ويكون العمل ناشئا عن المجموع من القرينة والخبر, وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد”([75]).
القرائن متصلة ومنفصلة
فالمتصلة: مثل كون الرواة من أهل الصدق والضبط والإتقان، وكون الخبر موافقًا لما تهدف إليه الشريعة، وكذا تَأيّدهُ بالنصوص الأخرى بمعناه([76]).
قال الحافظ ابن حجر: “والخبر المحتف بالقرائن أنواع:
منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحهمامما لم يبلغ حدَّ التواتر، فإنه احتفت به قرائن:
ومنها: جلالتها في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقِّى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقِّي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرَّد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.
إلا أن هذا يختصُّ: بما لم ينقده أحدٌ من الحفاظ مما في الكتابين.
و بما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته.
فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته- منعناه.
وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزيةٌ، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة.
وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني، ومن أئمة الحديث: أبو عبد الله الحميدي، وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما.
ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح.
ومنها: “المشهور” إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري: الأستاذ أبو منصور البغدادي، والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما.
ومنها: “المسلسل” بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبًا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل رحمه الله – مثلا – ويشاركه فيه غيرُه عن الشافعي رحمه الله، ويشاركه فيه غيرُه عن مالك بن أنس رحمه الله فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكَّك مَن له أدنَى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكًا – مثلا – لو شافَهَهُ بخبرٍ أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه مَن هو في تلك الدرجة ازداد قوةً، وَبَعُدَ عما يُخْشَى عليه من السهو.
وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور.
ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها:
أن الأول: يختص بالصحيحين.
والثاني: بما له طرق متعددة.
والثالث: بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يَبْعُد حينئذٍ القطعُ بصدقِه. والله أعلم”([77]).
– قال الإمام ابن الصلاح:”ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا؛ لتلقِّي الأمة ذلك بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وتلقى الأمة بالقبول يفيد العلم النظري، وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق”.
وقال الإمام النووي تعليقا على قول ابن الصلاح: “وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة، إنما تفيد الظن، فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقى الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان، وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على مَن قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه”([78]).
قال العلامة ابن حجر: “والخلافُ في التحقيق لفظيٌّ؛ لأن مَن جَوَّزَ إِطلاقَ العلمِ قيَّدهُ بكونه نظريًّا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومَنْ أبى الإطلاقَ خصَّ لفظَ العلمِ بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظنيٌّ، لكنه لا ينفِي أَن ما احْتفَّ منه بالقرائن أرجَحُ مما خَلا عنها”([79]).
– وأما القرائن المنفصلة: فالمراد بها أمورٌ خارجةٌ لا تُلازم الخبرَ دائمًا في كل الأحوال، وإنما تقترن به أو تحدث معه في بعض الأوقات؛ فيُعرَف بها صدق الناقل وصحة خبره.
وهذا النوع من القرائن هو الذي ذكره الأصوليون وهم يتحدثون عن إفادة الخبر العلم إذا انضمت إليه قرينة([80]).
– يقول حجة الإسلام الغزالي: “لاشك في أنا نعرف أمورًا ليست محسوسةً، إذ نعرف من غيرنا حبَّه لإنسان وبغضَه له وخوفَه منه وغضبَه وخجلَه، وهذه أحوال في نفس المحبِّ والمبغضِ لا يتعلَّق الحسُّ بها، قد تدلُّ عليها دلالاتٌ آحادُها ليست قطيعةً، بل يتطرَّق إليها الاحتمالُ، ولكن تميل النفسُ بها إلى اعتقاد ضعيف، ثم الثاني، والثالثُ يؤكِّد ذلك، ولو أُفْرِدت آحادُها لتطرَّقَ إليها الاحتمالُ، ولكن يحصل القطع باجتماعها، كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرَّق إليه الاحتمالُ لو قدِّر مفردًا، ويحصل القطع بسبب الاجتماع.
ومثاله: أنَّا نعرف عشقَ العاشقِ لا بقوله، بل بأفعالٍ هي أفعال المحبين من القيام بخدمته وبذل ماله، وحضور مجالسه لمشاهدته، وملازمته في تردُّداته وأمور من هذا الجنس، فإن كل واحد يدل دلالةً لو انْفَرَدَ لاحتمل أن يكون ذلك لغرضٍ آخر يُضْمِرُه لا لحبِّه إياه، لكن تنتهِي كثرةُ هذه الدلالات إلى حدٍّ يحصل لنا علمٌ قطعيٌّ بحبِّه، وكذلك ببغضه إذا رُؤيت منه أفعالٌ ينتجها البغضُ، وكذلك نعرف غضبَه وخجلَه لا بمجرَّد حمرة وجهه، لكن الحمرة إحدى الدلالات.
وكذلك نشهد الصبيَّ يرتضع مرَّةً بعد أخرى فيحصل لنا علمٌ قطعيٌّ بوصول اللبن إلى جوفه، وإن لم نشاهد اللبنَ في الضرع لأنه مستور، ولا عند خروجه فإنه مستور بالفم، ولكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه تدل عليه دلالةً ما، مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن لكن ينضم إليه أن المرأة الشابة لا يخلو ثديها عن لبن، ولا تخلو حلمته عن ثقب، ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص مستخرج للبن، وكل ذلك يحتمل خلافه نادرًا وإن لم يكن غالبًا، لكن إذا انضم إليه سكوتُ الصبي عن بكائه مع أنه لم يتناول طعامًا آخر صار قرينة، ويحتمل أن يكون بكاؤه عن وجع، وسكوتُه عن زواله، ويحتمل أن يكون تَنَاوَلَ شيئًا آخر لم نشاهده، وإن كنا نُلازمُه في أ كثر الأوقات، ومع هذا فاقترانُ هذه الدلائل كاقتران الأخبارِ وتواترِها، وكلُّ دلالةٍ شاهدةٍ يتطرَّق إليها الاحتمالُ كقول كل مُخْبِرٍ على حياله وينشأ من الاجتماع العلم”([81]).
– استدلَّ مَن قال بإفادة العلم من خبر الواحد المحفوف بالقرائن: بأنا نلحظ أمورا تقتضي العلم بالخبر – اكتسابا لا اضطرارا -، وتلك الأمور، إما أن ترجع إلى أحوال المخبِر، وإما أن ترجع إلى غير أحواله.
1- أمور ترجع إلى أحوال المخبِر،فنحو أن يكون له صارفٌ عن الكذب في ذلك الخبر، ولا يكون له داعٍ إليه نحو أن يكون متحفظا من الكذب نافرا عنه في الجملة.
مثاله: إذا جاء رسولٌ من السلطان إلى الجيش يخبرهم بأنه أمرهم بالرجوع إليه، و علمنا أن عقوبة السلطان تردعه عن الكذب، وأنه لا داعي له إلى الكذب- علمنا أنه لم يكذب، وإذا لم يكذب علمنا صدقه.
وكذلك إذا كان مهتمًا بأمر متشاغلا به فسئل عن غيره فيخبر عنه في الحال فيعلم أنه لم يفكر فيه فيدعوه إلى الكذب داع علمنا صدقه.
وكذلك أن يخبر الإنسان بأسعار بلده وهو ذو مروءة تصرفه عن الكذب ولا يكون له إلى الكذب في ذلك داع.
وهذه الأمور تقتضي أنْ لا غرض للمخبِر في الكذب- فيبطل بذلك أن يتعمَّد الكذب، فيعلم أنه إنما تعمَّد الصدق، وهذا استدلال على الشيء بإبطال ضده.
2- أمور ترجع إلى غير أحوال المخبِر، ومثاله: اقتران الواعية- أي: الصراخ – وحضور الجنازة بالخبر عن الموت.
– وقد اعترض المانعون: بأن جميع ما قالوه لا يوجب العلم؛ لأن رسول السلطان قد يشتبه عليه الذي أمَرَه به السلطانُ فيُخْبِر بغيره، وإن لم يتعمَّد الكذب، وقد يُرغَّب بالمال الكثير أن يفعل ذلك فيفعله متوخيًا أن يعتذر بما يقبله السلطان، أو لأن السلطان لابد له منه، ويحتمل أن يكون السلطان أمَرَه بذلك اختبارا لطاعةَ جنده، وربما أمره بذلك استهزاءً، وإذا احتمل ذلك لم نعلم أنه لا غرضَ له في الكذب فيعلم صدقه.
وكذلك قد يكون الإنسان مهتمًا بما يُسأل عنه، ويظهر أنه مهتم بغيره متشاغل بسواه، فإذا سُئِل عنه تنبَّه كأنه كان ساهيًا عنه ليوهم أنه لم يتعمَّد الكذب، ولكنه تَعَمَّدَهُ ورَعَاهُ.
وكذلك قد يسبق من الإنسان يمينٌ في أن يكذب في سعر الأشياء، أو يكون غرضه أن يعجب الناس بغلاء الأسعار أو رخصها وإن كان كاذبا، أو يكون له غرضٌ في نَفَاق سلعته أو سلعة صديقه، وقد يشتبه عليه الحال في ذلك فيخبر بالكذب وإن لم يتعمده.
وكذلك فإنه قد يخبرنا الإنسان بموت المريض، ويكون غرض أهله بالصراخ عليه وإحضار الجنازة إيهام السلطان موته؛ ليسلم منه، أو يكون قد أُغْمِي عليه، أو يكون غيره قد مات فجأة، وإذا أمكنت هذه الوجوه لم يعلم أنه لا غرض للمخبر إلا الصدق فلم يُعلَم صدقُه وإنْ غَلَب الظنُّ([82]).
ويجاب عليهم: بأن هذه المناقشة في المثال، ولا يلزم منها إبطال الحكم الكلي([83]).
– وقد نقل عن بعض العلماء القول بإفادة خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلم الضروري، بمعنى أنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال ويعرفه كل الناس؛ ولا يصح ذلك لأن من القرائن مَن لا يعرفها كلُّ الناس، ويعرفها بعضُهم فقط كما سبق عن ابن حجر، وكذلك فإنه سيكون مساويا للمتواتر، ويقف أمامَهُ، ولن يُقَدَّم المتواترُ عليه، ويكون كالمتواتر يكفرمنكره، وكل هذا لا يصح([84]).
والله أعلم.
كتبه:
مصطفى عبد الله عبد الحميد (الباحث بقسم الأبحاث الشرعية)
13/2/2008م
قرأه وحكَّمَه وأجازه للنشر:
أ.د/ محمد رأفت عثمان (عضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ بجامعة الأزهر)
المصادر:
—————————–
إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر، للدكتور/ عبد الكريم النملة، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع.
– إتحاف فضلاء البشر، للشيخ/ أحمد بن محمد البنا الدمياطي، الناشر: عالم الكتب (بيروت)، ومكتبة الكليات الأزهرية (القاهرة)، تحقيق دكتور/ شعبان محمد إسماعيل.
– أصول السرخسي، للإمام شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، الناشر: دار الكتب العلمية.
– إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي المالكي، ومعه (مكمل إكمال الإكمال) للسنوسي الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت).
– الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي، الناشر: دار الحديث (القاهرة)، الطبعة الأولى.
– الإحكام، للآمدي، دار الكتاب العربي (بيروت) الطبعة الأولى، تحقيق دكتور: سيد الجميلي.
– البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي، الناشر: دار الكتبي بمصر.
– البرهان في أصول الفقه، للإمام الحرمين، الناشر: دار الوفاء (المنصورة -مصر)، تحقيق الدكتور: عبد العظيم محمود الديب، الطبعة الرابعة.
– التعارض والترجيح عند الأصوليين للدكتور/ محمد الحفناوي، الناشر: دار الوفاء (المنصورة- مصر).
– العقيدة الإسلامية وأسسها، لفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، الناشر: دار القلم (دمشق)، الطبعة الحادية عشر 1423هـ- 2002م.
– القاموس المحيط، للفيروزابادي، الناشر: مؤسسة الرسالة.
– المحصول في علم أصول الفقه، للإمام/ فخر الدين الرازي، تحقيق الدكتور/ طه جابر فياض علواني، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت.
– المستصفى، لحجة الإسلام الغزالي، الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى 1322هـ.
– المعتمد، لأبي الحسين البصري المعتزلي، الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت)، الطبعة الأولى 1403هـ، تحقيق: خليل الميس.
– المهذب في علم أصول الفقه للدكتور/ عبد الكريم النملة، الناشر: مكتبة الرشد (الرياض).
– الوجيز في علوم الحديث للدكتور/ الخشوعي الخشوعي، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر.
– أوجز المسالك إلى موطأ مالك، للإمام المحدث/ محمد زكريا الكاندهلوي، الناشر: دار القلم (دمشق).
بحوث في علم الكلام، تأليف/ سعيد عبد اللطيف فودة، الناشر: دار الرازي (الأردن)، الطبعة الأولى 1425هـ- 2004م.
– تاج العروس من جواهر القاموس، للمرتضى الزبيدي، من طباعة التراث العربي سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في الكويت، تحقيق/ عبد العليم الطحاوي، 1394هـ- 1974م.
– توضيح العقائد النسفية، للشيخ/ سليمان سليمان خميس، كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، الطبعة الثالثة 1380هـ- 1961م.
– حديث الآحاد الصحيح بين العلم القاطع والظن الراجح، للدكتور/ محمود أحمد الزين نُشر في مجلة الأحمدية، العدد الثالث، المحرم 1420هـ.
– خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة، للدكتور/ نور الدين عتر، نُشِر في مجلة التراث العربي- مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتابالعرب- دمشق العددان: 11 -12(جمادى الآخر- رمضان) (نيسان”أبريل” – تموز”يوليو”) 1403هـ 1983م السنة الثالثة.
– دراسات أصولية في السنة النبوية، للدكتور/ محمد الحفناوي، الناشر: دار الوفاء (المنصورة- مصر)، الطبعة الأولى 1412هـ- 1991م.
– شرح الإمام جلال الدين المحلي على جمع الجوامع – مع حاشية الشيخ حسن العطار-، الناشر: دار الكتب العلمية.
– شرح الكوكب المنير، للعلامة الشيخ/ محمد الفتوحي الحنبلي المعروف بـ”ابن النجار”، تحقيق الدكتور/ محمد الزحيلي، والدكتور/ نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، 1413هـ- 1993م.
– شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي (بيروت)، الطبعة الثانية 1392هـ.
– شرح مختصر المنتهى الأصولي، لعضد الدين الإيجي- مع حواشيه، الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت).
– صحيح البخاري، تحقيق الدكتور/ مصطفى ديب البغا، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة 1407 هـ – 1987م.
– صحيح البخاري، مصورة على الطبعة اليونية، الناشر: دار طوق النجاة.
– صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
– ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، لفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، الناشر: دار القلم (دمشق).
– فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني دار المعرفة (بيروت) 1379هـ.
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، للشيخ/ محب الله ابن عبد الشكور، الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى 1322هـ.
– كبرى اليقينيات الكونية لفضيلة الدكتور/ محمد رمضان البوطي، الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت)، ودار الفكر (دمشق)، تصوير عن الطبعة الثامنة 1417هـ- 1997م.
– لسان الميزان، للحافظ ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات (بيروت)، الطبعة الثالثة 1406 هـ- 1986م، تحقيق: دائرة المعرف النظامية (الهند).
– لطائف الإشارات شرح نظم الورقات، للشيخ/ عبد الحميد قدس، الناشر: مصطفى البابي الحلبي.
– مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، اختصار: محمد ابن الموصلي، تحقيق الدكتور: الحسن بن عبد الرحمن العلوي، الناشر : أضواء السلف، الطبعة الأولى 1425هـ – 2004م.
– مفاتيح الغيب، تفسير الإمام الرازي، الناشر: دار الفكر (دمشق).
– نزهة الخاطر العاطر، للعلامة ابن بدران الدمشقي، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية.
– نزهة النظر شرح نخبة الفكر، للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي مالك كمال سالم، مكتبة العلم (القاهرة).
– نفائس الأصول، للشهاب الدين القرافي، الناشر: نزار مصطفى الباز، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، الطبعة الأولى 1413هـ – 1995م.
– نهاية السول شرح منهاج الأصول للإمام/ جمال الدين الإسنوي، ومعه حاشية العلامة/ محمد بخيت المطيعي، الناشر: عالم الكتب، مصورة على الطبعة السلفية.
– وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، للألباني، من رسائل الدعوة السلفية.
الهوامش:
——————————————————————————–
([1]) انظر: لوامع الأنوار (1/5).
([2]) أي: الذي لا يتغير في المستقبل.
([3]) المراد بالإثبات والنفي المعنى اللغوي، الذي هو إثبات أحد الطرفين للآخر في الإثبات، وعدم إثبات أحدهما للآخر في النفي.
([4]) فالصفة أوجبت التمييز للنفس؛ لأن النفس هي التي تميز، والصفة آلة لها في تمييز
الشيء.
([5]) فالظن محتمل للنقيض بمعنى أن القضية المظنونة يجوز أن يتصف طرفاها بالنفي المرجوح بدل الثبوت الراجح إذا كانت موجبة، أو العكس إذا كانت سالبة. انظر: توضيح العقائد النسفية، للشيخ/ سليمان سليمان خميس (1/66).
([6]) وانقسم العلم إلى ضروري وكسبي؛ لأنه لو كان الكل ضروريا لما احتجنا إلي تحصيله، فلن نجهل شيئا، ولو كان الكل كسبيا؛ لدار أو تسلسل.
([7]) انظر: شرح الكوكب المنير (1/67).
([8]) يقول الدكتور/ نور الدين عتر: “علم غلبة الظن، والمراد بها: إدراك رجحان صدق القضية ووقوع ذلك في القلب موقعالقبول، وذلك في كل قضية دل دليل صحيح على ثبوتها، لكن بقي احتمال مغلوب بعدمالثبوت لم يقطع الدليل ذلك الاحتمال، فهذا الاحتمال لا يمنع من القبول، وربما يظنه بعض الناس ولاسيما العوام يقينا، لعدم تفريقهم بين الأمرين، وإنما هو علم قائم على الشعور القوي بصحة القضية، وهذا يجب العمل به والأخذ بمقتضاه في الأحكام… وهو في الواقع نوع من العلم، كما قال بعض الأصوليين: إنه إدراكالطرف الراجح. وهو ملزم أيضًا، لكن العلماء نبهوا على هذا الاحتمال الضعيف الذي في هذا النوع الذي لا يلتفت إليه”.
انظر: بحث “خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة” للدكتور/ نور الدين عتر، نُشِر في مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب- دمشق العددان: 11 -12(جمادى الآخر- رمضان) (نيسان”أبريل” – تموز”يوليو”) 1403هـ 1983م السنة الثالثة.
([9]) انظر فيما سبق من التعريفات: شرح الكوكب المنير للعلامة البهوتي الحنبلي (1/63) وما بعدها، ولطائف الإشارات للشيخ/ عبد الحميد قدس ص (14- 16)، و إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر للدكتور/ عبد الكريم النملة (1/307) وما بعدها، وضوابط المعرفة ص (123) وما بعدها.
([10]) وتقييد الحواس بالسليمة، لأن غيرها لا وثوق بها، فلا تكون موجبة للعلم بمعنى اليقين.
([11]) انظر: بحوث في علم الكلام للشيخ/ سعيد فودة ص (35).
([12]) انظر: العقيدة الإسلامية للشيخ/ عبدالرحمن حبنكة الميداني ص (34).
([13]) الخبر الصادق قسم من الخبر المطلق، والخبر: هو المركب التام الذي يكون لنسبته خارجٌ تطابقه تلك النسبة أو لا تطابقه، فإن طابقت النسبة الخارج فالخبر صادق، وإلا فكاذب.
([14]) فالمعتبر في التواتر تحقق وصف القوم – أو الجماعة – بإحالة تواطؤهم على الكذب عادة من غير حصر في عدد معين بشرط أن يكونوا مستندين في إخبارهم إلى الحس
لا إلى العقل، لأن المعقول يمكن فيه الخطأ، كخبر الفلاسفة في قدم العالم. انظر: شرح العلامة المحلي على جمع الجوامع (2/147- 148).
([15]) المعجزة: أمر خارق للعادة قُصِد به إظهارُ صدق من ادعى أنه رسول لله تعالى.
([16]) فخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حضرته يفيد القطع واليقين في حق السامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف مَن لم يسمع منه مباشرة.
([17]) انظر: العقيدة الإسلامية للشيخ/ عبدالرحمن حبنكة الميداني ص (37).
([18]) أي: يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر؛ لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر، كالبله والصبيان.
([19]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «العلم» باب «من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم» حديث (108)، ومسلم في المقدمة باب «تغليظ الكذب على رسول الله» حديث (2) من حديث أنس ولفظه: “مَن تعمَّد علي كذِبًا فليتبوأ مقعده مِن النار “.
وأخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» باب «ما يكره من النياحة على الميت» حديث (108)، ومسلم في المقدمة باب «تغليظ الكذب على رسول الله» حديث (4) من حديث المُغِيرة بن شُعبة لفظه: “إِن كذِبًا علي ليس ككذِبٍ على أحد, فمن كذب علي مُتعمدًا فليتبوأ مقعده مِن النار”.
وأخرجه البخاري في كتاب «العلم» باب «من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم» حديث (110)، ومسلم في المقدمة باب «تغليظ الكذب على رسول الله» حديث (3) من حديث أبِي هريرة ولفظه: “ومَن كذب علي مُتعمدًا فليتبوأ مقعده مِن النار”.
وأخرجه البخارِي في كتاب «العلم» باب «من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم» حديث (109) عن سلمة بن الأكوع ولفظه: “مَن يقُل علي ما لم أقُل فليتبوأ مقعده مِن النار”.
والحديث قد روي عن غير هؤلاء من الصحابة في السنن والمسانيد حتى بلغ مبلغ التواتر.
([20]) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1/68).
([21]) انظر: شرح العلامة المحلي على جمع الجوامع (2/147- 148).
([22]) أي: على وجه العادة من الخبر مجرَّدًا عن القرائن الخارجية بخلاف خبر الآحاد.
([23]) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (2/147- 148)، ودراسات أصولية في السنة النبوية للدكتور/ محمد الحفناوي ص (143)، وبحث “حديث الآحاد الصحيح بين العلم القاطع والظن الراجح” للدكتور/ محمود أحمد الزين ص (137) نُشر في مجلة الأحمدية، العدد الثالث، المحرم 1420هـ.
([24]) انظر: فواتح الرحموت (2/111).
([25]) الحديث الصحيح: هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معلا.
([26]) انظر: البرهان (1/329)، والمستصفى (1/145)، وشرح المحلي على جمع
الجوامع (2/157)، ونزهة الخاطر العاطر للعلامة ابن بدران الدمشقي(1/202)، ودراسات أصولية في السنة النبوية ص (170).
([27]) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/103).
([28]) قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان( 5/291) في ترجمة ابن خويز منداد ما نصه: “وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب، كقوله: إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار، وإن خبر الواحد مفيد العلم، وإنه لا يعتق على الرجل سوى الأباء والأبناء.
وقد تكلَّم فيه بن الوليد الباجي، ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه وكان يزعم أن مذهب مالك أنه لا يشهد جنازة متكلم، ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا أمانتهم، وطعن ابن عبد البر فيه أيضا”.
([29]) انظر: البحر المحيط (6/134- 135).
([30]) المصدر السابق.
([31]) انظر: دراسات أصولية في السنة النبوية ص (169).
([32]) انظر: إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر (3/122) للدكتور/ عبد الكريم النملة.
([33]) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (4/1491).
([34]) انظر: بحث “حديث الآحاد الصحيح بين العلم القاطع والظن الراجح” للدكتور/ محمود أحمد الزين ص (137) نشر في مجلة الأحمدية، العدد الثالث، المحرم 1420هـ.
([35]) أي: المعنوي. انظر: دراسات أصولية في السنة النبوية ص (171)، وإتحاف ذوي البصائر (3/126).
([36]) انظر: إتحاف ذوي البصائر (3/125) وما بعدها.
([37]) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (1/202).
([38]) المستصفى (1/145).
([39]) البحر المحيط (6/136).
([40]) وإلا لترتب على ذلك أن آحاد المسلمين من العدول الثقات يكونوا معصومين، وبهذا نكون قد أعطينا العصمة لمن ليس بمعصوم.
([41]) انظر: بحث “خبر الواحد الصحيحوأثره في العمل والعقيدة” للدكتور/ نور الدين عتر.
([42]) ومن العجيب ما ذكره أحد الكاتبين أن من ثمرة ذلك القول الباطل “أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد” إنكار ما عليه المسلمون من العقائد الإسلامية الصحيحة التي تلقاها الخلف عن السلف، وجاءت الأحاديث متضافرة متوافرة شاهدة عليها، فهو قول يؤدي إلى الضلال البعيد، فمن الأمثلة التي ذكرها:
– نبوة آدم عليه السلام، وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن.
– أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين.
– شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى في المحشر، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وغير ذلك مما لا طائل وراء ذكره؛ فإنه قد نقض دعواه في نهاية كلامه بقوله “إن هذه العقائد الإسلامية الصحيحة قد وردت في الأحاديث الثابتة المتواترة أو المستفيضة وتلقتها الأمة بالقبول”، ولا يخفى على القارئ أن أصل الخلاف في خبر الآحاد الصحيح المجرد عن القرائن.
أما المتواتر فإنه مفيد للعلم، والمستفيض مع وجود القرينة فإنه مفيد العلم النظري- كما سيأتي بيانه؛ فيصح إثبات العقيدة بهما.
وأعجب من ذلك ادعائه لبعض الفروع أنها من العقيدة التي يجب على المسلم اعتقادها، وبعضها قد يعتمد على حديث ضعيف على قول كثير من العلماء، ولكن بما أن الكاتب صحح الحديث، فمضمونه يجب أن يكون عقيدة صحيحة، من لا يعتقدها يكن في ضلال بعيد، مثل: كون المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي التي تتمسك بما كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة وهدى.
فهل يصح شرعا أو عقلا أن يكون هذا الفرع من العقيدة التي يترتب عليها تضليل الآخرين؟!
([43]) انظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (1/202).
([44]) كذا في الطبعة اليونينية في كتاب «السهو» باب «من يكبر في سجود السهو» (2/68)، وفي نُسخٍ أخرى للبخاري “ذا اليدين”.
([45]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «السهو» باب «من يكبر في سجود السهو» (2/68) واللفظ له، ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «السهو في الصلاة والسجود له» في حديث (572).
([46]) ولذلك فإن الجمهور من العلماء يُرجِّح بين الروايات عند التعارض بناء على كثرة الرواة. انظر: الإحكام للآمدي (2/81)، والتعارض والترجيح عند الأصوليين للدكتور/ محمد الحفناوي ص (309).
([47]) قال ابن حجر في فتح الباري (7/303): “قوله (وهل) قيل: بفتح الهاء، والمشهور الكسر، أي: غلط، وزنًا ومعنًى، وبالفتح معناه: فزع ونسي وجبُن وقلق، وقال الفارابي والأزهري وابن القطاع وابن فارس والقابسي وغيرهم: وهَلْتُ إليه، بفتح الهاء، أهِل – بالكسر – وهْلا – بالسكون – إذا ذهب وهمُك إليه، زاد القالي والجوهري: وأنت تريد غيره، وزاد ابن القطاع”.
([48]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «المغازي» باب «قتل أبي جهل» حديث (3759)، ومسلم في كتاب «الجنائز» باب «الميت يعذب ببكاء أهله» حديث (932).
([49]) انظر: فتح الباري (7/303) وما بعدها.
([50]) ولا يكون المعارض قاطعًا أيضا؛ لأن القطعيات لا تتعارض وإلا لما كانت قطعيات.
([51]) انظر: بحث “حديث الآحاد الصحيح بين العلم القاطع والظن الراجح” للدكتور/ محمود أحمد الزين.
([52]) جمهور الأصوليين على عدم الجواز الشرعي لنسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد، مع كونه جائزا عقلا، انظر: إتحاف ذوي البصائر (2/533) وما بعدها.
([53]) انظر: البرهان (1/329).
([54]) انظر: شرح النووي على مسلم (1/131- 132).
([55]) انظر: الإحكام لابن حزم (1/112)، ومختصر الصواعق المرسلة (3/1534) وما بعدها، ورسالة “وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة” للألباني.
– وقد أعرضنا عن ذكر بعض ما استدلوا به ومناقشته؛ لكونها لا تخرج عن أن تكون حججا شعرية، والحجة الشعرية: هي التي لا يُشترط فيها أن تفيد ظنا راجحا مقبولا، بل قد تعتمد على مقدمات وهمية، وصور كاذبة لا تخفى على المخاطب، إلا إنها تشتمل على ما يتلاعب بمشاعر المخاطب النفسية، فيتأثر بها ويستجيب لمضمونها، وقد يكون عالما فكريا بعدم صحتها، فهي لا تفيد يقينا ولا تفيد ظنا راجحا. انظر: ضوابط المعرفة ص (300- 302).
([56]) انظر: فتح الباري (1/507)، وشرح صحيح مسلم للأبي ومعه شرح السنوسي (2/231).
([57]) أوجز المسالك إلى موطأ مالك، للإمام المحدث/ محمد زكريا الكاندهلوي (4/190).
([58]) انظر: إتحاف فضلاء البشر، للشيخ/ البنا الدمياطي (2/486).
([59]) أَصل الإنذار: الإعلام، يقال: أَنْذَرَهُ بالأَمْر إنْذارًا ونَذْرًا، أي: أعْلَمَهُ، وحَذَّرَهُ، وخَوَّفَهُ في إبلاغه. انظر: القاموس المحيط مادة (ن ذ ر)، وتاج العروس (14/200)، وعليه فلا وجه للتخصيص في الإعلام بين ما يفيد العلم أو الظن.
([60]) انظر: المحصول للإمام الرازي (4/354) وما بعدها.
([61]) أخرجه البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء» باب «ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث (3274).
([62]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة» باب «أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» حديث (1425) واللفظ له، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث (19).
([63]) هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب «التوحيد» باب «ما جاء في دعاء النبي صلى
الله عليه وسلم» حديث (6937).
([64]) انظر: تفسير الإمام الرازي (25/46).
([65]) انظر: نفائس الأصول للقرافي (7/2925) بتصرف.
([66]) انظر: حاشية العلامة محمد بخيت المطيعي على شرح الإسنوي (3/117).
([67]) في الأصل المطبوع (ولوجود)، والصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. انظر: نفائس الأصول شرح المحصول (7/1942).
([68]) انظر: كبرى اليقينيات الكونية لفضيلة الدكتور/ محمد رمضان البوطي ص (36).
([69]) انظر: دراسات أصولية في السنة النبوية ص (174).
([70]) انظر: حاشية العلامة محمد بخيت المطيعي على شرح الإسنوي (3/118)، والمهذب في علم أصول الفقه للدكتور/ عبد الكريم النملة (4/682).
([71]) انظر: بحث “حديث الآحاد الصحيح بين العلم القاطع والظن الراجح” للدكتور/ محمود أحمد الزين.
([72]) انظر: المحصول للرازي (4/282)، والإحكام للآمدي (2/53)، ونفائس الأصول للقرافي (7/2920- 2921)، وشرح مختصر المنتهى الأصولي- مع حواشيه (2/417)، شرح المحلي على جمع الجوامع (2/157).
([73]) البرهان (1/374).
([74]) المستصفى (1/136- 137).
([75]) البحر المحيط (6/116).
([76]) انظر: دراسات أصولية في السنة النبوية، للدكتور/ محمد الحفناوي ص (177).
([77]) انظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص (23- 25).
([78]) انظر: شرح النووي على مسلم (1/20).
([79]) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص (23).
([80]) انظر: حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح المختصر (2/418)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (2/157). ودراسات أصولية في السنة النبوية ص (179).
([81]) انظر: المستصفى (1/135).
([82]) انظر: المعتمد (2/94).
([83]) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (2/157).
([84]) انظر: أصول السرخسي (1/330)، ودراسات أصولية في السنة النبوية ص (181).