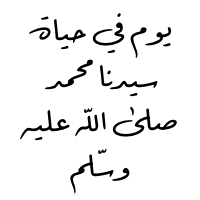حكم تعلم علم الكلام والسبب في نهي السلف عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم تعلم علم الكلام والسبب في نهي السلف عنه
خير ما نفتتح به هذه المقالة كلام إمام جليل عليم بالكلام خبير وهو حجة الإسلام الغزالي.
قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين
فإن قلت: تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه؟ فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف.
فمن قائل: إنه بدعة وحرام، وأن العبد لأن يلقى الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام.
ومن قائل: إنه واجب وفرض إما على الكفاية أو على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد، ونضال عن دين الله تعالى.
وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف، قال ابن عبد الأعلى رحمه الله تعالى : سمعت الشافعي -رضي الله تعالى عنه- يوم ناظر حفصا الفرد – وكان من متكلمي المعتزلة- يقول : لأن يلقى اللهَ العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام، ولقد سمعت من حفص الفرد كلاما لا أقدر أن أحكيه، وقال أيضا: قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط، وأن يبتلي الله العبد بكل ما نهى الله تعالى عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام ، وقال: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد. وقال: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأخذ في الكلام.
وقال أحمد بن حنبل : لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل، وبالغ في ذمه، حتى هجر الحارث المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة، وقال له ويحك تحكي بدعتهم أولا، ثم ترد عليهم ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة، والتفكر في تلك الشبهات، فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث، وقال أحمد –رحمه الله تعالى-: علماء الكلام زنادقة…[1]
وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه.
وقالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق، وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر، ولذلك قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ) أي المتعمقون في البحث والاستقصاء.
أما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا : لا نعنى به-أي بالكلام-إلا معرفة الدليل على حدوث العالم ووحدانية الخالق وصفاته كما جاء في الشرع، فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل؟ وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بها ، والبحث عنها محظورا؟ وقد قال الله تعالى ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فطلب منهم البرهان ، وقال تعالى (ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة ) وقال تعالى ( قل فلله الحجة البالغة) وقال تعالى ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى قوله فبهت الذي كفر ) إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ، ومجادلته وإفحامه خصمه في معرض الثناء عليه ، وقال عز وجل ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) وقال تعالى ( قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) وقال تعالى في قصة موسي عليه السلام ومباحثته مع فرعون: ( وما رب العالمين إلى قوله : أو لو جئتك بشيء مبين )
وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار مملوء بالحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد ، وإثبات الباري والمَعاد، وإرسال الرسل ، فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلا صحيحا على ذلك إلا وهو في القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان ، وأتم معنا ، وأبعد عن الإيراد والأسئلة ، وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين.
فعمدة المتكلمين في التوحيد قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) وفي النبوة ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) وفي البعث ( قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) إلى غير ذلك من الآيات والأدلة ، ولم تزل الرسل عليهم الصلاة والسلام يحاجون المنكرين ويجادلونهم ، قال تعالى ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا كانوا يحاجون المنكرين ، ويجادلون ، ولكن عند الحاجة ، وكانت الحاجة إليه قليلة في زمانهم فلذا كان الخوض فيه قليلا.
فإن قلت: فما المختار عندك فيه فاعلم أن إطلاق القول بذمه في كل حال، أو بحمده في كل حال خطأ، بل لابد فيه من تفصيل.
فنقول: إن فيه منفعة، وفيه مضرة فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام.
أما مضرته فإثارة الشبهات، وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق.
وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق، ومعرفتها على ما هي عليه وعمارة القلب بنور اليقين ، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف.
وهذا الكلام إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء لما جهلوا فاسمع هذا الكلام ممن خبر هذا الكلام، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة، وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى معرفة الحقائق من هذا الوجه مسدود .
ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف، وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور، وفي أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام.
بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل، فان العامي ضعيف يستفزه جدل المبتدع وان كان فاسدا.
وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته ، فينبغي أن يكون الناظر فيه كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر، إذ لا يضعه إلا في موضعه، وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة .
وتفصيله أن العوام المشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها، فان تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم، إذ ربما يثير لهم شكا، ويزلزل عليهم الاعتقاد، ولا يمكن القيام بعد ذلك بالإصلاح.
وأما العامي المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب، وبالكلام المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج بفنٍ من الوعظ والتحذير، فان ذلك انفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين، إذ العامي إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده، فإن عجز عن الجواب قَدَّرَ أن المجادلين من أهل مذهبه يقدرون على دفعها، فالجدل مع هذا ومع الأول حرام، وكذا من وقع في شك إذ يجب إزالة شكه باللطف والوعظ، والأدلة القريبة المقبولة، البعيدة عن تعمق الكلام واستقصاء الجدل….
فان كانت البدعة شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا فلا بأس أن يعلموا القدر الذي أودعناه كتاب ( الرسالة القدسية) ليكون ذلك سببا لدفع تأثير مجادلات المبتدعة إن وقعت.
فإن كان فيه ذكاء وتنبه لموضع السؤال، أو ثارت في نفسه شبهة، فقد بدت العلة المحذورة، وظهر الداء، فلا بأس أن يرقي منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) وهو قدر خمسين ورقة، وليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين.
وأما الزيادة على ذلك القدر بإيراد أسئلة وأجوبة وشبهٍ تنبعث من الأفكار، فهو استقصاء لا يزيد إلا ضلالاً وجهلا في حق من لم يقنعه ذلك القدر، فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاً.
فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام، والحال التي يذم فيها، والحال التي يحمد فيها، والشخص الذي ينتفع به، والشخص الذي لا ينتفع به.
واتضح لك أن المحمود من الكلام ما هو من جنس حجج القرآن من الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب المقنعة للنفوس ، دون التغلل في التقسيمات و التدقيقات التي لا يفهمها أكثر الناس ، وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها صاحبها للتلبيس، فإذا قابله مثله في الصناعة قاومه.
وعرفت أن الشافعي وكافة السلف إنما منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما فيه من الضررّ الذي نبهنا عليه، وأن ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من مناظرة الخوارج ، وما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه من المناظرة في القدر، وغيره، كان من الكلام الجلي الظاهر ، وفي محل الحاجة ، وذلك محمود في كل حال .
نعم قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلتها، فلا يبعد أن يختلف الحكم لذلك. انتهى كلام الغزالي . ملخصا
أقول :نهي السلف عن الكلام محمول على أوجه :
الوجه الأول: أنهم نهوا عن كلام أهل البدع والأهواء، فانه كان في القديم إنما يعرف بالكلام أهل البدع والأهواء، وأما أهل السنة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة، وكانوا قلما يخوضون في الكلام قاله الإمام البيهقي، نقله عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (334) ثم قال: وناهيك بقائله أبي بكر البيهقي، فقد كان من أهل الرواية والدراية.
ثم قال ابن عساكر (345): وإنما يعني الشافعي -والله أعلم- بقوله: “ من ابتلي بالكلام لم يفلح “ كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة، وجعلوا معولهم عقولهم، وأخذوا في تسوية الكتاب عليها، وحين حملت عليهم السنة بزيادة بيان لنقض أقاويلهم اتهموا رواتها، وأعرضوا عنها، فأما أهل السنة فمذهبهم في الأصول مبني على الكتاب والسنة، وإنما أخذ من أخذ منهم في العقل إبطالاً لمذهب من زعم أنه غير مستقيم على العقل، وبالله التوفيق. انتهى.
أقول: وعلى هذا يحمل تشديدات السلف الغليظة في النهي عن الكلام كما يدل عليه سياق كلام الشافعي المتقدم بعدما ناظر حفصاً الفرد القدري، وقد جاء مصرحاً في بعض الروايات عنه، روى عنه ابن عساكر بسنده المتصل (337) أنه قال: (لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء)
قال الشافعي هذا الكلام حينما رأى قوماً يتجادلون في القدر بين يديه.وعبر عن كلامهم بالأهواء.
وروى البيهقي أنه دخل حفص الفرد على الشافعي، فقال: الشافعي بعد خروجه:
(لأن يلقى العبدُ اللهَ بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه) وكان حفص يقول بخلق القرآن، نقله ابن عساكر في التبيين (341)
الوجه الثاني: أن النهي محمول على الخوص في الكلام لمعرفة المجادلة مع الخصوم والإحاطة بمناقضة أدلتهم، والتشدق بتكثير الأسئلة والأجوبة الدقيقة، وإثارة الشبه واللوازم البعيدة مما لم يكن يعرف شيء منه في العصر الأول، بل كانوا يشددون النكير على من يفتح باب الجدل والممارات، ولذلك قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (هلك المتنطعون) أي المتعمقون في البحث والاستقصاء، وذلك لاشتمال هذا النوع من الكلام، على ما أشار إليه الغزالي رحمه الله على كثير من الخبط والتضليل، وعدم وفائه بما هو المقصود من كشف الحقائق وعمارة القلب باليقين، بل إنه مورث بالعكس من ذلك زعزعة في العقيدة، ووهناً في التصميم.
قال الغزالي: وما أحدثه المتكلمون من تفسير وسؤال وتوجيه إشكال ثم الاشتغال بحله فهو بدعة، وضرره في حق عموم الخلق ظاهر، فهذا الذي ينبغي أن يتوقى، والدليل على تضرر الخلق به المشاهدة والتجربة، وما ثار من الفتن بين الخلق منذ نبغ المتكلمون وفشي صناعة الكلام مع سلامة العصر الأول عن مثل ذلك.
وقال الغزالي أيضاً: فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تفَيئهه الرياحُ مرةً هكذا ومرةً هكذا.
الوجه الثالث: ما في التغلغل في الكلام من خطر الدخول في البدعة أو الكفر وذلك لأن الباحث فيه قد يخطئ، والخطأ فيه لا يخلو عن أحد الخطرين المذكورين. وقد أشار إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله في ما رواه عنه ابن عساكر في التبيين (343) قال: وأما استحبابه أي الشافعي ترك الخوض فيه، والإعراض عن المناظرة فيه مع معرفته به، فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمت أبا الفضل الحسن بن يعقوب العدل يقول: سمعت أبا أحمد محمد بن روح يقول: كنا عند باب الشافعي نتناظر في الكلام فخرج إلينا الشافعي رحمه الله فسمع ببعض ما كنا فيه فرجع عنا فما خرج إلينا إلا بعد سبعة أيام، ثم خرج فقال: ما منعني من الخروج إليكم عِلّةٌ عرضت، ولكن لِمَا سمعتكم تتناظرون فيه، أتظنون أني لا أحسنه؟ لقد دخلت فيه حتى بلغت فيه مبلغاً، وما تعاطيت شيئاً إلا وبلغت فيه مبلغاً حتى الرمي، كنت أرمي بين الغرضين، فأصيب من عشر تسعة، ولكن الكلام لا غاية له، تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم: أخطأتم، ولا تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال: كفرتم.
الوجه الرابع: ما اشتمل عليه علم الكلام من حكاية مذاهب أهل البدع والأهواء، وذكر الشبه الواردة على اعتقاد أهل السنة، وهذا مفض إلى نشر هذه المذاهب، وقد أمرنا بإخمادها، وموجب لتمكن هذه الشبه في القلوب.
فإن الشبهة كثيراً ما تكون واضحة ويكون الجواب عنها خفياً، ثم إن هذا يجر إلى الرأي والجدل والممارات في دين الله تعالى، وقد علمت إنكار السلف له، وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما أنكر على الحارث المحاسبي تصنيفه كتاباً في الرد على المبتدعة، فقال له: ويحك تحكي بدعتهم أولاً ثم ترد عليهم! ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة، والتفكر في تلك الشبهات؟ فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث، وقد أشار إلى هذا الغزالي بقوله: أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد، وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه.
الوجه الخامس: إن النهي محمول على الاقتصار على الكلام لما فيه من زعزعة العقيدة وسقوط هيبة الرب من القلب، قال ابن عساكر في التبيين (334): ويحتمل أن يكون مرادهم من النهي عن الكلام أن يقتصر عليه، ويترك تعلم الفقه الذي يُتوصل به إلى معرفة الحلال والحرام، ويرفض العمل بما أمر بفعله من شرائع الإسلام، ولا يلتزم فعل ما أمر به الشارع، وترك ما نهى عنه من الأحكام.
وقد بلغني عن حاتم بن عنوان الأصم وكان من أفاضل الزهاد وأهل العلم –أنه قال: الكلام أصل الدين، والفقه فرعه والعمل ثمره، فمن اكتفى بالكلام دون الفقه والعمل تزندق، ومن اكتفى بالعمل دون الكلام والفقه ابتدع، ومن اكتفى بالفقه دون الكلام والعمل تفسق، ومن تفتن في الأبواب كلها تخلص. انتهى.
والسبب فيما قاله حاتم الأصم من أن المكتفي بالكلام يتزندق أن الخائض في علم الكلام المقتصر عليه تتزعزع عقيدته، وتسقط هيبة الرب من قلبه.
وذلك لأن عمل المتكلم هو الكلام على ذات الله تعالى وصفاته وإيراد الأدلة العقلية على إثباتها، ثم إيراد الشبه على تلك الأدلة ثم الجواب عنها، ثم الكلام على ما يرد على الجواب من النقض، والإجابة عنه وهلم جراً، وهذا العمل يوجب وهنا في العقيدة، ويفضي إلى سقوط هيبة الرب سبحانه وتعالى عن القلب ومن أجل ذلك كان كثير من المتكلمين المقتصرين على الكلام رقيقي الدين، حتى نقل عن بعضهم التهاون بإقامة الصلاة.
الوجه السادس: أن النهي محمول على الدخول في الكلام والخوض فيه عند عدم الحاجة إليه، وذلك لأن أدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع بها قليل من الناس، ويتضرر بها الآخرون، فينبغي الاقتصار منها على قدر الحاجة وعلى وقت الحاجة. قال الإمام الغزالي في “ إلجام العوام عن علم الكلام “ : إن الأدلة تنقسم إلى ما يحتاج فيه إلى تفكر وتدقيق خارج عن تدقيق العامي وقدرته، وإلى ما هو جلي سابق إلى الإفهام ببادئ الرأي، واقل النظر، بل يشترك فيها كافة الناس بسهولة لا خطر فيه، وما يحتاج إلى التدقيق فليس على قدر وسعه.
فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس، ويستضر به الأكثرون، بل أدلة القرآن كالماء ينتفع به الصبي والرجل القوي، وسائر الأدلة كالأطعمة، ينتفع بها الأقوياء مرة، ويمرضون بها أخرى، ولا ينتفع بها الصبي أصلاً.
وأما معرفة الكلام الذي لا يخالف الكتاب والسنة، واستعماله عند الحاجة فليس بمذموم، وقد اشتهر غير واحد من علماء الإسلام ومن أهل السنة قديماً بالكلام. قاله ابن عساكر (352) وقدمنا أن الإمام الشافعي كان ضليعاً منه.
قال ابن عساكر (339) والكلام المذموم كلام أصحاب الأهوية، وما تزخرفه أرباب البدع المردية، فأما الكلام الموافق للكتاب والسنة الموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة، فهو محمود عند العلماء ومن يعلمه، وقد كان الشافعي يُحْسِنه، ويَفْهمه، وقد تكلم مع غير واحد ممن ابتدع، وأقام الحجة عليه حتى انقطع، ثم أورد ابن عساكر جملة من مناظرات الشافعي للمبتدعة الدالة على أنه كان متضلعاً من هذا العلم، ثم قال ص351: فأما الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة، ويبين بالعقل والعبرة، فإنه محمود مرغوب فيه عند الحاجة، تكلم فيه الشافعي وغيره من أئمتنا رضي الله تعالى عنهم عند الحاجة كما سبق ذكرنا له.
وقال الإمام تقي الدين السبكي في نقده لنونية ابن القيم: لا تشتغل من العلوم إلا بما ينفع، وهو القرآن والسنة والفقه وأصول الفقه والنحو، وبأخذها عن شيخ سالم العقيدة، وبتجنب علم الكلام والحكمة اليونانية، والاجتماع بمن هو فاسد العقيدة، أو النظر في كلامه، وليس على العقائد أضر من شيئين: علم الكلام، والحكمة اليونانية، وهما في الحقيقة علم واحد، وهو العلم الإلهي، لكن اليونان طلبوه بمجرد عقولهم، والمتكلمون طلبوه بالعقل والنقل، وافترقوا ثلاث فرق:
إحداها غلب عليها جانب العقل، وهم المعتزلة.
والثانية غلب عليها جانب النقل، وهم الحشوية.
والثالثة استوى الأمران عندهم، وهم الأشعرية.
وجميع الفرق الثلاث في كلامها مخاطر، إما خطأ في بعضه، أو سقوط هيبة، والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس الباقون على الفطرة السليمة، ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى ينهى الناس عن الاشتغال بعلم الكلام، ويأمرهم بالاشتغال بالفقه وهو طريق السلامة.
ولو بقي الناس على ما كانوا عليه في زمن الصحابة كان الأولى للعلماء تجنب النظر في علم الكلام جملة، لكن حدثت بدع أوجبت للعلماء النظر فيه لمقاومة المبتدعين، ودفع شبههم عن أن تزيغ بها قلوب المهتدين. انتهى.
والحاصل أن المتكلمين قد وعروا الطريق إلى تحصيل العقيدة وحاولوا أثباتها ودفع الشبه عنها بكلام خفي دقيق طويل مبني على مقدمات فلسفية غير واضحة محتاجة ألى الأثبات بدلائل ركيكة صعبة الفهم عسيرة الهضم، قابلة لورود الشبه والشكوك والأنتقادات عليها، فبعد تقرير هذه الدلائل يشتغلون بدفع الإنتقادات الواردة عليها، وكثيرا ما يكون الدفع أيضا موردا للانتقاد، فيحاولون دفعه، وهكذا… فصار الكلام الذي مارسوه ووسعوا الكلام فيه قليل النفع كثر الضرر مخلفا ورائه شبها في العقول ووهنا في العقيدة، بدلا عن إيراثه الطمأنينة في الصدور والثلج في القلوب، فهو كلحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي، ولا سمين فينتقي، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريراً، وأحسن تفسيراً، وليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل:
لولا التنافس في الدنيا لما وضعت :: كتب التناظر لا المغني ولا العَمَد
يحللون بزعم منهم عقدا :: وبالذي وضعوه زادت العقد
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك.
ومن طريف ما بلغني أن بعض الأساتذة- وكان المقرر في قطرهم تدريس شرح العقائد النسفية للتفتازاني- كان عقب الإنتهاء من تدريس هذا الكتاب يدرس تلامذته كتاب الشفاء للقاضي عياض إصلاحا لما أفسده الشرح المذكور وتلافيا لما أورثه تدريسه من زعزعة في العقيدة ومن الوهن في التصميم.
وهذا ما أشار إليه الإمام الرازي في وصيته حيث قال فيها: ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذلك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة، والمناهج الخفية، فلهذا أقول:
كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبرائته عن الشركاء كما في القدم والأزلية، والتدبير والفعالية فذلك هو الذي أقول به، وألقى الله به.
وأما ما لا ينتهي الأمر فيه إلى الدقة والغموض، وكل ما ورد في القرآن والصحاح المتعين للمعنى الواحد فهو كما قال.
والذي لم يكن كذلك أقول: يا إ̃له العالمين: إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، فكل ما مده قلمي أو خطر ببالي فاستشهد وأقول: إن علمت مني أني أردت به تحقيق الباطل، أو إبطال حق، فافعل بي ما أنا أهله، وإن علمت مني أني ما سعيت إلا في تقديس ما اعتقدت أنه الحق، وتصورت أنه الصدق فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي فذلك جهد المقل…
وقد أورد الوصية بتمامها تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 8/91.
فظهر لنا مما تقدم أن هناك نوعان من الكلام: محمود، ومذموم:
أما المذموم فهو الكلام على طريقة الفلاسفة و على طريقة أهل ألأهواء والبدع الذين غلبوا جانب العقل، وتركوا الكتاب والسنة، وجعلوا معولهم عقولهم، وأخذوا بتسوية الكتاب والسنة عليها، و الكلام على طريقة المتنطعين والمتغلغلين في التقسيمات والتدقيقات التي لا يفهمها إلا قلة قليلة من الناس المتشدقين بتكثير الأسئلة والأجوبة الدقيقة مما أحدثه المتكلمون من تفسير وسؤال وتوجيه وإشكال، ثم الإشتغال بحله، ومن إثارة اللوازم البعيدة والإكثار من إيراد الشبه الواردة على عقائد أهل السنة مما لم يكن يعرف شيء منه في العصر الأول، بل كانوا يشددون النكير على من يفتح باب الجدل والمماراة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “ هلك المتنطعون “ أي المتعمقون في البحث والإستقصاء، وذلك لاشتمال هذا النوع من الكلام – كما قال الغزالي – على كثير من الخبط والتضليل، وعدم وفائه بما هو المقصود منه من كشف الحقائق وعمارت القلوب باليقين، بل إنه مورث – بالعكس من ذلك – زعزعة في العقيدة ووهنا في التصميم.
فهذا هو الكلام الذي ذمه السلف، ونهوا عن الإشتغال به، وكان علم الكلام عندهم منصرفا إلى هذا النوع، ومن أجل ذلك أطلقوا ذمه والنهي عنه ولم يفصلوا. ولا يزال هذا الإسم منصرفا إلى هذا النوع بحيث لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه إلا هذا النوع، وإن كانت التعريفات التي صاغوها لعلم الكلام أعم منه وشاملة للنوع المحمود منه كما سيأتي.
وأما الكلام المحمود: فهو ما تورد فيه العقائد الإسلامية ويستدل عليها بما هو من جنس حجج القرآن من الكلمات المؤثرة في القلوب، المقنعة للنفوس، المورثة لثلج الصدور وطمأنينة القلوب من الأدلة الجلية الظاهرة.
فإن أدلة القرآن – كما قال الغزالي- مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس ويستضر به الأكثرون، بل أدلة القرآن مثل الماء ينتفع به الصبي والرجل القوي، وسائر الأدلة كالأطعمة ينتفع به القوي مرة، ويمرض به أخرى، ولا ينتفع به الصبي أصلا.
وهذا النوع من الكلام قد جاء به الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى تعالى عليهم أجمعين وسلم. وقد حث الله تعالى على تعلمه في آيات كثيرة تحث على استعمال العقول في فهم ما جاء به القرآن وفي قبوله والإذعان له، وتأمر بالإحتجاج على الكفار و بمطالبتهم بالحجة، وقد أوجبه الله تعالى بقوله: ( وجادلهم بالتي هي أحسن)، وقد حشى الله تعالى كتابه بهذا النوع من الإستدلال فإن القرآن – كما قال الغزالي – من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار، مملوء بالحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد… إلى آخر ما نقلناه عنه آنفا.
هذا هو النوع المحمود من الكلام، والنوع الأول هو المذموم منه،
لكنه لا يخفى أن مجموعة كبيرة من علماء أهل السنة والجماعة من لدن عهد السلف قد اشتغلوا بالنوع الأول منه، واعتنوا به ووسعوا الكلام فيه كالحارث بن أسد المحاسبي، والقلانسي، وابن كُلاَبٍ، وحسين بن علي الكرابيسي، والإمامين: أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي المعين النسفي، وإمام الحرمين، والغزالي، وفخرالدين الرازي، والشهر ستاني، والآمدي، والقاضي عضدين الإيجي، وسعد الدين التفتازاني، والسيد الشريف الجرجاني، وغيرهم.
والعذر للأوائل من هؤلاء العلماء في ذلك أنه قد نجم على عهدهم شبه مصدرها الفلسفة، قد أوردها أصحابها على عقائد الإسلام وأصوله، وظهرت بدع وأهواء منشؤها كلام أهل البدع والأهواء، فرأى هؤلاء العلماء أنه من الواجب عليهم – حفاظا على أصول الإسلام أن تتطرق إليها الشبه، وعلى عقيدة المسلمين أن تتزعزع وأن تشوبها البدع- أن يدفعوا تلك الشبه، ويردوا على تلك البدع والأهواء، ويبنوا بطلانها، ورأوا أن أفضل أسلوب لدفع تلك الشبه وللرد على تلك البدع هو الأسلوب كلامي الذي هو منشئها كي يكون الرد أقوى وأشد إلزاما لأصحابها. وهذا ما أشار إليه الغزالي بقوله: “ فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال “ ، ونبه عليه السبكي بقوله: “ ولو بقي الناس على ما كانوا عليه في زمن الصحابة لكان الأولى للعلماء تجنب النظر في علم الكلام جملة، ولكن حدثت بدع أوجبت للعلماء النظر فيه لمقاومة المبتدعين ودفع شبههم عن أن يزيغ بها قلوب المهتدين. “
ثم بعد موت تلك الشبه واندثار تلك البدع استمر علم الكلام حيا على أيدي مجموعة من المتأخرين من علماء الأمة، فصاروا يقارعون عدوا ميتا، ويدفعون شبها ويبطلون بدعا لا وجود لها في عالم العقول الحية، وإنما مثواها بطون الكتب والزبر.
نعم بعد ما دون هذا العلم واستقر كأحد علوم الإسلام صار العالم الإسلامي الموسوعي بحاجة ماسة إلى معرفته أو الإلمام به لما له من العلاقة القوية بالعلوم الإسلامية الأخرى، ولاشتباك مصطلاحاته ومسائله بكثير من تلك العلوم.
فمن أجل ذلك إستمر الإعتناء بهذا العلم في الأوساط العلمية، وتتابع تدريسه في المدارس الإسلامية.
وقد صار المسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى علم كلام جديد يدلل العقائد الإسلامية بدلائل تتناسب مع عقول الناس اليوم وتتوائم مع ثقافتهم، ويرد على الشبه التي انتجتها عقول أعداء الإسلام الذين يكيدون له، ويتربصون بالمسلمين الدوائر من الملاحدة والمستشرقين وغيرهم، وقد تكفل الله بالحفاظ على هذا الدين بقوله: (إنا نحن نزانا الذكر وإنا له لحافظون)، ونحمد الله تعالى على أن أنجز وعده بتنشئة نخبة من العلماء الربانيين النابغين في شتى المجالات العلمية المتحمسين لدينهم المضحين في سبيله بالنفس والنفيس قاموا بالذود عن حمى الإسلام وحماية حقيقته، وبالتدليل على عقائده وأصوله، وبإثبات حقائقه وحقانيته، وبإبطال الشبه التي أثارها أعداء الإسلام ضد عقائده وأسسه ومقرراته، فأنشئوا بذلك علم كلام جديد يناسب عقول أهل العصر، ويتوائم مع ثقافتهم. ولهم في ذلك اتجاهات مختلفة.
فمنهم من اعتنى بشرح حجج القرآن التي استدل الله بها على عقائد الإسلام وحقائقه، فأخذ يفسرها ويفصلها ويضرب لها الأمثال.وهذه الطريقة أفضل الطرق وأجداها وأقصرها. وذلك لوضوح هذه الأدلة وجلائها ولأيراثها ثلج الصدور وطمأنينة القلوب للناس كافة عامتهم وخاصتهم،الأميين منهم والفلاسفة، وفي مقدمة من سلك هذا المنهج العالم الرباني نابغة العصر الإمام الملهم بديع الزمان سعيد النورسي في مؤلفاته المباركة المسماة برسائل النور، فقد أنشأ في رسائله هذه علم كلام جديد على هذا المنهج القويم، ومن أجل ذلك لقبه بعض العلماء بمتكلم العصر.
ومنهم من استدل على عقائد الإسلام وحقائقه بما اكتشفه عقول العلماء في العصر الحديث وتوصل إليه تجاربهم المستندة إلى التكنولوجيا الحديثة المتقدمة تقدما هائلا في شتى المجالات.
ومنهم من اعتنى بما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن، والقرآن لا تنقضي عجائبه، وبتفسير مجموعة من آياته الكونية بما يوافق المكتشفات العلمية التي توصلت إليه عقول العلماء وتجاربهم، وبذلك دعموا إيمان المؤمنين وقووا نفوسهم وزادوا ثقتهم بدينهم وكتابهم، وجذبوا إلى الإيمان مجموعة كبيرة من العلماء والمتعلمين والمثقفين من غير المؤمنين وهذه الطريقة طريقة محمودة نافعة إذا خلت عن التكلف والتعسف في تفسير آي الذكر الحكيم، إلى غير ذلك من الإتجاهات.
وهذه الإتجاهات كلها تصب في مصب واحد، وهو مصب اثبات العقائد الإسلامية وبيان حقانيته، والدفاع عن حياضه بطريقة تناسب العصرالحديث.
وهذا العلم –أي علم الكلام الجديد- قد ولد وتكون – كما هو عادة الإبتكار والتكون- مفرقا مشتتا كل مجموعة منه في كتاب، وهو بحاجة إلى من يقوم بجمعه في كتاب واحد يرتبه وينسقه فيه.
والله نسأل أن يقيض لهذه الامة من يقوم بهذ العبأ، ويقدم لها هذه الخدمة. وما ذلك على الله بعزيز.
وأخيرا نود أن ننبه على أمرين:
الأول: أن أئمة علم الكلام قد عرفوه بتعريفات مختلفة شاملة لكلا النوعين من الكلام ، ونورد منها ثلاثة تعريفات لثلاثة من فحول علم الكلام: الإيجي والتفتازاني وابن الهمام.
قال القاضي عضد الدين الإيجي في المواقف: والكلام: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج والدفع الشبه.
وقال التفتازاني في المقاصد: الكلام: هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقنية.
وقال ابن الهمام في المسايرة: والكلام معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوبة إلى دين الإسلام عن الأدلة علما ( في أكثر العقائد) وظنا في البعض منها.
فأنت ترى أن هذه التعريفات شاملة لكلا النوعين من الكلام حيث عمموا الأدلة ولم يخصوها بالواردة على أسلوب الفلاسفة، ولعلهم لاحظوا أن علمهم لا يخلوا عن الأدلة الواضحة التي هي من جنس حجج القرآن فمن أجل ذلك عمموا الأدلة وعمموا التعريفات لتشمل كلا النوعين من الكلام.
الثاني: أن علماء الكلام بعد أن عرفوه بتلك التعريفات وما هو قريب منها قالوا:
إن العلم المعرف بها يسمى علم الكلام، وعلم أصول الدين، وعلم التوحيد والصفات، فجعلوا الثلاثة أسماء مترادفة لمسمى واحد، مع أن السلف قد ذموا علم الكلام ونهوا عن الإشتغال به، ولم يذم أحد منهم علم أصول الدين، وعلم التوحيد والصفات، بل قد ألف فيه بعض من ذم علم الكلام، وكيف يذمه مسلم وهو علم الأصول الدين، وعلم التوحيد والصفات، وهو من آكد الواجبات أو آكدوها؟! فينبغي أن يفرق بأن علم الكلام إسم للنوع المذموم، وعلم أصول الدين وعلم التوحيد والصفات إسم للنوع المحمود. نعم علم الكلام علم متعلق بأصول الدين وبالتوحيد والصفات لكن وجه التسمية لا يقتضي التسمية، وذم السلف لعلم الكلام يقتضي ما ذكرناه من التفرقة. والله تعالى أعلم.
——————————————————————————–
[1] قد أورد الإمام ابن عساكر ما ذكرناها من أقوال السلف في ذم الكلام وغيرها في كتابه (تبيين كذب المفترى فيما نسب لأبي الحسن الأشعري) بالأسانيد المتصلة، فمن أراد النظر في أسانيدها فليرجع إليه ( ص 333) فما بعدها.